في المجتمعات التقليدية القديمة، ظل اكتساب المكانة العالية صعبًا إلى حدٍ بعيد، غير أن فقدانها لم يكن أقل صعوبة، وهو ما كان مريحًا لمن يملكونها. فقد كان تغيير اللورد لموقعه مثلا لا يقل صعوبة عن تغيير الفلاح لمنزلته وهو الأمر الأشد وطأة.
كانت هوية الإنسان بحكم مولده أشد أهمية من أي شيء قد يستطيع تحقيقه خلال عُمره كله، عبر استغلال مهاراته وقدراته. كان بيتُ القصيد هو من أنت، أما ماذا تفعل فنادرًا ما يُلتفت إليه. تطلعت المجتمعات الحديثة إلى تحقيق هدف عظيم، هو أن تقلب هذه المعادلة على وجهها الآخر، وأن تتخلّص من جميع الاعتبارات الموروثة، سواء تلك التي تمنح الامتيازات لبعض الناس أو التي تحرم منها البعض الآخر، بغرض أن تقوم منزلة المرء على منجزه الفردي وحسب – والذي أصبح معناه المنجز المالي بالأساس.
لم تعد المكانة تعتمد الآن على هوية تتوارثها الأجيال ولا تبديل لها، إلا في حالات نادرة، وبدلا من ذلك صار معيارها هو أداء المرء في ظل اقتصاد حركته لا تهدأ وشراسته لا تلين. نتيجة للطبيعة الخاصة بهذا الاقتصاد، فإنَّ أبرز سمات الصراع لتحقيق المكانة هي الريبة وانعدام اليقين.
إننا نتأمل المستقبل في ضوء معرفتنا بأننا معرَّضون في أي وقت لأن يخيب مسعانا إذا أعاق تقدمنا زملاؤنا أو منافسونا، أو إذا اكتشفنا أننا نفتقد القدرات اللازمة لبلوغ أهدافنا المنشودة، أو إذا انجرفنا داخل تيار مشؤوم وسط أمواج السوق المتلاطمة - ويقترن أي فشل لنا بالنجاح الممكن لأندادنا.
القلق هو التابع المخلص للطموح المعاصر، وهناك خمسة عوامل على الأقل عصية على التوقع، يتوقف عليها كسبنا للرزق والاحترام، وهي ذاتها تقدّم لنا خمسة مبررات وجيهة لكيلا نطمئن بالمرة إلى بلوغنا المنصب المنشود أو الاحتفاظ به داخل تراتبية المناصب، وأحد هذه العوامل هي:
الاعتماد على صاحب العمل
تشتد درجة عجزنا عن التوقع الدقيق لما قد يطرأ على ظروفنا عندما تكون مكانتنا مرتبطة تمامًا بأولويات من نعمل لديهم. ظهر في الولايات المتحدة عام 1907 كتاب بعنوان ثلاثة أفدنة وحرّية، وسرعان ما استحوذ على خيال عموم القراء.
انطلق مؤلّفه، بولتون هول، من التسليم بحماقة العمل لأجل شخص آخر، وبناءً عليه راح يوعز إلى قرائه أن بإمكانهم كسب حريتهم إذا هجروا المكاتب والمصانع واشتروا مساحةَ ثلاثة أفدنة من الأرض الرخيصة والصالحة للزراعة في المناطق الريفية بوسط أمريكا. وسرعان ما ستتيح لهم هذه الأفدنة القليلة زراعة طعام يكفي أسرة من أربعة أفراد، وبناء بيت بسيط ولكن مريح، والأفضل من ذلك كله أنهم لن يكونوا مضطرين بعد ذلك لألعاب التملّق والتفاوض مع الزملاء والرؤساء في أماكن العمل المعهودة. الجزء الأكبر من هذا الكتاب مخصَّص لتقديم وصف مفصل لكيفية زراعة الخضروات وبناء الصوبات الزجاجية، وتخطيط بستان أشجار الفاكهة، وشراء حيوانات المزارع (وقد شرح السيد هول في كتابه أن بقرة واحدة تكفي للحصول على الحليب والجبن، والبط مهم للحصول على طعام أكثر تغذية من الدجاج).
إن الرسالة التي نقلها كتاب ثلاثة أفدنة وحرية ظلت تتردد بوتيرة أعلى وأوسع نطاقا خلال الخمسين عاما السابقة في كل من أوربا وأمريكا لكي يعيش الإنسان حياة سعيدة عليه أن يحاول الهرب من الاعتماد على أرباب العمل وبدلا من ذلك أن يعمل لحساب نفسه مباشرةً، وبإيقاعه الخاص المناسب له، ومن أجل أرباح تعود إليه وحده. لقد ظهرت مثل تلك الدعوات كرد فعل على ميل في الاتجاه المعاكس: خلال القرن التاسع عشر، وللمرة الأولى في التاريخ، كف أغلب الناس عن العمل في مزارعهم الخاصة أو في الأعمال التجارية الصغيرة للأسرة، وبدأوا يقايضون ذكاءهم أو قوتهم البدنية في مقابل أجر يدفعه لهم شخص آخر عام ،1800 كانت نسبة 20 بالمئة من العاملين في أمريكا لهم رب عمل آخر غير أنفسهم؛ وبحلول عام 1900 ارتفعت هذه النسبة إلى 50 بالمئة، وفي عام 2000 صارت 90 بالمئة.
كما أن أرباب العمل ازدادوا ضخامةً وتوسعًا كذلك: كانت نسبة قوة العمل الأمريكية المشتغلة في مؤسسات تستخدم 500 موظف أو أكثر 1 بالمئة فقط في عام 1800 ومع حلول عام 2000 ارتفعت نسبة تلك المؤسسات إلى 55%. هي في إنجلترا، تسارعت وتيرة الانتقال من دولة صغار المنتجين الزراعيين إلى العاملين بأجر لدى الآخرين بسبب فقدان أجزاء كبيرة من الأرض ذات الملكية المشاعية، وهو مصدر كان يُمكن فقراء الفلاحين من الاستمرار في الحياة بزراعة ما يحتاجون من غذاء وبإطلاق ما يملكون من حيوانات - بقرة أو أوزة - حرةً لترعى أو تغتذي.
منذ القرن التاسع عشر فصاعدًا، أُغلقت الغالبية العظمى من الحقول الإنجليزية «المفتوحة» وأحاطها المُلاك من ذوي السلطة بالأسوار والأسيجة. بين عامي 1724 و 1815، أصبح أكثر من مليون ونصف من الأفندة ملكيات خاصة. وفقا للتحليل الماركسي التقليدي (والذي رفضه بعض المؤرخين، لكنه يبقى على الرغم من ذلك)، فإن حركة تسييج الأراضي كانت بشيرًا بمولد طبقة البروليتاريا الصناعية الحديثة، والتي تعرف بأنها مجموعة الأشخاص غير القادرين على إعالة أنفسهم، وبالتالي لا يُترك أمامهم أي خيار إلا بيع أنفسهم لصاحب العمل مقابل أجر ثابت وبشروط تصبّ في مصلحة صاحب العمل بالأساس.
ولا يختلفُ الحالُ الآن عمّا كان عليه آنذاك، فلا تقتصر متاعب الموظف على القلق بشأن استمرار وجوده في الوظيفة، ولكنها تشمل كذلك المهانة اليومية المتجسّدة في العديد من أعراف وآليات العمل.
تتخذ أغلب المؤسسات والشركات شكلًا هَرَميًا، حيث توجد قاعدة واسعة من الموظفين تضيق صعودًا حتى قمة ضيقة من المديرين، ولهذا السبب يُثار السؤال عن من ستتم ترقيته ومن سيظل في مكانه، ويتحوّل هذا السؤال إلى أحد دواعي القلق الجاثمة على الصدور في كل أماكن العمل – وهو مثل سائر دواعي القلق يغذي حالة الريبة وانعدام الأمان. ما يزيد الطين بلة حقيقة أنه من الصعب قياس الإنجاز في أغلب المجالات ورصده بوسيلة دقيقة يعوّل عليها، ولذلك فإن الطريق نحو الترقي للأعلى أو نحو الاتجاه المعاكس للأسفل قد لا تربطه إلّا علاقة عشوائية كما يبدو بالأداء الفعلي للموظف.
فقد لا يكون الناجحون في تسلّق الهرم الوظيفي في مؤسساتهم هم أفضل الموظفين وأكثرهم إتقانا، ولكن هم الأكثر إتقانا لمجموعة من مهارات سياسية لا يتوفّر لها في الحياة العادية عموما وسائل للتدريب والإرشاد.
على الرغم مما قد يبدو على السطح من اختلافات بين الحياة العملية المعاصرة وحياة البلاط الملكي، فلعل أرجح النصائح حول متطلبات البقاء في الأولى قد أتت من سلسلة نبلاء المعيين عاشوا حياة البلاط في فرنسا وإيطاليا ما بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر. فبعد أن تقاعد هؤلاء الرجال واعتزلوا العالم عكفوا على تجميع أفكارهم في مجموعة متوالية من أعمال، تتسم بروح كلبية تزدري البشر وتشك في دوافعهم، صيغت بأسلوب الشذرات اللاذعة - وما زال تلك الأعمال حتى يومنا هذا تتحدّى ما نود أن نعتقده حول رفاقنا البشر.














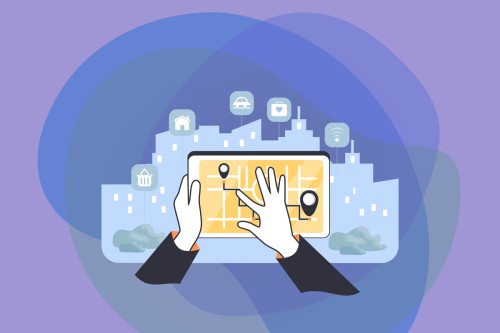

اضافةتعليق
التعليقات