حتى تتمكن من رفع تلك العقبات التي تعتري طريقك محاولةً إزاحتك عنه فأنت تحتاج لمن يشحذ فيك قوة الارادة، تلك الطاقة العجيبة والعزيمة الباهرة التي تخبرك بإستمرار أنك لابد أن تكمل طريقك وصولاً لهدفك المُبارك..
وإيماناً بضرورة هذه الارادة كان لـ فتيات جمعية المودة والإزدهار النسوية لقاء مع سماحة العالم الرباني والمُربي الفاضل آية الله السيد المرتضى الشيرازي (دام ظله) ضمن مُخيم الـمودة التي أقامتهُ جمعية المودة والإزدهار للتنمية النسوية لكادرها ضمن سلسلة بناء الفرد وتكامله من أجل بناء مجتمع سليم الأفكار والأفعال..
بدأ سماحته حديثه الذي دار حول محورين مُهمين:
المحور الأول: تعلموا القواعد الفقهية
والثاني: بناء المُجتمعات المُستقبلية
حيث فصّل سماحته المحور الأول بقوله: هذا المحور يحتاج لدقة وتطور مستمر يُمكن الفرد من الولوج في هذا العالم بنجاح من أجل التكامل الشخصي في البعد النظري والعملي..
ومن أجل تبسيط شرح هذا المحور بدايةً أشارَ إلى علم الفقه والذي يمكن دراسته في الـ (العروة، الرسالة العملية، الشرايع واللُمعة والمكاسب وغير ذلك) حيث أن الفقه (موضوعه فعل مكلفينا وغايته الفوز بـ عِليينا) فدائرته هي دائرة الأفعال الشخصية من صلاة وصيام وطلاق ونكاح وبيع وشراء وغيرها، وعلم الأصول والذي أيضاً يمكن دراسته في كتاب (المعالم أو الرسائل أو أصول الفقه وغير ذلك) فهو القواعد الكليَّة التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية مثل حُجية الظواهر أو حُجية الإستصحاب وغيرها!.
أمَّا العلم الثالث والذي يسمى علم القواعد الفقهية وهو (المحور الأول) فقال سماحته عنه: أن أحوج ما يكون الإنسان إليه هو معرفة هذا العلم والتبحر في قواعده لما لها من تأثير عظيم على حياة الفرد، حيثُ إنه العلم الوسيط الذي يقع بين علم الفقه وعلم الأصول..
وأضاف سماحته أن كتاب (القواعد الفقهية) لسماحة آية الله العُظمى السيد الراحل محمد الحُسيني الشيرازي قدس يوضح ماهية هذا العلم، وأهم تطبيقاته..
وقد ينقدح في ذهن القارئ سؤال مهم وهو: أين تكمن أهمية دراسة ومعرفة هذا العلم؟ وهل له تطبيقات في الحياة العامة؟
وللإجابة على هذا السؤال لابد من التطرق لبعض قواعده، وبيان مدى تأثيره في جوانب عِدة فقهياً وإجتماعياً وإدارياً، ومن تطبيقاته المهمة هي (قاعدة الميسور) وأصلها رواية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تنص على إنَّ (الميسور لا يسقطُ بالمعسور)..
من هذه القاعدة إستخُرجت المئات من الأحكام الفقهية في الصلاة والحج وغيرها والتي كانت تمُثل الحل لكثير من الإستفهامات الشرعية التي كانت مطروحة.. فمثلاً الصلاة وهي عمود الدين ولكن لو تعرض شخص لهجوم من حيوان مفترس أو الغريق الذي لايمكن أن يؤدي صلاته بشكل كامل بكل أجزاءه فماذا يفعل؟.
هذه القاعدة تحل هذه المشكلة حيث تنص على أن الميسور لا يسقط بالمعسور بمعنى آخر (ما لا يُدرك كله لا يُترك كله) فالذي لا يستطيع الإتيان بكامل أجزاء الصلاة (وهو المعسور) يمكنه أن يؤدي ميسورها وهو مثلاً تسبيحة عن كل ركعة مع الإيماء للركوع والسجود..
وهكذا في الحج فلو أن شخصاً ماطاف طواف النساء غفلة أو نسياناً ماذا يفعل؟
هذه القاعدة تُجيب أيضاً وتحل الإشكال الحاصل باتخاذ النائب الذي ينوب عنه في أداء هذا العمل وهكذا في كثير من التطبيقات والأمثلة التي لا مجال لذكرها هُنا وتُترك للقارىء الكريم فرصة التبحر بها ومعرفتها من أجل تسهيل الحياة العامة ومعرفة الدين الإسلامي المعرفة الحقة..
إذن أصل هذه القواعد: تسهيل الأمور ونقلها من الأصعب إلى الأسهل، وأصلها الآية القُرآنية الشريفة: (يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) والتي منها جاءت الرواية النبوية الشريفة (الميسور لا يسقط بالمعسور)..
وهذه الأمثلة كانت من الناحية الفقهية، فماهي تطبيقاتها في المجالات الأخرى؟
أشار سماحته إلى الجانب الإجتماعي ولعله الأهم، إذا ما تطرقنا إلى أهم أسباب توقف عجلة التقدم لدينا، ولماذا لا يزال الأغلب يراوح في مكانه تحت حُجج قد تبدوا ظاهرياً مقبولة؟
فالأغلب مثاليون في تفكيرهم، يفكرون في المدينة الفاضلة وهذا سبب تأخر الأعمال وعدم تقدمها حيث يتخذ الأغلب ذريعة أنه يُريد أن يصل إلى الكمال في عمله ولهذا فهو لا يقدم على أي عمل لأنه لا يمكنه بلوغ الكمال فيه!.
ولكن لهذه القاعدة رأيُ مغاير تماماً حيثُ أن شعارها اليسُر لا العُسر، والوجود الناقص خير من الغياب الكامل.
فعلى سبيل المثال لو أن كافة الكُتَّاب إمتنعوا عن تأليف الكُتب بحجة أنهم يريدون إنتاجاً مُتكاملاً ذا مستوى عالٍ فإن ذلك سيضعنا في أزمة حادة من نقص المؤلفات وتقلص مساحة نشر العلوم والمعرفة التي تأخذ على عاتقها إخراج الإنسان من ظُلمات جهله إلى نور العلم.
فهي تُنادي بضرورة بذل المجهود والعمل على تقديم الأفضل ولكن دون التوقف بحجة الكمال،
فاللازم أن لا يتكاسل أو يتقاعس الفرد عن أداء واجباته، وعليه أن يُقدم البسيط إذا كانت قدرته لا تسع لتقديم الأفضل، فإن الناس درجات وقابلياتهم تختلف من الواحد إلى الآخر ولهذا لايجب أن يُترك العمل بحجة أنه لابد من تقديم الأفضل الأكمل فالقاعدة تنص: كُلٌ عليه أن يعمل بالقدر الذي يتأتى منه!.
وهنا أقول: لو تأملنا قليلاً بمختلف المشاكل التي يُعاني منها المجتمع لـ كُنا أمام نتيجة مؤلمة جداً ألا وهي أنَّ هذه المشاكل هي من صُنعنا نحن إذ تركنا الميسور وعلقنا الأمور على المعسور!، نحن من وضعنا كل هذه الحواجز الصعبة في طريقنا! ثم صرنا ناقمين مُعلقين أسبابها على غيرنا!.
فـ العنوسة وإنتشار الطلاق والفقر والجهل والظُلم وغيرها ماهي إلا مشاكل من صُنعنا! لإبتعادنا عن العمل بما جاء به النبي الأكرم وآله صلوات الله عليهم أجمعين من قواعد ومنها قاعدة الميسور وخضوع أفعالنا لمسميات شخصية وأهواء ذاتية..
فلو أنَّ كلُ واحد فينا عمل بالقدر الذي يستطيع وأدى واجبه التشريعي والعملي لأستطعنا أن نتقدم وننهض بهذا المجتمع!.
ثم ختم سماحته الحديث في هذا المحور بإشارة لطيفة تفتح الطريق أمام الأذهان بضرورة رفض كل الحجج التي تعيق الفرد من العمل حيث قال: إن لم تستطع أن تكن الأفضل فكن فاضلاً وإن لم تستطع ان تكون فاضلاً فكن مفضولاً، وإن لم تستطع فكن أقلُ فضلاً.. وهكذا.. فالأهم أن تكون لا أن تغيب!.
بعدها إنتقل للحديث عن المحور الثاني وخطورة هذا المحور الذي كان عنوانه: إبنوا المجتمعات المُستقبلية.
لو تفكَّرنا قليلاً بهذا العنوان لوجدناه يُخبىء بين طياته الكثير من العمل والتفكير الذي يحتاج لتخطيط دقيق، فالذي يُريد أن يبني بناءً، إلى ماذا يحتاج؟ فكيف إذا كان بناءه بناءً مُستقبلياً؟
المشكلة التي نواجهها في عالم اليوم أننا نعيش في (الماضي) ولو حاول بعضنا الإلتحاق بالتطور فسيعيش بالحاضر!! ثم بعدها سنحتاج لمعجزة حتى نقفز إلى المُستقبل على مدى السنوات القادمة!.
هذه المشكلة الخطيرة وهي العيش في الماضي إستنزفت الكثير من الطاقات في البُعد الكمي والكيفي والتي كان من المقرر لها أن تنهض بواقع الأُمة لتكون خير أُمة أُخرجت للناس!.
فلو أخذنا مقارنة على مستوى البُعد الكمي بين نفوس العراق في ثورة العشرين ونفوسه الآن (الآن لعله يقارب الـ40 مليوناً، وفي ثورة العشرين كان حوالي خمسة ملايين)! لوجدنا الزيادة السكانية الكبيرة الحاصلة اليوم ولكن يجب أن نسأل سؤالاً هاماً وهو:
هل عدد رجال الدين إزداد بنفس الزيادة السكانية الكبيرة؟
لو أخذنا الأمر من ناحية الأرقام والإحصاء لوجدنا نقصاً ذريعاً ومذهلاً في هذا الأمر، فلو أن كل مائتي شخص احتاجوا إلى عالم يُعلمهم أمور دينهم ودنياهم فإلى كم رجل دين نحتاج ليتناسب مع الزيادة السُكانية الحاصلة؟ إنه حوالي مائتي ألف رجل دين للعراق وحده؟ لكن كم عدد طلاب حوزاتنا في النجف وكربلاء والبصرة والحلة؟
وكم كتاباً بمختلف مجالات الحياة نحتاج حتى نغطي إحتياجات الشعب مع هذه الزيادة الحاصلة؟ كم مسجداً وكم مركزاً صحياً وغيره من المقومات الحياتية الضرورية نحتاح حتى نسد هذه الزيادة؟
إذن وفق المعطيات التي لدينا نحنُ ما زلنا نعيش في الماضي، زمن ثورة العشرين حين كان تعداد العراق لا يتجاوز الخمسة مليون عراقي!.
هذا من الناحية الكمية أما من الناحية الكيفية فالأمر أخطر لأن المُخَاطب هذه المرة: هو الفكر والعقول التي تحتاج لخطاب فكري يمتاز بالقوة الكافية التي تسد إحتياجه من المعرفة الحقة والسؤال هو: إن المقالات والكُتب التي تُكتب ماهو مستواها؟ والخطاب الديني والثقافي والفكري وحتى السياسي ما هو مستواه؟.
إذا ما نظرنا لحقيقة ما يُقدم اليوم فإننا سنكون أمام نتيجة صادمة: سنجد الأغلب ربما يصلح لمئة سنة سبقتَ! أي في زمن كان فيه الشباب يمتلك من البساطة ما يجعله يقبل بأبسط الخطابات الموجهة إليه، وفي زمن كان الشباب فيه غير منفتح على بقية العالم، حيث لا مواقع تواصل اجتماعي ولا قنوات فضائية ولا هذا الإنفتاح الهائل الذي يعيشه شباب اليوم..
الخطاب الذي يُقدم اليوم هل هو بالمستوى المطلوب ليحفظ شبابنا من الإنحرافات التي تهجم كالفيروس الذي لا يُرى بل والذي يجري بسرعة الضوء؟ هل هو بالقوة الكافية التي تصدّ الأفكار الالحادية وتواجه الكم الهائل من الكتب المنحرفة التي تقع بين يدي الشاب بكبسة زر أو بحركة ماوس؟ وهل ترقى لتحفظ شبابنا من السقوط في براثن العلمانية والشيوعية والإلحادية؟
هكذا نحنُ اليوم نحتاج لخطاب توعوي ديني فكري يمتاز بالقوة الكافية الذي يصنعُ الربيع في عقول شبابنا ومجتمعنا.
وعلينا أن نتذكرُ جيداً: أن الربيع لا يحدثُ بوردة أو ورود أو كتاب أو كتب! وإنما يحصل بملايين الورود والأزهار والكتب والمقالات التوعوية..
بعدها ختم سماحته الحديث في هذا المحور بذكر إحصائية خطيرة لاحدى مراكز التخطيط الإستراتيجي في العراق حيثُ أجروا إحصاءاً إستبيانياً في جامعتين في العراق لعينة من الطلاب والطالبات، وتم طرح العديد من الأسئلة عليهم منها:
ماهو رأيكم بالأحزاب السياسية التي تحكم العراق؟
ماهو رأيكم برجال الدين؟ و...
والكثير من هذه الأسئلة الدقيقة، وكان الصادم في الأمر الأجوبة التي قيلت من قبل الطُلاب..
فمن ضمن الأسئلة التي طُرحت هل تصدقون كل كلام رجال الدين؟
المذهل أن 5% فقط من الإجابات كانت نعم! ورغم أن هذا السؤال ذكي لكنه خبيث من جهة أخرى لأنه يحصر القسمة على إثنين.
وأما السؤال الثاني فكان: هل تثقون بفتاوى المرجعية الدينية؟
والأجابة الغريبة التي كانت أن 15% فقط قالوا نعم نثق و85% أجابوا لا!
ورغم أنه قد نوقشت طريقة الاستبيان أو دقة المعلومات الواردة فيه، إلا ان المسألة بحاجة لمتابعة وتحقيق وعناية ورعاية.
ماذا يعني هذا؟ يعني أن الخطاب الديني لم يصل لهؤلاء بالصورة المطلوبة، الشاب والشابة إذا لم يأخذوا علوم أهل البيت (سلام الله عليهم) من رجال الدين فممن يأخذوه؟ يعني أننا فشلنا في إدارة المجتمع بالمحصلة النهائية.
فهؤلاء الـ 85% الذي لا يثقون برجال الدين من سيقودهم؟
الأمر في النهاية يضعنا أمام حقيقة خطيرة:
إننا ما زلنا نعيش في مئة سنة مضت!! كما ويحملنا مسؤولية كبيرة، مسؤولية النهوض بالمجتمع، مسؤولية إيجاد وخلق خطاب آخر يُحاكي عقول شباب اليوم، نحتاج لابتكار خطط وفق المقاييس المُستقبلية تسد حاجة شباب اليوم وتحفظ هذه الثروة الهائلة من الضياع..
لو تفكَّرنا قليلاً بهذا العنوان لوجدناه يُخبىء بين طياته الكثير من العمل والتفكير الذي يحتاج لتخطيط دقيق، فالذي يُريد أن يبني بناءً ماذا يحتاج؟ وكيف إذا كان بناءه لابد أن يكون بناءً مُستقبلياً؟
المشكلة التي نواجهها في عالم اليوم أننا نعيش في (الماضي) ولو حاولنا الإلتحاق بالتطور فسـنعيش بالحاضر ثم بعدها سنحتاج لعمل جاد دؤوب وتخطيط استراتيجي حتى نقفز إلى المُستقبل بسنوات قادمة.











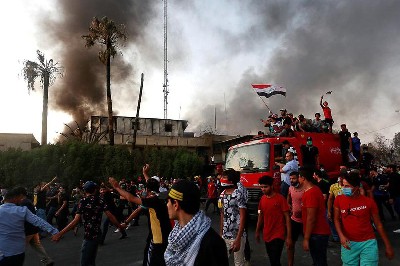


اضافةتعليق
التعليقات