كانت عيناها بحرًا من الأمل الهائج، تُبحر فيه باتجاه جزيرتها الوحيدة، باتجاهه هو. كان في نظرها أكثر من مجرد إنسان، هو النصر الأسطوري الذي تحتفي بذكراه في سرّها وجهرها. فمجرد وجوده في حياتها إنجازٌ تستحق عليه التمجيد، وحظٌّ ساحر حلّ عليها كمعجزة إلهية. بل إنه أدرك مكانة طوق النجاة الذي تشبثت به، والضوء الوحيد الذي أضاء ظلام نفقها الطويل. لكنها لم تدرك أنها كانت تبني مملكتها على جبل من الثلج، حتى جاءت اللحظة القاسية التي ذاب فيها كل شيء أمام عينيها، ذاب ذلك الحب الوهمي كقطعة ثلج في لهيب الشمس، تاركًا وراءه بركة ماءٍ مالح، دموعها هي فقط.
وفي لحظة جنون عاطفي، قررت سلمى أن تُنهي حياتها، كما تفعل الكثيرات في سنّها، ضحايا عواطف جارفة حوّلت قلوبهن إلى مقابر لأحلام لم تعش إلا في الخيال.
إن ما حدث مع سلمى ليس مجرد قصة درامية عابرة، بل هو تجسيد حي لظاهرة "الإفراط العاطفي" التي تُسيطر على العقل وتدفع بالإنسان إلى حافة الهاوية. إنها حالة من الانغماس الكلي في المشاعر إلى درجة فقدان التوازن النفسي والمنطقي، حيث يُصبح القلب هو الحاكم الوحيد، والعقل سجينًا بين جدران الأوهام.
والأسوأ من ذلك أننا نعيش في عصر "التشجيع على الإفراط العاطفي"، فمنصات التواصل الاجتماعي، والأفلام، والروايات الرومانسية تروّج لفكرة "الحب بجنون"، التي لا تروج فقط للإفراط في الحب، بل في جميع المشاعر السلبية أيضًا، مقدّمةً إياها على أنها ردود فعل طبيعية، بل ورومانسية في بعض الأحيان، كفكرة الرجل المتسلط المريض نفسيًا الذي "يُصلحه حب امرأة"، بينما في الحقيقة هذه الفكرة خطيرة جدًا؛ فهي تشجّع الفتيات على تحمّل علل نفسية وسلوكيات سامة تحت شعار: "حبي سيُغيّره".
أو حتى مشاهد "الملاحقة وعدم احترام الحدود"، حيث يظهر البطل وهو يلاحق حبيبته السابقة، يرسل مئات الرسائل، يقف تحت شباكها بالمطر، ويتوسل لها في مكان عملها، ويتم تقديم هذا على أنه "إثبات للحب" وليس كمخالفة للحدود الشخصية.
الكثير من الأفكار السامة تتسلل إلى خلايا عقلنا عبر مشاهد خيالية صنعتها السينما. وهنا لا يتم تقديم العاطفة على أنها علاقة إنسانية جميلة قائمة على الاحترام والتوازن، بل كمرض عضال يفقد فيه الشخص هويته وعقله.
ومن جنون الحب إلى "ثقافة الانهيار والدراما"
"كان يومي سيئًا، أنا منهار بالكامل" بسبب أمور روتينية مثل وجود زحام مروري، أو سوء طلب في المطعم، أو عطل تقني بسيط. حيث يتم تضخيم ردّ الفعل العاطفي ليتناسب مع دراما الموقف الذي يتم نشره، لا مع واقعيته.
فلم يعد الانهيار ردّ فعل، بل أصبحت هواتفنا مليئة بـ "ستايلات" الدراما: صورة للقهوة المنسكبة على المكتب وعبارة "كان يومي جحيمًا"، أو فيديو مُعدّل بإضاءة حزينة على أنغام موسيقى كئيبة منقوش عليه "أنا منهارة نفسيًا" بسبب خلاف عابر.
وهنا تحوّلت المشاعر إلى "محتوى" نتنافس على عرضه، لا إلى حالة نتعافى منها. صار الانهيار وسيلة للحصول على التفاعل والتعليقات المُتعاطفة، بدلًا من أن يكون إشارة حقيقية نستمع إليها لنساعد أنفسنا على النهوض.
والأخطر مما سبق هو تمجيد الاكتئاب والقلق، فأحيانًا يُقدّم بشكل جمالي على أنه علامة على الرقة والحساسية المفرطة، بدلًا من تشجيع التعامل معه على أنه حالة صحية تحتاج إلى علاج ودعم.
فنجد الصفحات تسرده على أنه محتوى يستحق الإعجاب، ويُروَّج بين الجميع كـ"ترند" حالي معلّق في صفحاتهم.
والأسوأ هو أن يتعدى الإفراط العاطفي حدود إيذاء النفس ليتحوّل إلى آلة دفاع عن القاتل، مثل القتل بسبب الفقر أو المشاكل المالية. وهذا النوع هو الأكثر خطورة، لأنه يحوّل اليأس العاطفي إلى فعل جرمي لا رجعة فيه.
والأخطر منه هو القصص الإخبارية والتبريرات الاجتماعية. فعند حدوث جريمة قتل بسبب الديون أو الفقر، تظهر أصوات في التعليقات تقول: "هذا البلد غير قابل للحياة"، والكثير من التبريرات المقدّمة للقاتل، كأن يكون الرجل كان يتحمّل همّ عائلته، أو اليأس دفعه لذلك، أو الخيانة جعلتها وحشًا.
وفي الحقيقة، هذه ليست فقط موافقة على الجريمة، بل محاولة لتقديمها كرد فعل "مفهوم"، وليس كجريمة مروّعة.
وكأن العاطفة أصبحت تلك الأداة التي تفقدك عقلك وتوازنك، دون الانتباه إلى أنها جزء خلقه الله في الإنسان ليبني لا ليهدم، هو شعور مكمّل لحياتك، لا حياتك بأكملها.
ليُصبح الإفراط العاطفي شكلًا من أشكال "الإدمان النفسي".
الخلط بين العاطفة والشعور
إن العاطفة هي الاستجابة الأولية الهائجة، مثل الموجة العاتية التي تضرب الشاطئ، أما الشعور فهو البحر بأكمله، أعمق وأهدأ وأكثر قدرة على حمل السفن.
وهنا يأتي الإفراط العاطفي على هيئة الاستسلام للموجة الأولى، واتخاذ قرارات مصيرية تحت تأثيرها، بينما الحكمة هي انتظار هدوء الموجة، والتفكير بعمق البحر الذي بداخلنا.
والسؤال هنا: كيف نحمي أنفسنا ومن نحب من هذه الظاهرة؟
في الحقيقة، إن الحماية من هذا الإعصار العاطفي لا تعني أن نصبح جليدًا بلا مشاعر، بل أن نرتدي سترة النجاة قبل أن نغامر بالسباحة في أعماقه. إليكم كيف:
تعلُّم فن التمييز: تدرب على تمييز الصوت الهامس للحدس الداخلي الحكيم، من الصوت الصارخ للرغبة العاطفية الجامحة. فالأول يهمس لك: "هذا الشخص قد يؤذيك، ابتعد"، والثاني يصرخ: "لا يمكنك العيش بدونه، هذه هي الفرصة الوحيدة". هنا يكون الأول يبني، والثاني يهدم.
الوعي بالمشكلة: الاعتراف بأن الإفراط العاطفي حالة غير صحية هو أول خطوات العلاج. مثلًا: يجب أن نُدرك أن الحب لا يعني الذوبان في الآخر، بل البقاء كيانين متكاملين.
تعزيز الثقة بالنفس: غالبًا ما يكون الإفراط العاطفي ناتجًا عن فراغ داخلي أو ضعف في تقدير الذات. ملء هذا الفراغ بالهوايات، والأهداف الشخصية، وتطوير الذات، يخلق حصنًا منيعًا ضد الاعتماد العاطفي المرضي.
الموازنة بين العقل والقلب: لا يجب أن يكون أحدهما ضد الآخر. استمع إلى قلبك، ولكن دائمًا امنح عقلك حق النقض، وصاحب الحكم الأخير على قراراتك المصيرية.
ختامًا، إن العاطفة لها حدود، والعقل له الأولوية. فالعاطفة يجب أن تمنحك السعادة دون أن تسرق منك عقلك، وتعطيك الأمل دون أن تجعلك عبدًا لخيالك.
لذلك، لا تجعلها تأخذك نحو الموت، بل امنحك مليون سبب لتحيا.
تشبه المنارة، تُنير الطريق في العتمة، لكنها تبقى ثابتة رغم كل العواصف.
لذلك، لنجعل من قلوبنا حدائق أمل، لا مقابر لأحلامنا. هي العاطفة ببساطة، يجب أن تكون: بلا إفراط ولا تفريط.










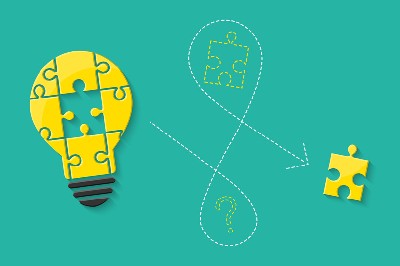


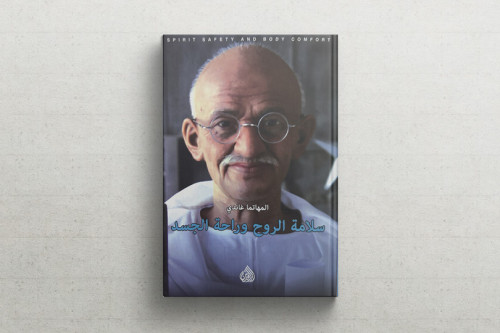
اضافةتعليق
التعليقات