لطالما ارتبط حجم العائلة ونمطها بطبيعة النشاط الاقتصادي السائد، لما لذلك من أثر بيّن في سعة العائلة وضيقها. ففي نمط الإنتاج اليدوي، سواء في الزراعة أو الصناعة أو ما شابه ذلك، نجد ميلاً نحو اتساع نطاق العائلة، حيث يتطلب إنجاز العمل والقيام بأمر المعاش عدداً كبيراً من الأيدي العاملة. بينما إذا كان الإنتاج، مثل الصيد أو الغزل أو تربية الدواجن، لا يحتاج إلى عمالة كثيرة، فإن ذلك يؤدي غالباً إلى قناعة الأسرة بالاعتماد على الزوجين وأولادهما فقط. وينطبق الأمر ذاته على العمل في بستان صغير، حيث تكفي عائلة واحدة لإدارته.
وقد شهد التاريخ محاولات قسرية لتغيير هذه العلاقة الطبيعية، كما في تجربة ستالين مع المزارع الجماعية التي أُجبر الفلاحون عليها، زاعماً أنها أكثر ربحاً للدولة، إلا أن نتائج هذه السياسة كانت كارثية، إذ نتج عنها تأخر الزراعة من ناحية، واستشراء الفساد الأخلاقي من ناحية ثانية، ومقاومة عنيفة قُتل فيها أكثر من مليون شخص.
أما فيما يختص بالأدوار داخل العائلة، فيُعدّ الرجل المنتج الطبيعي في معظم أشكال الإنتاج، أما مكانة المرأة فتتحدد بكونها منتجة أم لا؛ فإذا كانت منتجة اقتصادياً ارتفع شأنها داخل العائلة وفي المجتمع، بينما لا ينال عملها بوصفها “مربية وربة بيت”، رغم سموّه وقيمته، كما في المثل القائل: «التي تهزّ المهد بيمينها تهزّ العالم بشمالها»، التقديرَ المادي والاجتماعي نفسه الذي تحظى به المرأة المنتجة اقتصادياً.
ولهذا الحال ما يفسّره قول الإمام علي (عليه السلام):
«احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغنِ عمن شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره».
وقد سبق الإسلام الحضارات المعاصرة في منح المرأة مكانة رفيعة لم يصل إليها الغرب، تجلّت في نصوص مثل: «الجنة تحت أقدام الأمهات»، وفي الحديث المروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين جاءه رجل يسأله: إلى من أُحسن؟ فأجابه: «أمك»، ثم أعاد السؤال ثلاث مرات، وكان الجواب في كل مرة: «أمك»، حتى قال في الرابعة: «أباك».
مشاكل العائلة الحديثة
أفرزت التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة، في ظل غياب برامج صحيحة تُعنى بالإنسان بوصفه قيمة مركزية، جملةً من المشاكل التي أصابت العائلة، منها:
صِغَر حجم العائلة: اقتصرت كثير من الأسر على الوالدين والأولاد الصغار فقط، مما أفقدها دفء العائلة الممتدة وحنان الأقرباء. ويعود ذلك إلى السعي الفردي للمادة، وتراجع الثقافة التي توجب ترابط الأقرباء، الأمر الذي أدى إلى انفصال العائلة الواسعة، بل وصل في بعض الحالات إلى إخراج البنات من المنزل عند الرشد للعمل ودفع إيجار السكن ودعم أسرهن مادياً.
خروج مركز الإنتاج من الدار: لم تعد الدار مركز الإنتاج كما في عصر الإنتاج اليدوي، بل صار كل فرد من الآباء والأبناء يذهب إلى العمل خارج البيت. وليس الإشكال في العمل بحدّ ذاته، وإنما في حالة الانفصام التي يخلقها، حيث قد يبقى الفرد خارج المنزل أسبوعاً أو أكثر، ولا يلتقي أهل البيت إلا في أيام العطلة، مما يورث تقلص العاطفة والدفء، إذ إن كل صفة لا تُراعى تذبل وتضعف.
تراجع سلطة الوالدين التربوية: أدى انشغال الوالدين وانفصالهما عن البيت إلى تقلص قدرتهما على رعاية الأولاد وتربيتهم تربية سليمة، وبالتالي تراجع سلطتهما التربوية الطبيعية.
ضعف رعاية الأولاد للوالدين: في المقابل، قلّ اعتناء الأبناء بالوالدين واحترامهما واتخاذهما أُسوة، إضافة إلى ما يسببه ذلك من ضياع وغربة ووحشة نفسية عامة، نتيجة عدم تربية الأولاد تربية صالحة، مما يجعلهم نهباً للوساوس والشهوات والتيارات المنحرفة، وهو ما يفسر الاضطرابات الشبابية في مختلف المجتمعات.
قلّة اتكاء المرأة على الرجل: كان الاتكاء سابقاً نابعاً من الثقافة الاجتماعية ومن الحاجة الاقتصادية، لكن كلا الأمرين تغيّرا، إذ أوجبت الثقافة المادية الحديثة استقلال المرأة، كما فرض النظام الصناعي الحديث عليها تسديد حاجاتها بنفسها من خلال الوظيفة أو العمل الصناعي. وقد انعكس ذلك على قلة مبالاة الرجل بالمرأة، لأن الاتكاء والعطف يتقابلان زيادةً ونقصاناً، مما أوجب تحوّل الدار إلى جوّ باهت تفتقد فيه العائلة العطف والدفء.
انتقال قسم من أعمال الأولاد إلى خارج الدار: ابتداءً من دور الرضاعة والحضانة وصولاً إلى البلوغ والرشد، وذلك بسبب كثرة أعمال الأبوين من جهة، وقيام المؤسسات المختصة من جهة أخرى، وقد تسبب ذلك في تفاقم بعض المشكلات المتقدمة.
وتبعاً لما سبق، وقعت العائلة في مهبّ الانفصام، نتيجة جعل المادة محوراً للحياة، وانتشار الثقافة الانفصالية في المجتمع، ومنها الثقافة الماركسية التي لا ترى للعائلة قيمة تُذكر، إضافة إلى اختلاف آراء أفراد العائلة في الشؤون السياسية وغيرها، مما أوجد نزاعات دائمة، وسرعة استغناء كل من الزوجين عن الآخر، فكثر الطلاق بشكل ملحوظ، إلى غير ذلك من الأسباب والنتائج.
مقترحات للمعالجة
لإرجاع الدفء العائلي، والجمع بين الصناعة والدار، وبين المادة والروح، لا بد من وضع برامج عملية تفادياً للمشاكل الراهنة، وإن تعذّر ذلك على المدى القريب، وجب على الأقل إعداد برامج لحماية الشباب من الانزلاق وتفادي هذه المشكلات الخطيرة، وذلك عبر:
(أ) تقوية الثقافة الاجتماعية الصحيحة، لتستوعب الشباب أينما كانوا، وتعوّضهم عمّا فقدوه من العائلة السليمة.
(ب) تكوين الأحزاب والنقابات السليمة، لجمع الشباب وصرف طاقاتهم في البناء بدل الهدم أو الضياع.
(ج) إنشاء وزارة متخصصة بالشباب تعمل بشكل دائم على انتشالهم من المزالق والانحرافات.
(د) تأسيس المؤسسات الشبابية التي تجمعهم وتهديهم إلى الصراط السوي، عبر تلبية حاجاتهم، وحل مشكلاتهم، والإجابة عن تساؤلاتهم، وصرف طاقاتهم في المسارات الصحيحة.







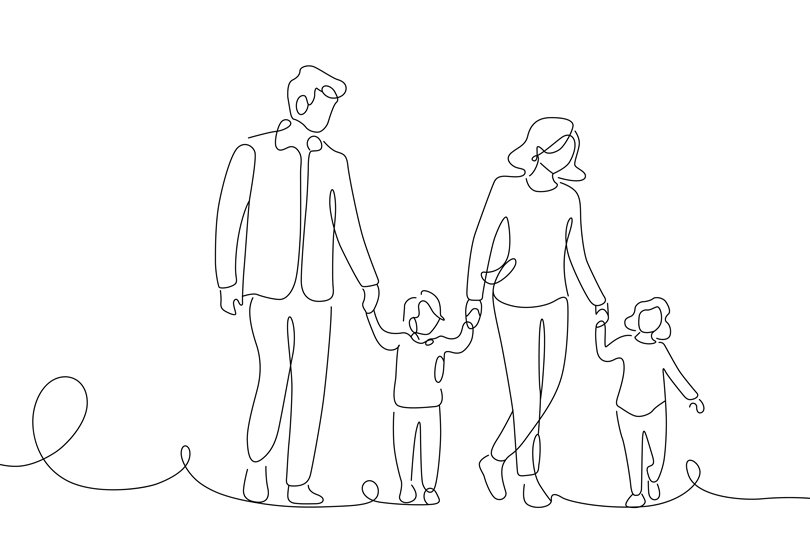

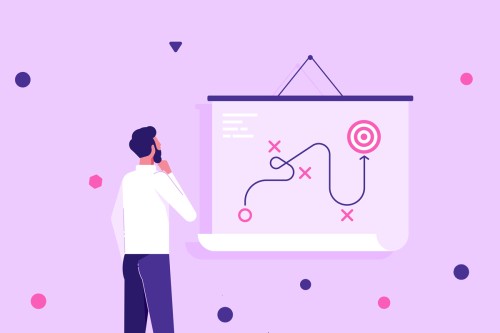




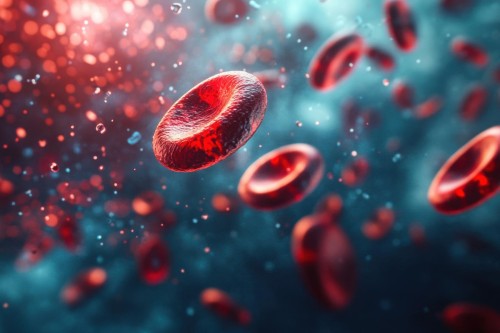

اضافةتعليق
التعليقات