أعتقد أن الناس تحاول التناسي غالبا لأن من الغريب جدا أن يتم نسيان حادثة كبيرة كهذه في منطقة لا تسمع فيها لا حسا ولا حسيسا كمنطقتنا، أو هل أن الجميع يخاف ذكر الأمر أو الاعتراف به من الأساس!.
لم يمر إلا أسبوعان من ذاك الغروب المرعب، غروب الشمس وغروب وجهها الجميل!
أذكر أننا ذهبنا في ذات اليوم المشؤوم ذاك لرؤيتها كونها عادت حديثا إلى المنطقة بعد سنين طوال، إلا أنها عادت امرأة يافعة، متزوجة، يرفقها ولدين وطفلة صغيرة ذات وجه اُستنسخ من وجه أمها.
شيماء.. كيف حالك؟
أجابت بطريقة باردة، غريبة، متشنجة كأن الحروف خرجت ترتعش من فمها، لم أفهم سبب خوفها الشديد المصحوب بالتوتر هذا، بدأ خوفها يزداد لدرجة مخيفة حين جاء زوجها، لم أرَ في تعابير وجهها أي تعبير يمكن ربطه بالترحيب أبداً، ولا وجهه كذلك.
أظن أن أمي لاحظت ذلك أيضا فودعتها برقة وهدوء وخرجنا دون أن تصحبنا إلى الباب حتى، عند خروجنا لمحتها تبكي بقوة وهي تحتضن ابنتها الصغيرة دون أي صوت، لم أفهم السبب إلا إنني لحقت أهلي بسرعة لباب المنزل خارجةً، قبل اغلاقي الباب الخارجي لمحت ظلهما من وراء ستار غرفة المعيشة. كان يضربها بشدة ضربا متسلسلا أوضح لي الظل قوته.
لم أخبر أحدا لليوم أني شاهدتها تضرب يومها إلا أن المشهد حفر تفاصيله على جدران ذاكرتي. بعدها بساعتين فقط سمعنا دوي طلق ناري في المنطقة.... في منطقتنا لا يوجد مسدسات، لا يسمع صوتها حتى في الأعراس، فهي محظورة من مختارنا.
"قتلت السيدة شيماء على يد زوجها بواسطة مسدس صغير إثر مشادة عائلية بين الاثنين". هذا ما تم تثبيته في محضر الشرطة، مشادة عائلية بين الاثنين!
لم ينتقم أحد لبنت الحي الصغيرة شيماء، خاف الجميع وفضل الصمت والنسيان. كأنها عادت لتموت بيننا كما ولدت، كبرت ولعبت بيننا.
هكذا تنتهي قصص النساء في المدينة، تطوى بين قصص الجدات التي سرعان ما تتحول لقصص خيالية لا تتجاوز آذان بضع أطفال من العائلة حتى تندثر تماما وتطوى بين سجلات الرحمن كغيرها الكثير.













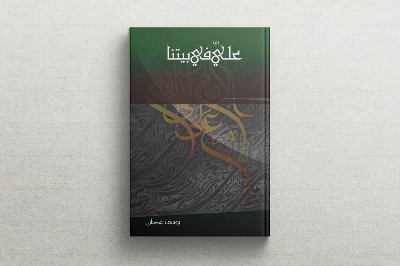
اضافةتعليق
التعليقات