يقول الإمام الصادق (عليه السلام): (وعندنا أهل البيت أصول العلم وعراه وضياؤه وأواخيه)(1).
هذا التقرير باستيعاب أهل البيت (عليهم السلام) الأصول العلم وجذوره وإشعاعه ومواصلاته، يكشف أن لهذا العلم مصادر فوق حقيقة الأشياء، وهو ما يمتاز به علم الأئمة المعصومين دون سواهم، وبذلك نحكم عليه بداهة بأنه غير خاضع لمقاييس التعليم التقليدية، فالإمام لم يحضر حلقة دروس العلماء، بل حضر العلماء حلقات دروسه، ولم نعهد له أساتذة أو شيوخاً كما هو الشائع لدى الدارسين، ولم يتدرج بمعلوماته من الأسهل إلى الأصعب، ومعلوماته في شبابه وكهولته وشيخوخته كلها حلقة واحدة مفرغة، لا تفاضل بين أزمنتها، كما هو شأن العلماء في الأخذ المسلكي النظامي.
وقد أشار الإمام (عليه السلام) إلى أبعاد هذا العلم ليشمل الخوارق ويتحدى نواميس الكون، فعن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي شيء هو العلم عندكم؟ قال الإمام: (ما يحدث بالليل والنهار، والأمر بعد الأمر، والشيء إلى يوم القيامة)(٢).
هذا الاستغراق الشمولي العريض يوحي بعدم إحاطة الفكر التقليدي بحيثيات هذا العلم، ويصرح بالبعد الغيبي الذي يمد روافده بهذه الموسوعية الشامخة، فلا يتلكأ في مسألة، ولا يغفل عن حادثة، ولا يقاس بنظير يشاكله أو يجانسه أو يدانيه؛ وليس في هذا المنحنى أية إشكالية عقلية بعد قول الإمام: إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم (٣).
فأين يعلم الإمام؟ وكيف يعلم الإمام؟ وما هي الطرق الموصلة لهذا العلم؟ إنه يشير إلى ما يفاض عليه من الغيب المجهول، ولا يتردد لحظة في التأكيد على هذه الظاهرة، فعن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الذي يسأل الإمام وليس عنده فيه شيء من أي يعلمه؟ قال (عليه السلام): (ينكت في القلب نكتاً، أو ينقر في الأذن نقرأ)(٤).
وهذا النوع من العلم لا يتوفر في النظر الفعلي إلا للإمام المعصوم فهو ظاهرة لم تسبق، وبادرة لا يحيط بها أحد، لهذا كان ما يدور من حديث أهل البيت في الدرجة القصوى من الصعوبة إدراكاً، لا من حيث مضمونه وطريقة عرضه، فهو مفهوم بيسر وسماح، بل من حيث روافده وموارده وتحمّله في شتى الظروف الدقيقة والنوازل الحادثة، لأن فيه اختراقاً هائلاً للحواجز المألوفة، وخروجاً عن الإدراك المتداول، لهذا قال الإمام الصادق نفسه: (إن حديثنا صعب ، مستصعبٌ ، شریف ، کریم ، ذكوان ذكي، وعرُ، لا يحتمله ملك مقرّب، ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن قيل فمن يحتمله؟ قال: من شئنا)(٥).
بينما نجد الإمام الباقر (عليه السلام) من ذي قبل يعالج هذا الحدث العلمي بمنظور آخر فيقول: إن حديث آل محمد صعب مستصعب، ثقيل، مقنع، أجرد ذكوان.. لا يحتمله إلا ملك مقرّب، أو نبي مرسل، أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان، أو مدينة حصينة)(٦).
وهذا التقدير لا يختلف بعائديته عما تحدث به الإمام الصادق فيما عرضت، لذلك نجده يوصي أولياءه بالاضطمام عليه، والحفاظ عليه إلا على أهله، فيقول: «اقرأ موالينا السلام، وأعلمهم أن يجعلوا حديثنا في حصون منيعة، وصدور فقيهة، وأحلام رزينة، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما الشاتم لنا عرضاً، والناصب لنا حرباً، أشد مؤونة من المذيع علينا حديثاً عند من لا يحتمله(٧).
وهذه الأحاديث في برمجتها علمياً ينبغي أن ترصد من خلال ثلاثة معايير، من أجل فهمها وادراكها وتسييرها:
الأول: أن هذه الصعوبة تتمثل في انتظام علمهم (عليه السلام) في قلوب واعية وعقول مدركة تحتفظ في هذا العلم مخزوناً إلا على أهله، فإشاعته في غير أهله من الجهلة والسطحيين يشكل خطورة مركزية عليه، إذ قد يتخذ ذريعة لإنزال المكاره والأضرار في الأئمة والأولياء، وقد يتفوه به غير حَمَلته ممن لا يطيقون حمله، ولا يفقهون موقعه من الرمزية والتعريض، أو الحقيقة والمجاز، أو التصريح والكناية، أو أساليب البلاغة العربية، وقد يروى دون دراية، وقد يهذ هذا ساذجاً.
الثاني: ومن الطبيعي أن التعقل لعلم الأئمة، ورعاية أصوله في التداول العلمي، أفضل من روايته دون إدراك في لحن القول، ومخارج الكلام، هذا المعيار هو الذي أشار إليه الإمام الصادق بقوله: (حدیث تدريه خير من ألف ترويه، ولا يكون الرجل فقيهاً حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجهاً، لنا من جميعها المخرج)(٨).
والإمام يكرر هذا المعنى، ويدعو إلى الإدراك لوجوه كلامهم (عليهم السلام)، لأنه يحمل على وجوه متعددة، وهذا ما خاطب به مؤمن الطاق محمد بن النعمان بقوله: (أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا، إن كلامنا ينصرف على سبعين وجها)(٩).
الثالث: إن حديث الإمام في الأحكام والتشريع والعقائد، وخصائص الإمامة، وعالم الغيب يخضع للمعيارين السابقين، وأما في نشره للعلوم الإنسانية والتجريبية فيمكن أن يقال: (إن الإمام الصادق الله يشرح نظرياته شرحاً مبيناً واضحاً، ويعرضها عرضاً علمياً سهل الفهم والإدراك، بحيث تستطيع الأذهان تقبله واستيعابه، فالقوانين العلمية التي أتى بها، ساقها بأسلوب واضح وصاغها بعبارات لا تحتمل اللبس، إدراكاً منه لحقيقتين هما: إن انتشار العلم رهن بالقدرة على فهمه، وإن قوانين العلوم تبقى مع الدهر، ولا تنتهي بوفاة واضعيها)(١٠).











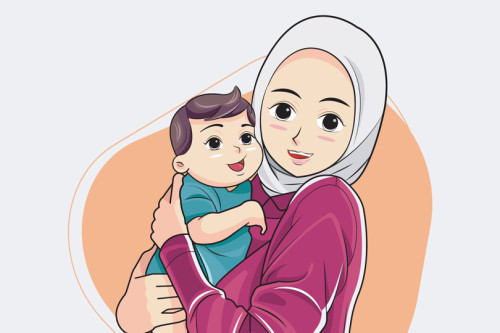
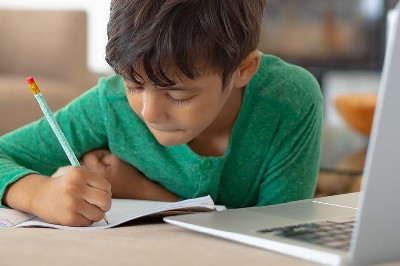

اضافةتعليق
التعليقات