هل سمعتم يوماً عن شمسٍ لم تأفل أو نجمٍ سكنَ السماءَ بهيأة واحدة منذ بدء البدء وحتى اليوم، ذلك ما خاله إبراهيم (ع) واكتشف بعدها أن النور يشتعل في لُبٍّه الدامس شيئاً فشيئاً حتى يكتمل إلى عظمته المعتادة في أعين المبصرين على يد خالق العظمة من العدم.
"وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ"، تنتعشُ بعدهُ أنظمة الخلق الواعية واللاواعية.. تلك التي تخطو بخطى الفقيه المبرمج نحو المرحلة التالية من غير أن تختار الوسيلة، بل تستعيض برسالة إلى نفس الإنسان ليقرر بعدها.. هل إلى فجورها أم تقواها.
التدرج؛ سُلّمُ السماء الذي يبدأ بقرار ثم خطوة وقد تفي نظرةُ بصيرة واحدة بالأمر كلّه، فقد اشتملت تلك الكلمة على معاني أبلغُ من فمِ البلاغة بل وحتى أساسها، فهي عملية البناء التكتيكية التي تستمر متصاعدة بأيدي مختلفة لتشكّل بعدها الصورة الأكبر والأعمق للمبنى الخالد، فالغايةُ أن نرى ما يحملهُ المستوى الأعلى من كساء الأرواح والعقول وأن ندرك ما كنا وما سنكون، وذلك ما يترجمهُ مفهوم هذه الكلمة.
فقد تبنت التجربة الأرضية كما يسميها العلم الحديث، مبدأ التدرج وذلك على صعيد الداخل والخارج والخَلق والخُلق والتشريع والتكوين وكُلّ ما من شأنهِ أن يثري الوجود بوجوده، ولكن يبقى السؤال يطرح نفسهُ كعادته..لماذا يتدرج كل شيء؟ وإلى أي شيء يتدرج؟
قبل أكثر من ملياري عام كانت الأرض هامدة بلا أنفاس، فلم تكن تحوي آنذاك غاز الأوكسجين بعد، و لكنها لم تخلو من سكانها حتى في تلك الحالة، فقد أثبتت النظريات العلمية في عصرنا الحاضر وجود مخلوقات أحادية الخلية تسمى (السيانوبكترياCyanobacteria ) كانت تسكن الأرض في تلك الحقبة اللامعروفة، كطبقة لزجة تصارع من أجل البقاء من خلال عمليات كيميائية أشبه ما تكون بعمليات التمثيل الضوئي التي تقوم بها النباتات في وقتنا الحاضر، فكانت تطلق كميات ضئيلة من غاز الأوكسجين في الهواء كغاز فائض عن حاجتها...ويرجح العلماء أنها تدرجت في تطورها لتصبح فيما بعد كائنات متعددة الخلايا ترمي بالحياة في كوكب الأرض.. من حيث لا تحتسب.
وتصاعد الكون في تدرجه فيما بعد على كل الأصعدة، بدءاً من أدق كائناته إلى أكبرها وأعظمها وذلك ما يشمل الكواكب والمجرات، وقد مسَّ هذا التدرج حتى سعة عقول البشر وإدراكهم بل جعله ركيزته، فلقد مرَّ الجنس البشري على سطح الكوكب بترادف مدروس بشكل مذهل، فلو نظرنا إلى أول جنس بشري على وجه الأرض (حسب الثقافة العلمية) وهو الإنسان المنتصب الذي سكن اليابسة في الحقبة قبل 108 ألف و117 ألف عام كما أكدّت مجلة "Nature" العلمية، لأدركنا مدى الانتقالات التي حدثت على مدار السنوات السالفة و أهميتها في زيادة سعة الإدراك بانسياب ملحوظ، فالكون بأكمله رهن إشارة العقل البشري بإذن خالقه، فقد قال أبو عبد الله (ع): "لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، بك آخذ، وبك أعطي، وعليك أثيب". فقد جعل الباري موضوع التطور والتدرج بحيثياته وجزئياته التي تعتبر لبّ الحياة.. محض اختيار يذوي إليه البشر أو عنه.
فلو أصرّ الإنسان آنذاك على التزمّت بحياته ومعطياتها المحدودة لكان حرياً بالكون أن يندثر، فتكاملُ الإنسان يعني السماح لكل محيطهِ أن يتدرج إلى الكمال، فلو لم يدرك الإنسان حاجتهُ للدفء لما اكتشف النار، ولو لم يكتشف النار لما عرف ما ورائها.. وهَلُمَّ جرّا.
فالتدرج فريضةُ الكون التي تبدأ من أذان الإنسان العاقل الذي يسمح لجميع المخلوقات بأن تكتمل من خلاله، حتى تلك التي يقاطعها بعض البشر ظناً منهم أنها بذلك تظفر بحياة بعيدة عن قتلٍ محتم، كتلك الحركات التي تُدعى ب(النباتية) والتي ترفع شعارات ضد أكل الدواجن والأسماك وغيرها من اللحوم.. زاعمةً بالرأفة واحترام حقوق الحيوان، ولكن.. من سيؤدي دورها في صناعة أجساد البشر؟ والتنامي بداخله لتصل إلى أعلى درجات الكمال والاكتمال فيهِ..
و به، قال تعالى: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ".
لذلك لم تكن دعوة الدين الإسلامي إلى التكامل دعوة صورية بل كانت تتمحور حول جوهر الوجود وغايته، لذلك كان النبي محمد (صلى الله عليه وآله) هو الإنسان الأعظم والأتم بكمالهِ والذي رحم العالمين بالسماح لهم بأن يؤدوا دورهم الملكي والملكوتي من خلاله، فقد قال الإمام الصادق (ع): "فأعطى الله محمدا (صلى الله عليه وآله) تسعة وتسعين جزءا (من العقل)، ثم قسم بين العباد جزءا واحدا".
فمن شاء أن يستشف حقيقة خلقه، فليتفكر في ماهيّة عقله وإلى أي مدى سمح لهُ في الترحال في سبل الكمال، وذلك من خلال استطلاع محيطه وما يحويه من أوجه التكامل، ومن أراد الوصول إلى الذروة فليهيأ قاعدة العمل.













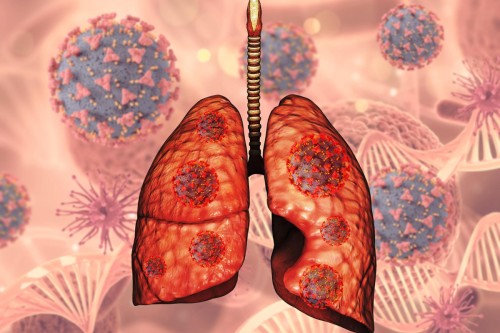


اضافةتعليق
التعليقات