تشير الدراسات إلى أن نوع الجنس يعد عاملا مهما في الفروق بين الخجولين والأقل خجلا . فقد وجد بيلكونز» (Pilkonis, 1977a) عند دراسته لكل من سلوكيات الكلام وسلوكيات النظر في أثناء التفاعل الاجتماعي، أن الفروق بين الرجال الخجولين والرجال غير الخجولين كانت أوضح من تلك التي ظهرت بين السيدات الخجولات وغير الخجولات.
فالرجال الخجولين أبطأ في بدء الكلام زمن الإرجاء بالعين. (طول)، ويتكلمون أقل في محادثاتهم، بينما كان الرجال غير الخجولين هم أقل المجموعات نظرا إلى الطرف الآخر في الموقف أقل المجموعات ترددا وصمتا، وأكثرهم كلاما .
بينما كان الرجال غير الخجولين أكثر المجموعات نظرا وتواصلا. أما بروش وزملاؤه، فقد وجدوا أن النساء غير الخجولات من أقل المجموعات درجة على مؤشر تجميعي لقياس القلق في أثناء التفاعل الاجتماعي، بينما لم توجد فروق جوهرية بين المجموعات الثلاث الأخرى، وهي النساء الخجولات والرجال الخجولين والرجال غير الخجولين، وقرر الرجال الخجولون أنهم عانوا أفكارا سلبية متعلقة بالذات في أثناء موقف المحادثة، وكانوا في ذلك أعلى جوهريا مقارنة بالمجموعات الثلاث الأخرى.
وعلى النقيض من نتائج دراسة بيلكونز، فقد أشارت نتائج دراسة بروش وزملائه هذه إلى أن الفروق بين الخجولين وغير الخجولين في الكلام لا تتأثر بنوع الجنس ذكور، إناث، إذ تبين أن الخجولين، سواء من الرجال أو النساء، يتكلمون أقل من غير الخجولين.
ويبدو أن الرجال الخجولين يواجهون مشكلات وصعوبات عند تحادثهم مع النساء، أكثر جوهريا من تلك التي تواجهها النساء الخجولات عندما يتحدثن مع الرجال. فقد وجد بيلكونز) أن الخجل يكشف عن نفسه لدى السيدات في صورة يغلب عليها رد الفعل كأن تنكس رأسها قليلا وتبتسم)، ذلك لأن التقاليد والأعراف الثقافية تجعل المرأة أقل إدارة أو تحكما في الموقف، وأقل توكيدا للذات في مثل تلك المواقف الاجتماعية.
أما الرجل، فالمتوقع منه أن يكون هو البادئ دائما أو الآخذ بزمام الأمور. ومن ثم، فإذا كان خجولا، فإن خجله سوف يؤثر سلبا في قدرته على أخذ المبادرة والبدء في التفاعل، فهناك توقعات اجتماعية للأدوار التي يجب أن يقوم بها كل من الرجل والمرأة في موقف التفاعل الاجتماعي، على الرغم من أن تلك التوقعات ربما تختلف من طبقة اجتماعية إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر داخل المجتمع الواحد.
وعلى سبيل المثال، فطلاب وطالبات الجامعة المشاركون فى الدراسات التي عرضنا لها هنا، هم في مرحلة عمرية يكون الفرد فيها منشغلا كثيرا بالبحث عن شريك للحياة، ومن ثم فإن مدى جاذبيته لدى الجنس الآخر أحد الأشياء التي يهتم بها كثيرا، وهو ما يجعل نمط التفاعلات الاجتماعية بين الأفراد في هذه - المرحلة العمرية يأخذ شكلا مختلفا - بدرجة أو بأخرى يوجد لدى الراشدين الأكبر عمرا.
ومن هنا نظل في حاجة إلى أن تعرف ما إذا كانت النتائج التي خلصت إليها تلك الدراسات قابلة للتكرار، إذا أجريت على عينات من الراشدين الأكبر عمرا، أو على أفراد يعرفون بعضهم بعضا أكثر، أو تربطهم علاقات اجتماعية مختلفة عن تلك التي تربط هؤلاء الطلبة بعضهم ببعض.
وعلى أي حال، تشير النتائج في مجملها إلى وجود فروق بين الجنسين في أساليب الكلام، فالذكور - بشكل عام - يتكلمون أكثر في المواقف العامة مثل الفصول الدراسية، والمقابلات والاجتماعات والمؤتمرات. وتشير تانن إلى أن الكلام يقوم بوظائف تختلف لدى المرأة عنها لدى الرجل، إذ تقول:
بالنسبة إلى معظم النساء، فإن لغة المحادثة هي في الأساس لغة صلات تنهض على الوئام والألفة، فهي وسيلة لتكوين العلاقات وتقوية الأواصر، ويكون التأكيد لديهن على إظهار التشابه والتماثل في الخبرات مع من تتحدث إليه المرأة.
أما بالنسبة إلى معظم الرجال فالكلام في الأساس هو وسيلة للحفاظ على الاستقلالية والتفاوض والدفاع عن المركز الاجتماعي وحمايته. ويتم ذلك من خلال إظهار الرجل معارفه ومعلوماته ومهاراته، ومحاولته الإمساك بزمام الحديث من خلال سرده القصص، أو إلقاء النكات، أو المعلومات.
وإذا كان للكلام وظائف مختلفة بالفعل لدى الرجل والمرأة، فلن يكون غريبا أن يكون تأثير الخجل في الرجل مختلفا عنه في المرأة. ولما كان الخجولون يتشككون في قدرتهم على الأداء بمهارة في المواقف الاجتماعية، فيمكننا أن نستنتج أن من يحتاج أكثر إلى الأداء بمهارة في المواقف الاجتماعية (الرجال) (غالبا) هو الذى سوف يتأثر أداؤه سلبيا أكثر إذا عانى الخجل.
وكذلك فإن أسلوب لغة المرأة وكلامها يمكن أن يؤدى إلى الخجل خصوصا فى المواقف العامة. وقد ضربت (تانن) مثلا لذلك بسيدة كانت أكثر كلاما من زوجها فى المنزل إلا أنها تتحول إلى شبه خرساء معقودة اللسان حينما تذهب - مثلا - إلى اجتماع مجلس الآباء في مدرسة ابنها، أو حفلة تقيمها مدرسته.
إذ تصبح صامتة، مع وعي شديد بردود الفعل السلبية التي ربما يبديها الآخرون على أي شيء يمكن أن تقوله، وبكل الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها إذا حاولت أن تتكلم أو تعبر عن أفكارها.
وإذا استجمعت شجاعتها واستعدت لأن تقول شيئا ما، فإنها تحتاج إلى وقت ليس بالقليل لكي تصوغ كلماتها. إنها لا تستطيع أن تقف وتنطلق في الحديث مثلما يفعل زوجها وغيره من الرجال في هذه المواقف.
وربما يمارس نوع الجنس تأثيرا في الخجل بطرق أخرى. فإذا كان الفرد معتادا على مواجهة الخجل والتوافق معه عن طريق الصمت وعدم توكيد الذات، فإنه سوف يعاني كثيرا من التوتر والاضطراب إذا واجه موقفا يحتم عليه توكيده لذاته.
ولما كانت التقاليد والأعراف الثقافية تلزم الرجل وتجبره على أن يكون أكثر توكيدا لذاته من المرأة في مواقف معينة، فإن الخجل سوف يؤثر سلبا في الرجل أكثر من تأثيره السلبي في المرأة في مثل هذه المواقف.
والحب والزواج مثال واضح على ذلك. فهناك دليل من الدراسات التتبعية التي بدأت على أطفال من الجنسين، واستمرت تتابعهم إلى أن أصبحوا أزواجا وزوجات ، على أن الرجال الخجولين يتزوجون في سن متأخرة مقارنة بالرجال الأقل خجلا (الفرق حوالي ثلاث سنوات)، بينما لا يوجد هذا الفرق في متوسط سن الزواج بين السيدات الخجولات وغير الخجولات وتتسق هذه النتائج مع فكرة أن العثور على شريك الحياة وتكوين علاقة وثيقة دائمة معه، تختلف لدى الرجل عنها لدى المرأة، ويحتاج كل منهما إلى متطلبات مختلفة.
إن القول بأن الفروق بين الجنسين هي ظاهرة عامة، توجد في كل زمان ومكان، يعنى ضمنيا أننا لا بد من أن نجد فروقا بينهما في الخجل منذ سنوات الطفولة، وذلك لأن أدوار الجنس يتم اكتسابها وتعلمها فى هذه المرحلة العمرية.
وهناك بالفعل بعض الأدلة على ذلك. فقد أشار أزيندورف في دراسته التي أجراها على عينة من الذكور والإناث في عمر أربع سنوات، إلى أن الذكور الأكثر بطئا وترددا في المبادأة بالتواصل مع راشد غريب عليهم، كانوا ينظرون أقل إلى هذا الراشد، بينما لم تكن الحال هكذا بالنسبة إلى الإناث. إلا أنه بعد أن تبدأ عملية التفاعل بالفعل بين الطفل وهذا الراشد الغريب، فلا توجد فروق بين الجنسين في نمط النظر إلى هذا الغريب.
وهو ما يعني أن الفروق بين الجنسين توجد في مرحلة ما قبل أول مبادأة للتفاعل، أي في الفترة ما بين الوجود مع الغريب وبدء التفاعل معه. ويتسق ذلك مع ما تبين من دراسة تانن، سبقت الإشارة إليها، من أن البنات أكثر ميلا إلى النظر إلى الراشد بطريقة تكشف عن استعدادهن ورغبتهن في بدء التفاعل معه، بينما يكون الأولاد أكثر تهيبا ونفورا من ذلك، خشية من أن يؤدي ذلك إلى بدء علاقة مع آخر (الراشد) له سلطة ونفوذ عليهم.
وفي دراسة لستيفنسون - هايند وغلوفر عن الخجل لدى عينة من الجنسين في عمر الرابعة قسم الأطفال إلى ثلاث مجموعات: الأولى مجموعة الأطفال شديدي الخجل خجولين في المنزل وشديدي الخجل في المعمل عند إجراء الدراسة، ومجموعة المنخفضين في الخجل غير الخجولين في المنزل ولم يكشفوا إلا عن قدر بسيط من الخجل في المعمل، ومجموعة الخجل المتوسط متوسطي الخجل في المعمل، بصرف النظر عن مستوى خجلهم في المنزل. وجرت ملاحظة وتحليل سلك أمهات الأطفال الذكور شديدي الخجل من أكثر الأمهات إيجابية أطفال المجموعات الثلاث، وهن يتعاملن مع أبنائهن فى المنزل.
وتبين ولياقة وكياسة وحساسية وهدوءا عند تعاملهن مع أطفالهن، بينما كانت أمهات الأطفال الإناث شديدات الخجل من أقل الأمهات تبنيًا لهذا النمط الإيجابي من التعامل مع أبنائهن. وعندما لوحظت كل أم مع ابنها أو ابنتها، وهما يقومان معا بنشاط مشترك، تبين أن أمهات البنات متوسطات الخجل من أكثر الأمهات إيجابية تجاه أبنائهن، إذ كن أعلى - جوهريا - في الإيجابية مقارنة بكل من أمهات البنات شديدات الخجل، وأمهات الأولاد متوسطي الخجل.
وتبين أخيرا أن هناك مجموعة صغيرة شملت ستة أطفال ذكور كشف كل منهم عن درجة عالية جدا من الخجل في المنزل، ولكنهم كانوا أقل خجلا من ذلك بكثير في المعمل. وكانت أمهات هؤلاء الأطفال أقل الأمهات في إبداء مظاهر الاتجاهات الإيجابية نحو أطفالهن.
وعلينا أن نأخذ نتائج تلك الدراسة بحذر، وذلك لصغر حجم عينة الأطفال المشاركين فيها، ومن ثم العدد القليل في كل مجموعة فرعية من مجموعات الدراسة.
ومع ذلك، يمكننا القول إنه في هذه السن الصغيرة أربع سنوات، فإن خجل الإناث يستثير لدى أمهاتهن نمطا معينا من الاستجابات، يختلف عن ذلك الذي نجده لدى أمهات الذكور الخجولين.
وهو ما يبرز دور المنشئين الاجتماعيين من الراشدين في تحديد مدى المرغوبية الاجتماعية للخجل لدى كل من الذكور والإناث، ومدى تقبل المجتمع وتسامحه، بل وتشجيعه للخجل لدى الإناث، ورفضه ومقاومته واعتباره شيئا غير مرغوب لدى الذكور.
وهنا تثار الأسئلة التالية: هل المجتمع بالفعل أكثر تقبلا لخجل الإناث منه لخجل الذكور؟ وهل خجل الطفل الذكر يقلق والديه بالدرجة نفسها التي يقلق بها خجل البنت والديها؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يؤدي هذا إلى تنميط ثقافي للخجل يعتبر المجتمع من خلاله أن الأنثى الخجولة هي فتاة طيبة ووديعة ومؤدبة، في حين أن الرجل يجب أن يكون قويا مقداما، وبالتالي فإن
الخجل ينتقص من رجولته، ويكون الرجل الخجول رجلا ضعيفا غير مرغوب فيه؟ الواقع أنه يجب توخى الحذر عند محاولة الإجابة عن مثل تلك الأسئلة وغيرها، وذلك لكثير من الأسباب منها أنه من الخطأ أن نتصور أن الطفل - ذكرا كان أو أنثى - إما أن يكون خجولا وإما غير خجول، فهناك بعض أشكال سلوك الخجل التي يصعب على آباء الذكور الخجولين أن يتقبلوها منهم، ولكنهم قد يتقبلون منهم سلوكيات خجل أخرى، بل وربما يعتبرونها صفات جيدة.
لقد أثارت تانين عددا من القضايا الأساسية في ما يتعلق بالبحث عن تأثير الخجل في كيفية استخدام الفرد اللغة.
فهي تشكك كثيرا في قيمة تلك الإجراءات التي اعتمدت عليها معظم الدراسات، والتي تمثلت في مجرد إجراء تحليل كمي سطحي للمحادثة بين الطرفين الخجول والآخر بهدف حصر وحساب مدى تكرار ما نلاحظه من سلوكيات لفظية.
إذ ترى أن هذا تبسيط شديد الموقف ولا يجب الاكتفاء بذلك، لأن الفهم والتفسير الصحيحين لتلك السلوكيات اللفظية فترات الصمت وقطع الصمت والعودة إلى الكلام ومقاطعة الآخر ... إلخ، يجب أن يتم في ضوء معلومات أخرى إضافية مثل العلاقة بين طرفي المحادثة وموضوع المحادثة، وهدف كل منهما من المحادثة وأسلوب المحادثة الخاص بكل منهما .
فتحليلنا للمحادثة وما يتم فيها يجب أن يكون أكثر عمقا وشمولا، لنعرف على وجه الدقة هدف الفرد وغايته من أي سلوك لفظي يصدره خلالها. فالفرد ربما يصمت لأي سبب آخر غير كونه خجولا، وربما يقاطع الآخر لأسباب مختلفة، فقد يكون هدفه من المقاطعة هو أن يكون له سبق تحديد موضوع المحادثة، أو يريد أن يضيف إلى ما يقوله الطرف الآخر ويجعله أكثر وضوحا، أو يسعى إلى تغيير موضوع الحديث لعدم رضاه عنه، أو لأن هذا الموضوع يضايق أحد الحاضرين ... إلخ.
إن موقف المحادثة هو موقف يتضمن كثيرا من الأنشطة الاجتماعية المعقدة. وقليلة جدا تلك الأبحاث التي اهتمت بدراسة كلام الخجولين في ضوء هذا التحليل الكيفي العميق لموقف المحادثة، ولم تتوقف - كما هي الحال في معظم الدراسات - عند مجرد هذا الحصر الكمي البسيط البعض مظاهر السلوك اللفظي للخجولين في مواقف المحادثة .












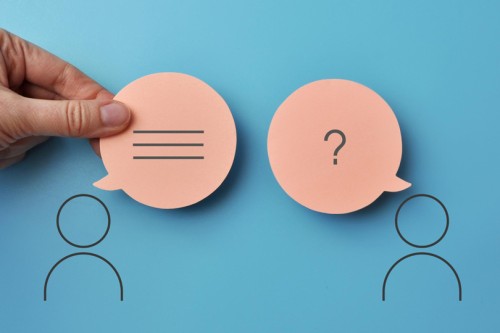



اضافةتعليق
التعليقات