فاطمة السيّد أحمد الموسوي، كاتبة وباحثة من البحرين، تنتمي إلى الحوزة العلمية حيث صاغت شخصيتها بين المعرفة الدينية والوعي الثقافي. تجمع في كتاباتها بين جمال الأدب وصدق الرسالة، لتقدّم خطاباً يعانق العقل والوجدان. ترى في القلم أمانة ومسؤولية رسالية، تستلهم من سيرة الشهيدة بنت الهدى، لتجعل من الكلمة جسرًا نحو الوعي والنهضة الأخلاقية والفكرية.
متى بدأ شغفكم بعالم الكتابة، وكيف انسجم مع تكوينكم الحوزوي؟
البدايات مع الكتابة قد لا تُختزل في تاريخٍ، أو تُحاصر في عمرٍ أو حادثة بعينها، بل هي أشبه بجدولٍ خفيّ انبثق في أعماق الروح منذ اللحظة الأولى التي انفتحت فيها العين على دهشة الوجود. وكانت القراءة هي الشرارة الأولى، من رحم الصحبة مع الكتب ومن وهج الكلمة المضيئة.
من هنا وُلد الشغف بالكتابة في طورٍ مبكرٍ بالمعنى الزمني، وأما بالمعنى الوجودي فمنذ أن عانقتُ القلم لم أره سوى أداة مقدسة، لابد أن يضمّ في طياته رسائل وكلمات تتسلل نحو القلوب لتضيء صفحات الروح والفكر، وتنير مسالك العقل والوجدان، فتترك أثرها في أعماق النفس وتستنهض الضمائر نحو السمو والمعنى.
هذا المسار الذي سلكته عند ولوج عالم الكتابة كان مرتبطاً برؤية راسخة تمسكتُ بها منذ البداية: الكتابة في الأدب الملتزم لا الأدب الخاوي. رؤية استلهمتُها من أيقونات القلم الملتزم، وعلى رأسها الشهيدة بنت الهدى، آمنة الصدر، التي جسدت منارة الالتزام بين الكلمة والرسالة، وجعلت من الكتابة مساراً نحو المعنى والوعي، لا مجرد زخرفة أو عرض للمهارة.
ومع الانغمار في التكوين الحوزوي، اتسع فضاء الكتابة ليصبح امتداداً طولياً يتسق مع النهج الروحي والمعرفي. فالمعرفة الدينية كانت الريح التي تدفع قارب الكلمة، فصارت الكتابة مساراً متداخلاً مع التكوين الحوزوي، تتماهى مع صدى النصوص الدينية، وتستشرف الحقيقة في رحاب المعنى.
هل تجدون أن الكتابة ما زالت وسيلة مؤثرة في نشر الوعي، رغم هيمنة الصورة والفيديو في مواقع التواصل؟
نعم، ما زالت الكتابة تحتفظ بسطوتها في زمن الصورة والفيديو، فالكلمة ليست مجرد حروف تُقرأ، بل أثر يتجذّر في الوعي ويمتد في الذاكرة. الصورة تلمع لحظة ثم تخبو، أمّا الكلمة فتتسرّب إلى الأعماق وتعيد تشكيل الفكر والوجدان.
ألم يبقَ أثر كلمةٍ قالها مفكر أو حكيم قروناً تتوارثها الأجيال؟ بل ألم تُخلَّد كلمات المعصومين عليهم السلام، فكانت تنير مسارات التاريخ حتى اليوم: كنهج البلاغة للإمام علي عليه السلام، ووصايا الإمام الحسين عليه السلام التي ما زالت تهزّ الضمائر وتبني الوعي بعد قرون طويلة؟ إن الكلمة، حين تصدر من صدق ورسالية، تتحول إلى نار توقظ، وإلى نور يهدي، وإلى جسر يربط الإنسان بالمعنى العميق للحياة.
فالكتابة تمنح القارئ فسحة للتأمل، وتدعوه أن يقف وجهاً لوجه أمام نفسه، بعيداً عن إيقاع العبور السريع للصور والفيديوهات. وهنا يكمن سحرها: إنها تؤسس لما هو أبقى من الدهشة العابرة، تؤسس للوعي.
كيف تصيغون خطابًا مكتوبًا يفهمه الجيل الجديد دون أن يفقد عمقه الديني والفكري؟
الخطاب المكتوب الموجَّه إلى الجيل الجديد لا يُصاغ بالتبسيط المخلّ ولا بالعمق المنغلق، بل بمزج دقيق يجعل المعنى راسخاً والكلمة مشرقة وشفافة.
فالمعرفة حين تُلقى في قوالب جافة تنفّر القارئ، وحين تُسكب في زخارف مبالغ فيها تفقد رسالتها، أمّا إذا ارتدى الفكر ثوب البلاغة الرشيقة، ورافقته السلاسة التي تحاكي عقل الشاب وروحه، عندها يظل النص محتفظاً بعمقه الديني والفكري دون أن يغترب عن قارئه.
فالكتابة إلى هذا الجيل هي استدعاء لجمال الأدب ليكون جسراً للمعرفة لا حجاباً عنها، حيث تتصالح الكلمة مع رسالتها، وتبقى راسخة في الفكر، ملامسة للقلب.
كيف يمكن أن نُشعِر الجيل الجديد بأن الدين ليس عائقًا أمام التقدم بل هو رافعة له؟
الدين ليس حائطاً يوقف طموح الإنسان، بل أساس متين لكل تقدم حقيقي. إنه يزرع في النفوس قيم الصدق والاجتهاد والصبر، ويوجّه العقل نحو رؤية متزنة للحياة، فلا يتحوّل التقدم إلى فوضى أو انحراف.
في مفاصل الحياة اليومية، من العلم إلى العمل إلى المجتمع، الدين يوفّر خارطة توجيه أخلاقية وعقلية تساعد على اتخاذ القرارات الصائبة، وتحويل المعرفة إلى إنجازات ملموسة.
حين يفهم الجيل الجديد أن التزامه بالدين لا يقيد حريته بل يمنح أفقاً أوسع للابتكار، وأن التقدم لا يُقاس بالسرعة فقط بل بالوعي والمسؤولية، سيدرك أن الدين هو رافعة للكرامة، وقوة للفكر، وعمود للارتقاء بالإنسانية، وليس عائقاً أمام تطور الحياة.
ما الدور الذي ترونه للمرأة المثقفة الحوزوية في ربط الأجيال بالقرآن والعترة؟
المرأة المثقفة الحوزوية هي الجسر الحي بين الأجيال في ربطهم بالقرآن والعترة، وهي المرشدة التي تزيل الحجب العائمة، فتكشف الحقائق وتعيد للأجيال الرؤية الصافية.
بدرايتها وعمقها الروحي، تُرسخ في نفوس المجتمع الأصالة والهوية الدينية والفكرية، فتمنع التشويش الذي تطرحه الموجات الثقافية العابرة، وتزرع بذور الوعي النقدي الجمعي.
أدواتها في ذلك متعددة: الكلمة المبصرة في الدروس والمجالس، والقدوة العملية في الالتزام والسلوك، والكتابة النافذة إلى القلوب، والنصيحة الرقيقة التي توقظ الضمائر.
وهي بذلك لا تكتفي بإيصال المعرفة، بل تصنع تجربة حية من الانصهار بين الدين والحياة، لتصبح الأجيال قادرة على فهم القرآن والعترة ليس كمجرد نصوص، بل كمسار للحياة، ومرشد للسلوك، ومنارة للوعي والارتقاء.
في ظل الانفتاح الرقمي، كيف ترسمون حدودًا واضحة في العلاقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
رسم الحدود يبدأ بالوعي بالنية والغرض من التواصل، وبمعرفة ما هو مسموح وما هو مرفوض، مع الحفاظ على الحياد النفسي والعاطفي؛ فلا غرق في الصداقات العابرة، ولا انكشاف غير مسؤول للذات. كما يقتضي التنبه لآليات الانفلات الرقمي، مثل الإفراط في المشاركة، أو الانجراف وراء الإعجاب والتفاعل الفارغ، مع استثمار الوقت في بناء علاقات واقعية وهادفة، تتماشى مع القيم والمبادئ، وتغذي العقل والروح دون أن تهدرهما.
كما يجب رسم حدود واضحة مع الجنس الآخر، بحيث يبقى التواصل ضمن أطر الشرع، بلا أريحية زائدة أو اختلاط غير ضروري.
بهذا الشكل، تصبح العلاقات الرقمية أداة للمعرفة والتواصل البناء، لا فخاً للانحراف أو الغموض، ولا مساحة للتخبط والانفلات، بل امتداداً واعياً لهوية الفرد ورساليته في العالم الافتراضي.
ما القيم أو الضوابط التي تنصحون الفتيات بالتمسك بها في استخدام هذه الوسائل؟
أنصح الفتيات بالتمسك بالضوابط الأساسية: الصدق في النية، وضبط النفس في الكلام، وحفظ الخصوصية، والالتزام بالحدود الشرعية، وعدم الانجراف وراء الإعجاب والتفاعل الفارغ، وحمل هدف محدد يوجّه حضورها ويمنحه معنى. وبهذه القيم تصبح وسائل التواصل أداة للمعرفة والتواصل البناء، لا فخاً للانحراف أو التفريط بالهوية والعفة.
كيف يمكن أن تتحول مواقع التواصل من تهديد للقيم إلى وسيلة لخدمة الدين والمجتمع؟
حين تُستثمر النوايا الصادقة والمعرفة الهادفة، تتحول المنصات إلى منابر للوعي والمعرفة. وقد شهدت الساحة الرقمية أمثلة حيّة على ذلك، إذ استطاع بعض الروّاد الرساليين أن يحوّلوا فضاءً غارقاً في الانحلال إلى منبر للوعي، فارتفعت الكلمات فوق ضجيج الفراغ، وأصبحت المنصة جسراً يربط الحياة بالدين، والعقل بالقيم، والرسالة بالمتلقي.
ما النصيحة التي تقدمونها للكاتبات الشابات اللواتي يرغبن في الجمع بين الأدب والفكر الديني؟
أن لا يفصلن بين جمالية الأسلوب وصدق الرسالة، بل يندمج القلم فيهما ككيان واحد، فيغدو الأدب أداة إشراق، والفكر الديني نبراساً يوجّه السطور ويضيء العقول.
وإن الجمع بين الأدب والفكر الديني ليس مجرد زخرفة للنصوص، بل خلق فضاء متداخل تنبض فيه الروح، ويعلو فيه المعنى، ويستقر في قلب القارئ أثر لا يُمحى.
ولتحقيق هذا الانسجام، لابد من تحصيل المعرفة الدينية والتأمل الواعي، وجعل الكتابة رحلة بين الجمال والإلهام، بين اللغة والرسالة، بين الذائقة والفكر، حتى تصبح كل جملة صدى للوعي، وكل نصّ مرآة لرسالة صادقة.
ما هي الرؤية المستقبلية التي تحملونها لمشروع المرأة الحوزوية في ميدان الثقافة والإعلام؟
حين تخلو الساحة الرقمية من النساء الرساليات، تُترك العقول عرضةً للتشويش والانجراف. والرؤية المستقبلية لمشروع المرأة الحوزوية في الثقافة والإعلام تقوم على ملء هذه الفجوة بحضور نساء رساليات مثقفات، يقدمن محتوى رقمياً يخدم الإسلام، ويقود الفكر، ويوقظ الوعي. ففي عالم يتسارع فيه الانفتاح الرقمي وتغمره موجات المشهورات والمؤثرات، يصبح من الضروري أن يكون لكل منشور، ولكل محتوى هدف واضح: غرس القيم، تعزيز الأصالة، وربط الجيل الجديد بالرسالة الحقيقية للإسلام.
هذا المشروع يرتكز على مسؤولية المرأة الحوزوية في تبيين الحقائق، وإيقاظ الضمائر، وصنع إعلام يوازن بين التطور الرقمي والهوية الدينية. فبهذا الحضور، تتحول المنصات الرقمية من ساحات مبعثرة إلى فضاءات تثقيفية هادفة، ورافعة للوعي، ودرع يحمي عقول الشباب من الانجراف، وجسر يصل بين الأصالة والمعاصرة.
أخيرًا، كيف تقيّمون أثر حضور المرأة الواعية في إحداث تغيير حقيقي في المجتمع؟
حضور المرأة الواعية في المجتمع ليس امتداداً ثانوياً، بل ركيزة أساسية في بناء الأمة وحفظ هويتها. فالمرأة شريك فاعل في الحركة الثقافية والاجتماعية والسياسية، حاملة رسالتها الروحية والأخلاقية كما أرادها القرآن الكريم. فهي في الأسرة تربي الأجيال على القيم، وفي المجتمع تشكّل وعياً جماعياً، وفي الفضاء العام تقود الفكر بالمعرفة والالتزام.
من هذا المنظور، تصبح المرأة مرآة المجتمع ومصدر إلهام للرسالة الأصيلة، قادرة على أن تحوّل الوعي الفردي إلى حركة حضارية، وتحقق التوازن بين روح الدين ومتطلبات الحياة.








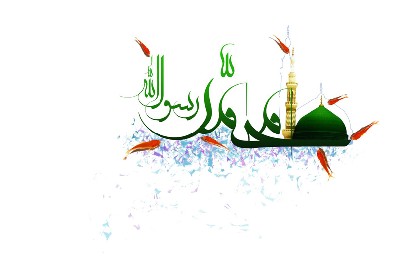





اضافةتعليق
التعليقات