في أروقة التاريخ المضمخة بأريج الحكمة، يتوقف الزمن احترامًا عند سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)، ذلك الرجل الذي لم يكن فقيهًا فقط، بل كان أمةً وحده، ومشروعًا معرفيًا متكاملًا، زرع البذور الأولى لفكرٍ ديني ينظر بعينين: عينٍ ترى النص وتحترمه، وأخرى تغوص في عمق العقل لفهم النص وتفسيره.
كان الإمام الصادق ابنًا لزمنٍ مضطرب سياسيًا، لكنه في قلب هذا الاضطراب صنع ثباتًا علميًا ما زالت آثاره حاضرة حتى اليوم. فقد تجلّت في الإمام جعفر الصادق صورةُ الأخلاق المحمدية بأبهى حللها، فكان التسامح من سماته البارزة، لا يحقد على أحد، ولا يُقابل الإساءة إلا بالإحسان. كان زاهدًا في الدنيا، مترفعًا عن زخارفها، يراها وسيلة لا غاية، ويُعلّم أتباعه أن الغنى الحقيقي هو غنى النفس.
كان صبره مضرب الأمثال؛ فقد عاش في زمنٍ مضطرب، بين انهيار الدولة الأموية وصعود الدولة العباسية، ومع ذلك لم ينجرف إلى العنف، بل ثبت على مبدأ الإصلاح بالحكمة والموعظة الحسنة. لم يكن يضيق صدره بالاختلاف، بل كان منفتحًا حتى على مخالفيه في الرأي، يجادلهم بالحجة والبرهان، ويدعو إلى الحوار الهادئ البنّاء، ملتزمًا بقول الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلِىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾.
وقد شهد له خصومه قبل محبّيه بأنه كان عالمًا لا يُجارى، وصادقًا لا يُكذّب، وأن مجلسه كان ملتقىً للعقول، لا ميدانًا للخصام. لم يكن يحمل علمًا فقط، بل كان يحمل قلبًا كبيرًا، وسيرة تفيض عدلًا ورحمة، مما جعله منارة هادية على مرّ العصور.
في المدينة المنورة، حيث كانت تنبض بالحياة العلمية، أسّس الإمام مدرسته الكبرى التي ضمّت آلاف الطلاب، وتعدّدت فيها مجالات البحث من الفقه والكلام إلى الطب والكيمياء والفلك. لم يكن حبيس محراب أو حاشية، بل كان منفتحًا على الحوار، يقارع الحجة بالحجة، ويشجع تلاميذه على التفكير والتساؤل. وكان عليه السلام يقول: "عليكم بالنظر في معاني الكلام، فإن فيه مفتاح أبواب المعرفة."
لقد خالف الإمام الصادق الجمود الذي أصاب بعض العقول الدينية في زمانه، فلم يكن يكتفي برواية الحديث، بل يعيد قراءته في ضوء مقاصد الشريعة وروح النص. وفي هذا السياق، لم يتردّد في مناقشة أصحاب المدارس الفلسفية، بل شجّع على تعلم الرياضيات والطب، لأنه كان يرى أن الدين ليس نقيض العلم، بل حاضنته الكبرى.
ولعل من أبرز ما يميّز فكر الإمام هو جمعه بين النقل والعقل دون أن يسمح لأحدهما أن يطغى على الآخر. فبينما اعتمد القرآن والسنة أساسًا، لم يُغفل دور العقل في الاستنباط، ولذلك كان يقول: "إن الله لا يُعبد بغير علم، والعلم لا يكون إلا من عالم، وعالم لا يكون إلا من عمل بعلمه."
لقد كان تأثير الإمام الصادق عميقًا في طلابه الذين انتشروا في الأمصار، حاملين علمه وفكره المعتدل، ومن أبرزهم أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس، وهما من أعمدة الفقه الإسلامي. وقد شهد أبو حنيفة قائلًا: "ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد." وهذا ما يدل على عمق تأثيره وتقدير العلماء له، حتى من غير أتباع مذهبه.
لم يكن الإمام الصادق حكرًا على طائفة دون أخرى، بل كان رمزًا للوحدة العلمية، وجسرًا بين المذاهب، إذ اجتمع حوله من يختلفون في العقيدة ولكن يتفقون في طلب العلم. فمكانته لم تُبنَ فقط على نسبه الشريف، بل على علمه الغزير، وفكره المتسامح، وأسلوبه الفريد في الحوار والتربية.
لقد ترك مدرسة فكرية ما زالت أصولها تضيء العقول حتى اليوم، وتدعو إلى البحث والتأمل والانفتاح، لا إلى الجمود والانغلاق. ومن هنا، يستحق الإمام الصادق أن يُعدّ واحدًا من أعظم أئمة الإسلام، الذين جمعوا بين العلم والعمل، وبين الزهد والانفتاح، وبين الثبات والتجديد.
لقد عاصر الإمام الصادق زوال بني أمية وقيام بني العباس، لكنه آثر الانصراف عن السياسة الظاهرة إلى مشروع أعمق: بناء الإنسان العارف، لا الحاكم المتسلّط. وفي الوقت الذي كان الخلفاء يتصارعون على السلطة، ويتفننون في أدوات القمع والتشهير، كان الإمام الصادق يزرع في تلامذته قيم المعرفة والحرية والصدق.
إلا أن طريقه لم يكن ممهّدًا؛ فقد واجهته صعوبات جمّة وهو يخدم العلم ويرسي قيم الدين. من أبرز ما واجهه، الحصار الفكري والرقابة السياسية؛ فكان يُراقب من قبل السلطات التي رأت في علمه ونفوذه تهديدًا لمشروعها السلطوي. وكم من مرة استُدعي للمثول أمام الخلفاء العباسيين، لا تكريمًا، بل ترهيبًا وتهديدًا. كما عانى من محاولات التشويه التي سعى خصومه لزرعها في أذهان العامة، بهدف الحد من تأثيره وانتشار فكره.
ورغم كل ذلك، لم يهادن في الحق، ولم يُساوم على مبادئه، بل واصل بثّ علومه سرًا وجهارًا، فأسس مدرسة فكرية عميقة، كانت بمثابة ثورة صامتة في وجه الاستبداد، تستبدل السيف بالقلم، والولاء الأعمى بالوعي الحر، والطاعة العمياء بالاجتهاد الواعي.
لقد أدرك الإمام الصادق (عليه السلام) أن بقاء الدين لا يتحقق بقيام دولة تُرفع فيها الرايات، بل ببناء ضمير حيّ، وعقل مفكّر، وإنسان حرّ يعرف ربه عن بصيرة، لا عن تقليد.












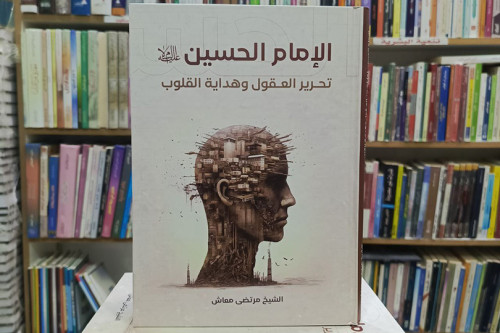

اضافةتعليق
التعليقات