لا يسعنا في بحثنا عن القيادة الربانية سوى التكلم عن أهمية القيادة ودورها الفاعل في صياغة المجتمع وبقي علينا أن نسلط الضوء على مختلف جوانب البحث لا سيما ما يتعلق بمصير الأمة، بدءاً بالأسس الشرعية ودورها الريادي، فهناك تفاصيل دقيقة وعميقة في الإنسان لا يمكن سبر غورها، إلا بعد تشخيص القيادة. لذا فاختيار القائد في الشرع الإسلامي موكول إلى الله تعالى، فهو الذي يعين ويقرر القائد للأمة، وإذا كان خالق الإنسان قد قيض القدوة والأسوة وأوضح معالمها، فينبغي للإنسان التأسي واقتفاء أثر النموذج وهم الأنبياء، أما لماذا؟ فلكي تنمو فيه بذرة القيم وتورق شجرة الأخلاق. وكما هو ثابت فإن الأخلاق لا تورق إلا إذا توفرت القابليات وتهيأت الأرضية لنموها، ولا توجد الأرضية من فراغ أو بدون مقدمات وإنما لكل شيء سبب ومن أهم الأسباب التي تخلق الأرضية الوراثة والنموذج. فإذا كان الأب طيباً ومستقيماً إلى جانب الأم، فإنهم يورثون الطيب والاستقامة لأولادهم، ومن ثم يأتي العامل الآخر وهو النموذج، لذلك فإن مهمة الأنبياء تتمثل في إقامة البناء، بعد أن قدموا نموذجاً طيباً وبعبارة أدق إيجاد بنى تحتية في كيان الإنسان. إن الشيء المهم في البناء يكمن في الأخلاق ويُعد العامل الأول في نموها. فإذا لم يتم سقي الأخلاق بماء المكرمات فإنها تموت وتذبل وهكذا فالكلمات والعبارات لا تمنح الأخلاق فضلاً عن نموها، والكلام لا يجدي بدون العمل حتى لو استغرق آلاف السنين، ونطقت به ملايين الألسن ما لم يكن نموذجاً يحتذى به، وأسوة يقتدى بها. قال الله تعالى في محكم كتابه: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (الكهف ١٥). لقد قدم الباري عز وجل العمل الصالح على القول، فثبت عنواناً مضيئاً للمسلم وللواقع الإسلامي (العمل أولاً وأخيراً). لذا فإن الله عز وجل أتى بعبارة (وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (فصلت ٣٣) وهذه صفة المؤمن فالمؤمن قليل الكلام ولكنه كثير العمل، إن الأمة الإسلامية بحاجة إلى من يطبق ويجسد المثل الإسلامية، وليست بحاجة إلى من يتكلم ويتحذلق بالكلام. لقد ملّ الناس الكلام وضاقوا ذرعاً بالمتكلمين الذين يفتقرون إلى الواقع الذي يصدق أقوالهم، وهكذا ومن جراء افتقار المتكلمين إلى الواقع أصاب الكثير الخيبة واليأس من عدم تطبيق القيم وتجسيدها عملياً، وبات الكثير لا يصدق بحيوية القيم وواقعيتها. إن المشكلة التي تعاني منها الأمة الإسلامية ليست في المتكلمين والمتحذلقين، وهؤلاء والحمد لله كثر عددهم وذاع صيتهم وأصبحت الألسن الببغائية تلهج بهم كل حين، ولكنها تكمن في التطبيق والتجسيد وتمثيل القيم العليا التي جاء بها الإسلام ، وهذه في نظري من أهم المشاكل التي يعاني منها المسلمون وهي السبب في بروز معظم المشاكل التي منها الازدواجية والنفعية وبروز طبقة المتلبسين بالدين الذين أصبح همهم جمع المال باسم الدين، وفي نظري فإنّ الساكت غير العامل أفضل بكثير من المتكلم غير العامل. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا (۲) عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ (الصف٢-٣). فالأمة التي تقتصد في كلامها وتقدم حلولاً عملية المشاريعها وترسم منهجاً واقعياً لكيانها هي التي تقطف الثمار الطيبة وتبني مستقبلاً مضيئاً لأجيالها والأمم التي تعمل وفق القواعد المنطقية، والأسس المتينة إنما تثبت خطوة أساسية على طريق بناء الذات، وتثبيت الأعمدة الأساسية، التي أضحت سهلة بسبب وفرة العلوم والأفكار. ويا حبّذا لو تستغل العقول النيرة والنفوس المؤمنة هذه العلوم والأفكار لتوظيفها في مجال خدمة الإنسانية، وخدمة العقول التي تهفو إلى المبادئ السليمة والتي طالما حرمت منها فاستغلتها عقول مشبعة بالأفكار الشيطانية، فراحت تهوي بها نحو الانحراف والزيف. وهكذا استغلت هذه العقول الشيطانية الفضائيات ووسائل الإعلام فأشبعتها ببرامج متهتكة ومخلة بالشرف، فسلبت من الناس (فرص التقدم العلمي) وجردتهم من لباس الأخلاق والشهامة فأضحى من لا يفقه معاني الفضيلة والأخلاق ينسج على منوالهم ويحاكي سلوكهم الشاذ، الأمر الذي خلق جيلاً مستهتراً بالأخلاق، وبعيداً عن القيم الإلهية. فينبغي للمسلمين وضع الفرص المواتية في حسابهم، ثم التهيؤ اللازم لاقتناصها لئلا تمر فيستغلها الآخرون كما هو حاصل الآن. وحتى لا نكون بعيدين عن الواقع نقول على المرجعية الرشيدة استغلال الفرص الإعلامية ، ومنها الفضائيات فهذه تعد الآن من الوسائل الإعلامية المهمة التي تلعب دوراً كبيراً في صناعة القرار، وصياغة الأفكار، حسبما تمليه العقول الشيطانية ومع أهمية هذه الوسائل نرى المؤسسات الإسلامية لا تهتم بها، والسؤال لماذا التغاضي عن هذه الوسيلة الإستراتيجية التي أضحت الدول والمؤسسات توليها اهتماماً بالغاً، وترصد لها ميزانية ضخمة، فما المانع أن نرصد ميزانية تتناسب مع مستوى المسؤولية. إننا والحمد لله لا يعوزنا شيء سواء في مجال الفكر والأدب الذي به إثراء العقول والنفوس أو في مجال العلم والثقافة، فهناك طاقات خلاقة في مجال الصحافة والكتابة والشعر والنثر والتربية والعلوم العصرية ما لا يتوفر لغيرنا، وهذه حقيقة لا مبالغة فيها، وما علينا إلا أن نخطو الخطوة الأولى، ولكن وفق خطة مدروسة ومحبوكة. فالعمل وإن كان يسيراً إلا إنه يفتح آفاقاً عديدة، ويمهد السبيل لاستغلال الفرص، فالكثير من العمالقة بدؤوا من الصفر، ولكنهم وضعوا في حسابهم النتائج والأهداف العالية فحصلوا على زخم متواصل وروح وثابة نهضت بهم إلى مستوى عال، ولا أدل على ذلك من صانع الكمبيوتر فهو بدأ قياساً إلى الإمكانيات من الصفر، ولكن عندما وضع في حسابه الأهداف قــام بخطوات عملاقة فأطل على عالم واسع ورحب فأخذ يتقدم ويقطع الخطوات بنجاح باهر . وهكذا فالعاملون اقتنصوا الفرص الذهبية التي كانت متاحة للجميع، قال تعالى: ﴿كُلاَ نُمِدُّ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ محظوراً (الاسراء ٢٠). أدب الكلام والسلوك والأخلاق والمعاملة، فهناك إذن حث وتشجيع وتثمين للعلم والعلماء مما يتيح فرصاً للإنسان لكي يتقدم ويكتسب المقام المحمود، فالفرص متوفرة ومتاحة لمن يستغلها، أما إذا فرطنا في استغلالها الواقعي لها فسوف تستغلها عقول صانعي القنابل النووية والجرثومية والهيدروجينية وصانع البرامج الإباحية والأفلام الخلاعية التي أصبحت معولاً هداماً يدك البيوت والعوائل، ويستغلها أيضاً صانع المشروبات الكحولية وصانع الأزياء والكماليات الذي يهمش الأساسيات ويقلص فرص التقدم الحقيقي عند المسلمين. فنرى الآن الكثير من المحلات في سوق المسلمين أخذت تتفنن في جلب الزبائن لشراء الفستان والبنطلون والقميص والحذاء وما شابه من الكماليات، وتصرف الملايين للدعاية . وفي المقابل هنا تهميش للعلم والثقافة والفكر، فأصبح العلم والفكر لا يذكران ، وبدل عنهما موضات الفستان، وهكذا أصبحت تدور على الأسر والعوائل آخر موضات الألبسة وآخر موديلات الأثاث وما شابه، في حين قلما يسأل أحد عما هو جديد في عالم التأليف والأدب والصناعة، على كل حال فالخيارات الآن مفتوحة والأبواب مشرعة وبإمكان الجميع اقتناص الفرص. ولرب سائل يسأل: ما هي علاقة حديث استغلال الفرص بالقيادة؟ الجواب: إن القيادة الرشيدة تقدر وتثمن كل ما يقدم الإنسان ويطوره وتضع في حسابها الوقت الذي هو جزء مهم في حياته لذا فهي تقدر أكثر من غيرها عامل الوقت وحيويته بالنسبة إلى المجتمع.
وفي هذا السياق كانت أحاديث الإمام الجواد علاجاً تطبيقاً ومعنويا لكل تلك المشكلات الشائعة حيث قال (عليه السلام): "ما هدم الدين مثل البدع، ولا أفسد الرجال مثل الطمع، وبالراعي تصلح الرعية، وبالدعاء تصرف البلية".










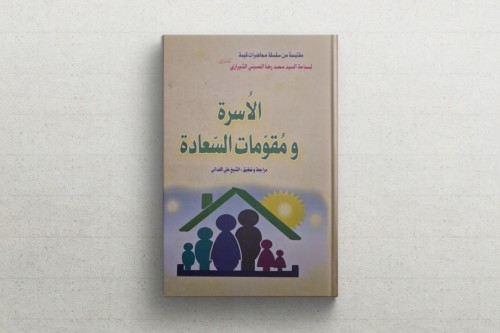



اضافةتعليق
التعليقات