هناك بعض الجوانب الإيجابية الخفية التي يمكنك الاستفادة منها من قضائك وقتاً طويلاً في رحلتك اليومية إلى مكان العمل ذهاباً وإياباً؛ بدءاً من تقليل وزنك، وصولاً إلى تحسين حالتك المزاجية.
قد يكون مُثبطاً لعزيمتك أن تعلم مقدار الوقت الذي تقضيه وأنت تتنقل بين وسائل المواصلات المختلفة في طريقك إلى مقصدٍ ما قد يكون مكان عملك. فالبريطاني الذي يعيش في لندن مثلاً يقضي أكثر من 40 دقيقةً في المتوسط ذهاباً ومثلها إياباً في رحلته اليومية من منزله إلى عمله وبالعكس.
ويعني ذلك أن سكان لندن يقضون في رحلة الذهاب والعودة اليومية من العمل، وقتاً يماثل ما يمضونه وهم يتفاعلون مع من حولهم اجتماعياً، أو يزجونه في ممارسة ما يحلو لهم من هوايات. ومع أن هذه المدة ربما تكون الأطول من نوعها في المتوسط على مستوى أوروبا، فإن الوضع أسوأ في العديد من المدن الكبرى في العالم خارج تلك القارة.
وفي ضوء ذلك، من ذا الذي لا يفضل أن يمضي ذلك الوقت مع أصدقائه، أو في صالة الألعاب الرياضية، أو حتى جالساً مسترخياً إلى حد الجمود التام أمام شاشة التليفزيون؟
لهؤلاء يمكن القول إن الصورة ليست سوداء تماماً، فقد أفادت سلسلةٌ من الدراسات التي نُشِرَت خلال الأعوام القليلة الماضية، بأن لرحلتيْ الذهاب إلى العمل والعودة منه جوانب إيجابية أيضاً، خاصة إذا كنت تستخدم خلالهما وسائل النقل العام. وقد يجعل التعرف على هذه الإيجابيات وإدراكها تلك الرحلة من وإلى العمل أقل إرهاقاً.
فإذا أخذت مثلاً رحلة الذهاب الصباحية إلى العمل، ستجد أن الضغوط التي تكتنفها بسبب ازدحام الحافلة أو القطار يمكن أن تُشعِرَك بلا شك أنك منهكٌ حتى قبل أن تصل إلى العمل. لكن بعض الدراسات المدهشة التي أجراها الباحث جون ياخيموغيتش في كلية كولومبيا لإدارة الأعمال تُظهر أنك لست بحاجة للشعور بأنك مُستنزف إلى هذه الدرجة.
فقد وجد ياخيموغيتش أن الأشخاص المنخرطين في ما يُعرف بـ"التفكير والتنقيب المرتبط بالعمل"، أي أولئك الذين يفكرون ويخططون ليومهم وأسبوعهم في العمل مسبقاً والخطوات التي يحتاجونها لإنجاز أهدافهم المهنية، يميلون لأن يكونوا أكثر قدرة على مواجهة الضغوط الناجمة عن الرحلة اليومية إلى العمل، مُقارنةً بمن تهيم عقولهم بلا هدى بين الأفكار والخواطر. ويُترجم ذلك إلى شعورهم بقدرٍ أكبر من الرضا الوظيفي على مدار يوم العمل.
يبلغ متوسط مدة الرحلة اليومية من وإلى العمل في مختلف أنحاء العالم 38 دقيقة. ولكن لا يُعلم حتى الآن سوى القليل للغاية عن كيفية موازنة التأثيرات السلبية للرحلات الطويلة في هذا الإطار
ويعتقد ياخيموغيتش أن هذه الفوائد تنجم من حقيقة أن تلك الرحلة الصباحية تخفف الصراع الذي نشعر به بين أدوارنا في المنزل ومثيلتها في مكان العمل. ففي كل الأحوال، يختلف سلوكك في المنزل - كشخصٍ شريكٍ في مسكنٍ ما أو زوج/زوجة أو أب/أم - على نحوٍ كبيرٍ للغاية عن الطرق التي يُتوقع أن تتصرف بها في مكان العمل.
وهناك بعض الأشخاص يعجزون عن التنقل بشكلٍ طبيعي للغاية بين هذين النوعين من الأدوار، ما يخلق إحساساً بالصراع يمكن أن يفاقم الضغوط المرتبطة بالعمل.
ويقول الباحث في هذا الصدد: "عندما نَعْلَق بين هذين النوعين من الأدوار - وهو ما يسميه الباحثون 'التباس الدور' - نشعر بصراعٍ، وهو ما يقود إلى الكثير من النتائج السلبية"، مثل الشعور بالإنهاك والاستنزاف.
ويضيف بالقول إن ذلك يجعل قضاءك لحظاتٍ من التفكير في يوم العمل الذي ينتظرك، أمراً قد يخفف من وطأة انتقالك من أداء الأدوار المنزلية للاضطلاع بنظيراتها المهنية، ما يقلل الضغط الواقع على كاهلك بمجرد أن تصل إلى مكتبك.
ويخلص ياخيموغيتش إلى التأكيد على أن "الفترة الزمنية الفاصلة بين مغادرة المنزل والوصول إلى العمل تمثل بحق فرصةً رائعةً يمكن أن يغتنمها الناس للانتقال" بين نوعيْ الأدوار هذين.
أما في رحلة العودة المسائية من العمل، فربما يكون الوقت مناسباً لتعزيز قدرتك على تذكر الأشياء التي تعلمتها على مدار اليوم. وفي هذا السياق، طلبت الباحثة فرانشيسكا جينو من كلية هارفارد للأعمال من أشخاصٍ يتدربون على العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أن يقضوا 15 دقيقةً في التأمل في نهاية كل يوم.
وبحلول نهاية فترة الدراسة هذه، تبين أن أداء هؤلاء بات أفضل بنسبة 20 في المئة من أقرانهم الذين قضوا تلك الدقائق في القيام بنشاطٍ إضافيٍ ينطوي على حركة لا تأمل. وإذا كان المشاركون في التجربة التي أجرتها جينو قد انخرطوا - على نحوٍ لا يمكن إنكاره - في التأمل والتفكير في ما مر بهم خلال يوم العمل وهم مرتاحون في مكاتبهم، فإنه ما من سبب يحول دون أن تغتنم أنت الفترة التي تقضيها في رحلة عودتك المسائية إلى منزلك، في أن تتفكر بهدوءٍ وسكينةٍ في الدروس التي تعلمتها أثناء يومك.
بطبيعة الحال، يفضل الكثيرون مصدر إلهاء أو انشغال يتطلب منهم التفاعل والمشاركة بشكل أكبر. ويجدر بنا هنا أن نتذكر كم يمكن أن تكون هذه اللحظات المُختلسة من اليوم مُثمرةً ومنتجةً على المدى الطويل.
كشفت "بي بي سي كابيتال" مؤخراً أن بوسع من يقضي نحو ست ساعات في رحلاته إلى العمل ومنه أسبوعياً، مطالعة كتاب مؤلف من 100 ألف كلمة، أو الاستماع إليه، خلال تلك الفترة
فقد كشفت "بي بي سي كابيتال" مؤخراً أن بوسع الشخص الذي يقضي نحو ست ساعات في رحلاته إلى العمل ومنه أسبوعياً، مطالعة كتاب مؤلف من 100 ألف كلمة أو الاستماع إليه، خلال هذه الفترة.
وقد يقرر آخرون تعلم لغةٍ جديدةٍ أثناء تلك الرحلات. وتظهر الدراسات التي أجراها علماء في الأعصاب أننا غالباً ما نتعلم على نحوٍ أفضل، حينما ندرس المعلومات التي نتلقاها على فتراتٍ زمنيةٍ متباعدةٍ، وتمثل رحلات الذهاب إلى العمل والإياب منه الفترة المثالية لوضع هذا المبدأ موضع التطبيق.
وحتى إذا أطلقت لذهنك العنان للتفكير في ما يحلو له، فربما ستجد أنك تمكنت - وبصورة غير متوقعة - من حل مشكلة معقدة، وذلك في ظل أدلة تفيد بأن قضاء المرء وقتاً يُشْغِل عقله فيه بمصدر تسليةٍ لا يتطلب تفكيراً، قد يقود إلى حدوث ومضاتٍ خاطفةٍ من الابتكار والإبداع.
وعلى أي حال، فإنك لست بحاجة إلى قضاء وقت أطول من اللازم في أيٍ من هذه الأنشطة، التي يمكن أن تتخلل تصفحك لما يرد على حسابيك على تويتر وإنستغرام مثلاً، إذ أن تكريس بعض الوقت للتأمل قد يجعل رحلتك إلى العمل ومنه، عاملاً مساعداً لك على تعزيز مستوى إنتاجيتك وتحسين شعورك بالإنجاز كذلك.
إضافةً إلى ذلك ربما تجلب "محنتك" اليومية في طريق العمل ذهابا وإيابا، فوائد غير متوقعة تعود على صحتك البدنية. فقد أفادت دراسة أُجريت على من يخوضون غمار هذه الرحلات في تايوان بأن من يستخدمون وسائل النقل العام منهم يصبحون أقل عرضة بنسبة 15 في المئة للبدانة واكتساب الوزن الزائد، مُقارنةً بأولئك الذين يستقلون السيارة لهذا الغرض.
ومن الأمور الحاسمة في هذا الشأن، أن العلاقة بين استخدام وسائل النقل العام وتقلص فرص التعرض للبدانة تظل قائمةً، حتى عندما نضع في الحسبان عوامل محتملةً أخرى قد تؤثر في اللياقة البدنية للمرء بدورها مثل مستواه "الاقتصادي والاجتماعي".
ومع أن رحلتك على متن القطار أو الحافلة لا تنطوي بطبيعة الحال على بذل المجهود البدني نفسه الذي يتطلبه حضورك صفاً لممارسة رقصة الزومبا مثلاً، فإن هذه الرحلة لها متطلباتها البدنية كذلك، إذ أنها تستلزم عادةً التمشية ذهاباً إلى محطة القطار أو الحافلة وإياباً منها، وقد أظهرت الدراسة التي أُجريت في تايوان أن هذه الفترات القصيرة من النشاط البدني، يمكن ان تُحْدِثْ فارقاً لا يُستهان به على صعيد مستوى لياقتك البدنية.
تفيد دراسة بأن قرابة ثلث من يستخدمون وسائل النقل العام إلى العمل ومنه يحققون نتائج تماثل ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً، وهو ما توصي به بعض الجهات.
وللتعرف على مزيدٍ من المعلومات في هذا الشأن، أجرى ريتشارد باترسون من كلية لندن الإمبراطورية (الكلية الإمبريالية للعلوم والتكنولوجيا والطب) دراسةً تحليليةً على بياناتٍ مُفصلة خاصة بمسحٍ يُجرى دورياً في إنجلترا للتعرف على التوجهات طويلة المدى للسكان فيما يتعلق بالتنقل والسفر.
وتبين لهذا الباحث أن نحو ثلث من يستخدمون وسائل النقل العام من بين هؤلاء يلبون - بشكلٍ غير مباشر وبما يبذلونه من جهدٍ خلال رحلاتهم اليومية هذه وحدها - توصيات الحكومة البريطانية بممارسة الرياضة 30 دقيقةً يومياً.
ويشير باترسون إلى أن الحكومة يمكن أن تضع هذه الفوائد في الحسبان، عندما تكون بصدد اتخاذ قراراتها الخاصة بتحديد التمويل الذي توفره لشبكات النقل والمواصلات، وذلك بالنظر إلى التأثير الفعلي الذي يمكن أن يترتب في نهاية المطاف على الصحة العامة، بفعل تشجيع الناس على التخلي عن استخدام سياراتهم في الذهاب إلى العمل والعودة منه واللجوء بدلاً من ذلك إلى الحافلات أو القطارات.
ففي المملكة المتحدة مثلاً، أفادت تقديرات هذا الباحث بأن زيادة استخدام وسائل النقل العام بنسبة 10 في المئة، قد يؤدي إلى أن يزيد عدد من يصلون إلى المستويات الموصى بها من النشاط البدني في البلاد إلى 1.2 مليون شخص. ويقول باترسون: "قد يكون لبعض القرارات التي لا يبدو أنها ترتبط بشكل كبير بشؤون الصحة، تلك التأثيرات الحتمية وغير المباشرة في الوقت نفسه على عافية الإنسان".
وبرغم أن باترسون لا يزعم بالتأكيد أن قطعك لرحلتك اليومية هذه، قد يشكل بديلاً عن ترددك المنتظم على صالات الألعاب الرياضية، فإن الإقرار بهذه المنافع وإدراكها قد يخفف - بالقطع - من وطأة تلك الرحلة المحبطة.
وعلى كل الأحوال، أظهرت الدراسات النفسية مراراً وتكراراً أن الضغوط الناجمة عن أمرٍ ما، تعتمد بشكلٍ كبيرٍ غالباً على الطريقة التي ننظر بها إلى هذا الأمر. فربما يكون هناك اختلافٌ لا يكاد أن يُلحظ في تأثيرات موقفين يبدوان متماثليْن ظاهرياً بكل معيارٍ موضوعي، وذلك تبعاً لتفسيرنا الخاص لكلٍ منهما. كأن نرى أن هذا الموقف يُشعرنا بأن لدينا الاستقلالية مثلاً، أو أن ذاك يجعلنا نشعر بأن ما نفعله يُسهم في تحقيق هدفٍ أسمى.
اللافت أن هذه التغيرات ليست ذاتية وتختلف من شخصٍ لآخر فحسب، بل إنها تنعكس كذلك في صورة مادية ملموسة، مثل حدوث تغيرٍ في مستوى هرمون الكورتيزول الذي يفرزه الجسم بفعل الشعور بالتوتر والإجهاد.
وهكذا فإن التعرف على المنافع التي تعود على المرء من رحلته اليومية ذهاباً إلى العمل وإياباً منه وإعادة تقييمها كذلك، بما يجعلها لا تبدو أشبه بوقتٍ ضائعٍ ومُهدر كما قد تراها في الوقت الحالي، يمكن أن يُحْدِثْ تأثيراً حقيقياً في تجربتك في هذا الشأن برمتها، ما قد يغير نظرتك بعد الآن إلى يومك بشكل سلبي وكئيب. حسب بي بي سي.





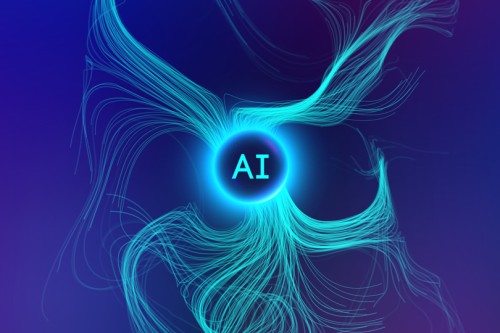


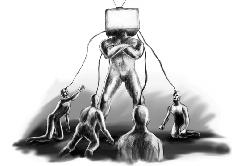





اضافةتعليق
التعليقات