يمثّل القرآن الكريم، بغضّ النظر عن كونه مرجعًا دينيًا وعقائديًا، مرجعًا إنسانيًا وعلميًا ضخمًا أيضًا، إلا أنه لا يجد مكانًا بارزًا في الجامعات والمؤسسات البحثية.
ومما يفسّر ذلك هو أن كثيرًا من المسلمين يتعاملون مع القرآن ككتاب ديني فقط، ولا يتعاملون معه كمصدر للعلوم والمعرفة وبناء التصورات.
إن عملية إقصاء القرآن عن الدراسات الأكاديمية تعني تقليص الفهم العميق للمفاهيم الدينية التي تجمع بين الدين والعلم، وتضع الأسس المنهجية لعلاقة الإنسان بالكون والمجتمع. وتجاهل القرآن يعني فقدان المنظور الشامل للإنسان، الذي يتضمن الجوانب الأخلاقية والتربوية والروحية، إلى جانب الجوانب العقلية والعلمية.
فيكون القرآن محصورًا في دور الحفظ والحوزات فقط، أما في الجامعات، وحتى المتخصصة بالدراسات الإسلامية، فتجد القرآن فيها يُدرَّس كظاهرة، لا كمصدر للهداية والمعرفة.
وهذا، مع بالغ الأسف، يعود إلى كوننا نؤمن بقداسة القرآن، لكننا لا نؤمن بفاعليته، في حين أن القرآن جاء ليرسم للإنسان الحياة القويمة من كل الجوانب، ويكمله روحيًا، ومعنويًا، وعلميًا، وأخلاقيًا، وثقافيًا، واجتماعيًا… إلخ.
وفي هذا المقال، نسلّط الضوء على أبرز الأسباب التي أدّت إلى استبعاد القرآن من الجامعات والمؤسسات البحثية، وتداعيات ذلك:
الأسباب:
أولًا / المرجعية الليبرالية الغربية
من أبرز الأسباب التي ساهمت في إقصاء القرآن الكريم عن الجامعات والمؤسسات البحثية هو وجود مرجعية ليبرالية غربية تستند إليها هذه الجامعات ودور البحث العلمي، مما أدّى بها إلى الاستغناء عن مرجعية القرآن الكريم، وتبنّي نماذج تعليمية غربية تركز على الفكر والعلم المادي، بعيدًا عن الأفكار والأخلاقيات التي يستند إليها الدين الإسلامي.
فبالرغم من تنزّه مرجعية القرآن عن الخطأ، إلا أن الجامعات تفضّل الاعتماد على المرجعية الغربية الليبرالية، التي يتوارد فيها الخطأ بسهولة، متغافلين عن أن الجامعات الغربية تأتي بعقلية علمانية تعمل على تقليص المفاهيم الإنسانية الحقيقية، وتكتفي بالجانب العلمي والتجريبي فقط.
كما أنها تسعى إلى فصل الدين عن شؤون الحياة العامة. ولهذا السبب، لا نجد أثرًا للنصوص الدينية في الجامعات الغربية، وهذا ما أصبحنا نلاحظه، مع بالغ الأسف، في جامعاتنا.
فبدلًا من اعتبار القرآن مصدرًا رئيسيًا للمعرفة الإنسانية، وعاملًا أساسيًا في صناعة الشخصية السوية والمتوازنة من الجوانب الروحية، والأخلاقية، والتربوية، والعلمية، أصبحنا نتعامل معه كمجرد كتاب ديني، منفصل تمامًا عن سائر المعارف.
ثانيًا / تقديس القرآن دون التفاعل مع محتواه
إن جهل المجتمع، وبالأخص الشريحة الأكاديمية، بتاريخ القرآن، وبعمق هذا الكتاب، وما يحويه من معارف مختلفة، سواء في الجانب السياسي أو العسكري أو الاقتصادي أو النفسي وغيرها، هو الذي أدى إلى استبعاده من الجامعات. فالقرآن ذكر كل الأسس التي تستند إليها المعرفة الإنسانية بكافة مجالاتها.
إن هذا الجهل بالقدرة التفسيرية والتحليلية العميقة التي يقدمها القرآن، هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى تهميشه في الجامعات والمراكز البحثية.
لذا، الحل هو عودة الأكاديميين إلى القرآن الكريم، من خلال التدبّر في الآيات، ودراسة الجوانب المختلفة التي يتطرق إليها، وبالأخص التربوية والنفسية منها، واستيعاب فكرة أن ركيزة التعليم في النظام الإسلامي لا تستند إلى الذكاء، بل تستند إلى الرشد؛ لأن الذكاء هو القدرات العقلية الواسعة، أما الرشد فهو حسن التصرف بهذه القدرات.
فما فائدة القدرات العقلية إذا كان الإنسان لا يُحسن التصرف بها؟ وهذا عكس الفكر الغربي، الذي يرتكز نظامه التعليمي على الذكاء فقط، ولا يعترف بالرشد. فمثلًا، مخترع الأسلحة المحرّمة، ألم يكن ذكيًا؟ قطعًا كان ذكيًا، لأنه امتلك القدرات العقلية، ولكنه لم يُحسن التصرف بها، فكان سببًا في موت ملايين الأبرياء.
لهذا السبب نقول: إن المرجعية الغربية تعتمد على المعارف المادية فقط، ولا تبالي بالجوانب الأخلاقية والتربوية التي يركّز عليها القرآن الكريم، ويقوم عليها، ليضمن للبشرية حياة سليمة.
التداعيات:
أولًا / الانحدار نحو الماديات وفقدان المصحّح الذاتي
عندما يصل الإنسان إلى المرحلة الجامعية، يكون مستعدًا لاستلام المعارف والمفاهيم الحقة، إلا أنه يواجه حينها أفكارًا ومعارف ليبرالية مادية بحتة، فتنصقل شخصيته وفقًا لها، ويخرج إلى المجتمع إنسانًا خاليًا من المعنويات والأخلاقيات التي كان يجب أن يُؤسَّس عليها.
وحينها، لا تستغرب إذا شاهدته يقابل فكرة الزواج بصورة مادية، ويتعامل مع العائلة من منظور مادي، ويفقد في العمل كل الأخلاقيات، ويتمسك فقط بالصورة المادية التي زرعتها في داخله الدراسة الأكاديمية المعتمدة على المرجعية الليبرالية.
لذا، من الطبيعي أن نشاهد صورًا كثيرة خاطئة في الغرب، لأنهم يفتقدون إلى مرجعية قطعية سليمة، ومثال على ذلك هو الانحراف الواضح الذي نشاهده اليوم في الغرب بما يتعلق بالحريات. ولكن، هل يستطيع الغرب أن يصحح تشخيصه من حرية الشذوذ مثلًا؟ كلا، لأنه لا يمتلك مرجعية منزهة عن الخطأ يعود إليها.
أما نحن، فنمتلك هذه المرجعية المتمثّلة بالقرآن الكريم، وفي حال تعرضنا إلى أي مطب فكري، نستطيع أن نعود إلى القرآن، ونصحح ذلك وفقًا للنصوص القطعية، التي تكون بمثابة مصحّح ذاتي لنا.
ثانيًا / الانهيار الحضاري وفقدان هوية الأمة
إن إقصاء القرآن الكريم من مؤسسات التعليم يعزّز من فقدان الهوية الثقافية لدى الأجيال الجديدة، إذ يصبح الطلاب أكثر تعرّضًا لفكر الغرب وقيمه، ما يؤدي إلى ضعف الارتباط بالجذور الدينية والثقافية للأمة.
كما أن عدم الاهتمام بالمفاهيم القرآنية داخل الحرم الجامعي يساهم في فقدان الأصالة الثقافية، والإيمان العميق بدور الإسلام في حياتنا المعاصرة.
وإذا استمر هذا التجاهل للقرآن كمصدر أكاديمي رئيسي، فإن ذلك يؤدي إلى فقدان الأمة الإسلامية لمرجعيتها الحضارية الحقيقية، وبالتالي غياب القدرة على إحداث تطوّر حضاري متوازن، يجمع بين العلوم الحديثة وقيم الإسلام.
وقد نجد أنفسنا أمام تحديات كبيرة في كيفية التعامل مع قضايا العالم المعاصر دون مرجعية راسخة.
ثالثًا / سهولة التلاعب الفكري واحتلال العقول
الإنسان الذي يتلقّى أفكاره من مرجعية غير صائبة، من الطبيعي أن يتعرّض للاختراق بسهولة، وأن يتم التلاعب بأفكاره وإعادة فرمته، وفقًا لما يتناسب مع المصالح الغربية.
وهذا التلاعب يكون سهلًا بهذا الشكل، لأننا لا نمتلك الوعي القرآني الذي يكون بمثابة السدّ المنيع الذي يحمينا من الاختراقات الفكرية.
فعندما تكون المرجعية ثابتة ورصينة، ومنزهة تمامًا عن الأخطاء، سيكون من السهل جدًا أن نُشخّص الحق من الباطل. وحينها، يكون من الصعب جدًا أن يتم التلاعب بأفكارنا، لأننا نمتلك ثوابت فكرية مصدرها النصوص القطعية في القرآن الكريم.
فإذا حاول المتلاعب أن يُدخِل إلى المجتمع فكرة "النوع الاجتماعي"، سيتلقّى ردعًا قويًا من الشخص الذي يتبع المرجعية القرآنية، لأن هذا الشخص يمتلك نصًا قطعيًا يقول إن الجنس إمّا ذكر أو أنثى، ولا ثالث لهما أبدًا.
أما الشخص الذي يتبع المرجعية الغربية الليبرالية، فمن الطبيعي أن يتقبّل الجندر والشذوذ وغيرها من الأفكار المنحرفة، لأن مرجعيته لا تعتمد على ضابطة إلهية سليمة، وأفكارها تتغير وتتحوّر بين لحظة وأخرى، وفقًا لما تراه مناسبًا لمصالحها أكثر.
إن تجاهل القرآن الكريم في الجامعات والمؤسسات البحثية، ليس مجرد خطأ أكاديمي، بل هو تهديد لفهم عميق وشامل للحياة، وعائق أمام تحقيق التقدّم والتطور على أسس دينية وعلمية متكاملة.
القرآن الكريم هو مرجع حضاري ضخم، يجب أن يُدرَس كمصدر معرفي وأخلاقي في جميع المجالات.
ومن واجب المؤسسات الأكاديمية العودة إلى القرآن كمرجعية أساسية، وجعله جزءًا من المنهج العلمي، ليس فقط كنص ديني، بل كدليل في تفسير وتوجيه الحياة البشرية بكل جوانبها.
لا يمكننا تجاهل هذا المصدر العظيم دون أن ندفع ثمنًا باهظًا على مستوى الهوية، والإنسانية، والتربية، والتقدّم الحضاري.












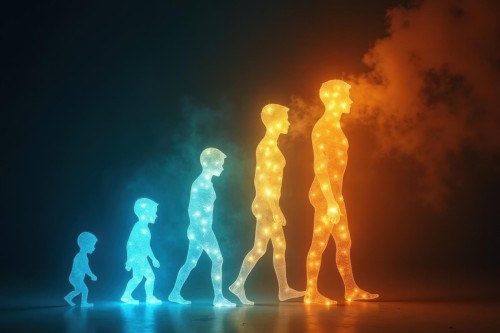



اضافةتعليق
التعليقات