لحظات الفزع كانت تتوزع على الأطفال بشكل متساوٍ دونما انحياز، انطلقت تلك العجلة ومعها قدمين أنهكهما التعب بشكل لا يوصف جراء حركتهن المستمرة دون كلل أو ملل، تنقل الصغار من أحضان العمران إلى سراديب الريف العتيقة لتختبئ بين أكفها من فزع النيران، تختطف الأيدي يد صغاره وتتسابق مع عقارب الساعة وأصوات الرصاص التي يتعالى منها دخان الموت على هيئة أشباح تكسو أراضي العراق دون مبالات إلى أي أرض تنتمي أو أي صدر طفلٍ ستقبل. إن الحرب لا ترحم وتترك وساما على كل شخص قد هام في أراضيها بحثاً عن الكرامة أو جبراً بأمر الساسة، ثم تتساقط الحروف مغبرة ومبعثرة وتحتضن زمن الشدة، وتأخذها رياح الفقر فتتقافز على أوتاد أغنياتها دون تعب وتندرج الكلمات بكل سلاسة فما من صعوبة تقف في طريق الفقر حينما يصف حال نفسه، بينما لو انتقدت سياسيا غير عادلا ستنتقده بنبرة حقيقية دون الحاجة للعودة إلى محركات البحث للقراءة في ماضيه وهو يعاصرك ويشاطرك ذات الوطن لكنه لا يرقد على نفس الوسادة، فوسادته ريش نعام خيوطها معلقة في المطارات ومرتبطة بدول أخرى تحرك المسارح لدينا.
فالكوارث بوصف قلم وطني هي الكوارث بعينها دون تزويق والنواح هو النواح الحقيقي فتجد حتى في أبسط الناس شعرا تتغنى به البلدان بينما هو يرويه ألماً، وانطلاقا من مفهوم موريس بلانشو أن الكتابة حرفة مهولة، محفوفة بالألم، فهي تنتجه وتتعلق بالموت تعلقاً كبيرا، الذي يتجلى فيها بشكل حاد وطارئ، فالكاتب يحلم دوما بالحصول على موطئ قدم وأن لا يتوقف أبداً في حياته من أجل سعيه إلى التهرب من هذا المنفى الاغترابي وقلق الحياة عبر مواصلة إبداعية لا تتوقف، فهو لا يكل ولا يمل في البحث والتنقيب في عالمنا هذا.
ثم نعود لمسألة الأوطان، لأنها في رأيي الشخصي من يهب الإبداع أولاً وأخيرا، وكل من يكتب أو يرسم أو يصنع شريطا سينمائيا عن الوطن سيغدو حقيقيا وصادقا، ففي زمن الرخاء والاستقرار ستغدو الكتابة فراشات تطير في حقول خضراء تستمد القوة من ابتسامة الناس على الطرقات بمفردات الحياة المسترخية، والليل يرتدي فيها ثياب العشاق بينما النهار يكون بمعنى الضوء بلا زيادة ولا نقصان.
ورغم أنه في كثير من الأحيان، خاصة في بلادنا العربية تبدو الأوطان جافية بالنسبة لمبدعيها، والأحضان ضيقة، والنزيف الكتابي بلا ثمن ولا احتفاء، لكن ذلك لا يوقف الإبداع في أي مرحلة من مراحله، ولا يكون الوطن لا وطنا، حتى بالنسبة للذين هاجروا أو اغتربوا عن بلادهم، أجدهم يدونون الشوق رغم الترافة لديهم ويحنون لتراب الوطن الذي غطى أجسادهم بنكرانه وقمعه لهم ولكنها رابطة غريبة تجمع بين الطين والدم فهو حنين المرء إلى تربته التي كان انباته فيها، فحين يرسمون الذكريات، ويكتبون قصيدة أو نصا روائيا يكتبونه من إيحاء زمن عاشوه في بلادهم، أو متغيرات سمعوا بها، وأجادوا الاحتفاظ بها في الذاكرة، خلافا للمتغيرات اليومية التي تحيط بحياتهم الجديدة في المهجر
وخير مثال لذلك المتنبي حين قال:
فاطلب العزّ في لظى، ودع الذلّ
ولو كان في جنان الخلود
حتى أنه سافر من وطن إلى آخر دون أي حنين لأن هذه الأوطان لم تحقق له ما يصبو إليه:
غنيّ عن الأوطان لا يستفزني
إلى بلد سافرتُ عنه إياب
ويكتب بلغة وطنه ولم يخرج في نصوصه عنه قط، وكذلك تعيش أعمالهم الإبداعية في وسط الطرق الوعرة لبلدانهم، وحين نقرأ نصا للألماني السوري رفيق شامي نقرأ نصا سوريا خالصا، تتسكع فيه الشخصيات في الشام بكل خصوصياته، ويقول د.يحيى الشامي أستاذ الدراسات العليا في الجامعة اللبنانية في مقدمة الكتاب (لطالما شكلت الهجرة، بصورة مؤقتة غير دائمة، حافزاً لقدح زناد الفكر، وكشف القناع عن ملكة الإبداع، فكيف إذا كان المهاجر من ذوي الفطنة والفهم والذكاء، ومن الذين لهم بالفطرة علوق بالأدب أو الشعر، الذي هو ترجمان مختلف المشاعر والأحاسيس الكامنة في النفس كمون الشرر في النار).
الذين حملوا أوطانهم في قلوبهم، وقد أكهلتهم الغربة، وضجت بهم السنون، فأطلوا من علٍ، صياحين على بيادر الوجد، عرفتهم شعراء وكتابا مندفعين في الهم الثقافي والإبداع، ويتمتعون بواقع يقترب من لغة الحنين، بل يذوب فيها، فما ورثوه من أوطانهم لغة وحدث جعلت في قلوب المبدعين شعلة من نار تفوق كل قرين لم يمتلك أداة الحنين ولا شجاعة الموت على شفاه الأنين، جعلت منهم هذه المَلكة ليسوا مجرد موهوبين إنما رسمت لهم أبواب المقدمة وجعلت منهم أنموذجاً يحمس للكتابة والمواصلة المستمرة من أجل تأثير الأدب في الفكر الإنساني، وكذلك تأثير في فكر القراء، وبعد كل مرة حين نعود لنستنشق عبق العراق في طيات الأوراق وتناثر الأقلام نجد أنه الأوفر حظا والأكثر مكانة ففيه كبر العلماء ومنه نبع الشعراء، فقها وعلما ومعرفة وكانت لسود أيامه إبداعا يولد كل ليلة على يد مدون ارتضى من الزاوية جليسا له فكون صورة ابداعية عُلقت في أذهان العالم أجمع.



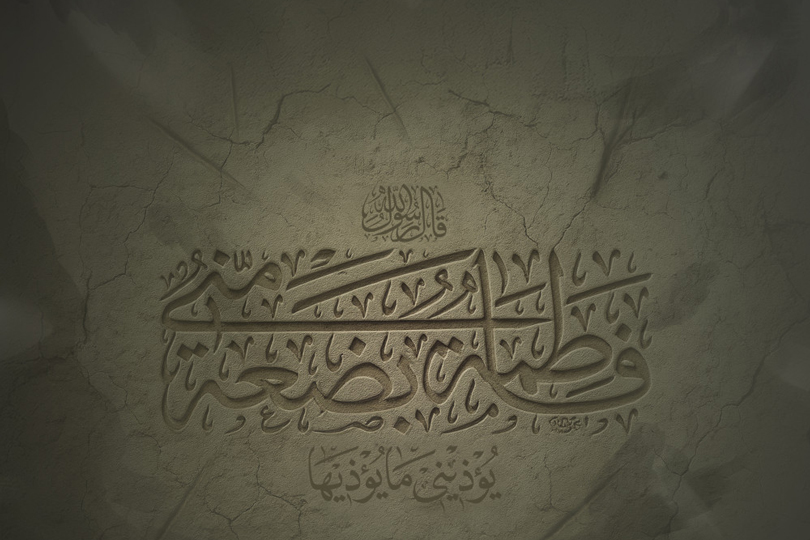












اضافةتعليق
التعليقات