يُعدّ التحدّث مهارة إنتاجية شفوية تُدرّب الطلاب على الطلاقة؛ إذ تتحدد هذه المهارة بقدرة الطالب على التعبير عن نفسه بسرعة ودقة دون عوائق أو تردّد، وهو القدرة على استخدام الرموز اللفظية للتعبير عن أفكار الفرد ومشاعره بفاعلية، وبطريقة لا تُضعف الاتصال ولا تستدعي انتباهًا مفرطًا من المتحدث أو المستمع.
فالحديث مزيج من العناصر التالية: التفكير بوصفه عمليات عقلية، واللغة بوصفها صياغة للأفكار والمشاعر في كلمات، والصوت بصفته حاملًا للأفكار والكلمات عبر أصوات ملفوظة للآخرين، والأداء بما يشمله من هيئة جسمية واستجابة واستماع. ومن ثمّ؛ فالحديث هو فنّ نقل الاعتقادات والعواطف والاتجاهات والمعاني والأفكار والأحداث من المتحدث إلى الآخرين.
ويُعرَّف التحدّث أيضًا بأنه تكرار الطلاب مجموعة من الجُمَل المسموعة داخل قاعة الدرس، أو المسموعة في حوار ما. ويمكن ممارسة هذه المهارة في مجالات عديدة، منها: تحدّث الطلاب عن حياتهم الخاصة، التحدّث عن الأخبار التي سمعوها، التعبير عن أفكارهم، مناقشة القضايا فيما بينهم.
كما عُرِّف التحدّث بأنه مهارة إبداعية إنتاجية تعتمد على إخراج الأصوات اللغوية وفهمها، ويرتبط بذلك عدد من العمليات الفسيولوجية كالتنفّس واهتزاز أو سكون الثنايا الصوتية الموجودة في الحنجرة. وتعتمد هذه المهارة أيضًا على حركة اللسان الذي يشكّل مع الأسنان والشفاه وسقف الحلق الصوت في صورته النهائية. فالنطق يعني القدرة على إصدار الأصوات، ويُعدّ التحدث فنًا لغويًا يتضمن أربعة عناصر أساسية:
الصوت: فلا حديث دون صوت، وإلا تحولت عملية الاتصال إلى إشارات وحركات، وهو ما لا يتفق مع المواقف الطبيعية للتخاطب.
اللغة: إذ يحمل الصوت حروفًا وكلمات وجُمَلًا ذات مدلولات، لا مجرد أصوات بلا معنى.
التفكير: فلا معنى للكلام من دون تفكيرٍ يسبقه ويكون مصاحبًا له.
الأداء: وهو الكيفية التي يتم بها الكلام من تمثيل للمعنى وحركات للرأس واليدين تعزّز التأثير والإقناع.
ومن خلال العرض السابق لمفهوم التحدّث، يتضح أنه عملية فسيولوجية وعقلية تتضمن نقل المعتقدات والمشاعر والأحاسيس والخبرات والمعلومات والمعارف والآراء من المتحدث إلى المستمعين، على نحوٍ يحقق القبول والفهم والتفاعل والاستجابة، مع طلاقة في النطق وصحة في التعبير وسلامة في الأداء.
وهو أيضًا عملية عقلية إدراكية تتضمن دافعًا واستثارة نفسية لدى المتحدث، ثم مضمونًا أو فكرة يعبر عنها، ثم نظامًا لغويًا ناقلًا لهذه الفكرة. كما أن التحدّث عملية معقدة تتضمن عمليتين هما:
أولًا: العملية الفسيولوجية
وتتمثل في استغلال هواء الزفير الخارج من الرئتين، حيث يعترض هذا الهواء أثناء صعوده المجاري الهوائية، ويُحدث اهتزازًا في الوترين الصوتيين داخل الحنجرة، المسماة الجهاز الاهتزازي. ثم تتشكل الأصوات في الفم بتأثير من اللسان والشفتين والأسنان.
ثانيًا: العملية العقلية
وتتمثل في عملية التفكير التي يمارسها المتحدث قبل الكلام وأثناءه وبعده، مع استدعاء المفردات اللغوية المخزنة والخبرات السابقة، وتنظيم الأفكار ترتيبًا منطقيًا. ويأتي قبل ذلك الدافع النفسي الذي يحفّز الفرد على الحديث، وقد يكون داخليًا كالمشاعر والانفعالات، أو خارجيًا كاستفسار، أو طلب معلومة، أو رغبة في التواصل.
ثالثًا: خصائص فن التحدّث
استنادًا إلى التعريفات السابقة، يمكن تحديد أهم خصائص هذه المهارة:
أنه عملية تفكير تتطلب من المتكلم وجود فكرة واضحة يود إيصالها، ثم ترتيبها وعرضها بطريقة مؤثرة.
أنه عملية بنائية تفاعلية يجري خلالها بناء المعنى ثم صبّه في قوالب لغوية وصوتية، ويتلقى المستمع هذه العناصر ليعيد بناء المعنى بطريقة معكوسة.
أنه عملية نفسية تقوم على دافع داخلي أو خارجي يدفع المتحدث للكلام.
أنه عملية لغوية تعتمد على استخدام قوالب لغوية سليمة المعنى والمبنى.
أنه عملية صوتية إذ يُعدّ الصوت المظهر الخارجي للغة المنطوقة، وهو سابق تاريخيًا للكتابة.
أنه فن له مؤشرات سلوكية قابلة للقياس، منها:
النظر إلى أعين الآخرين أثناء الحديث.
وضوح النطق.
صحة نطق الأصوات المتقاربة.
الحديث دون تردد أو خوف.
تنويع نبرات الصوت.
استخدام الإيماءات الداعمة للمعنى.
ترتيب الحديث منطقيًا.
استخدام الصيغ العربية المختلفة استخدامًا صحيحًا.
الاستشهاد بالأدلة والشواهد.
حسن استخدام الإشارات الجسمية.
مراعاة خلفية المستمعين.
حسن الانتقال بين الأفكار.
الحديث في وحدات فكرية كاملة.
توظيف القواعد النحوية توظيفًا سليمًا.




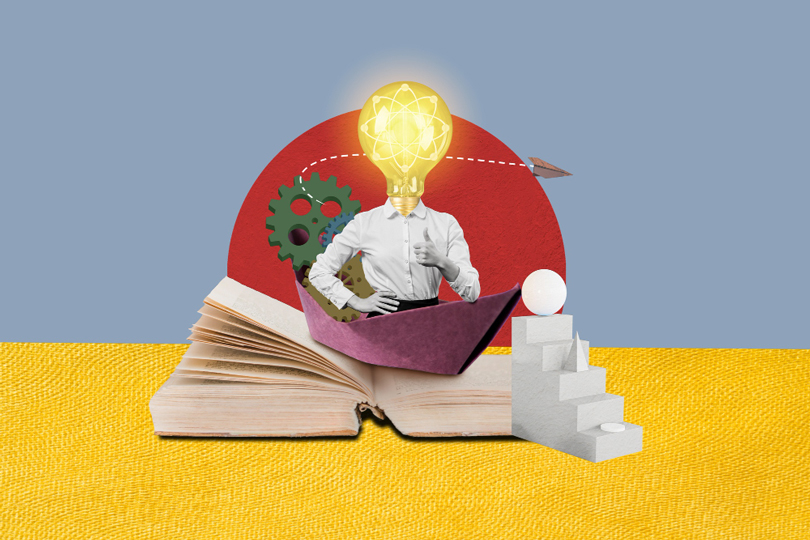









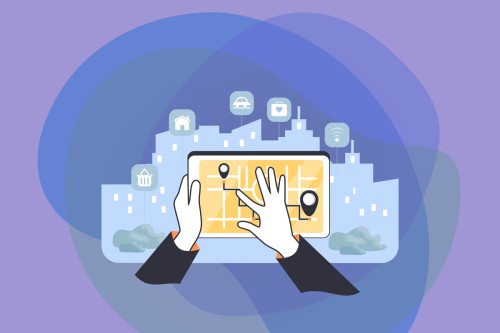

اضافةتعليق
التعليقات