التحدث هو المهارة الثانية من المهارات اللغوية التي يكتسبها الأطفال بعد عملية الاستماع للغة ومحاكاتها من خلال الوسط الاجتماعي الذي يعيشون فيه. وهذه المهارة هي المظهر الحقيقي لتحقيق تواصل جيد بين الفرد وأفراد الجماعة اللغوية التي ينتمي إليها، كما أنها إحدى العناصر المهمة في عملية اكتساب السلوك الاجتماعي، لا من خلال قدرة الفرد على نقل المعلومات والأفكار والخبرات إلى الآخرين فحسب، بل من خلال تكوين المفاهيم التي يُطالَب الطفل بالتعرّف عليها كمعانٍ للوحدات اللغوية المختلفة التي يتعلمها عن طريق اتصاله بالآخرين، ومن خلال محاكاته أنماط الأداء اللغوي الشفوي التي يقلدهم فيها.
فالتحدث هو المظهر الحقيقي للغة؛ فإذا كانت اللغة أصواتًا يُعبّر بها كل قوم عن أغراضهم، فإن الكلام هو الإطار العام الذي يُوظّف هذه الأصوات في إنتاج كلمات وجمل ذات معنى. كما أن المتحدث يلتزم بمجموعة من القواعد والضوابط التي تحدد استعمال الأصول والصيغ والتراكيب وأساليب التعبير النحوية والدلالية والسياقية أو الحالية عند عملية التحدث.
ولعلّ وظيفة مهارة التحدث تبدو في أنها المهارة التي يمارسها الفرد في فترة مبكرة من حياته؛ وهي فترة لا يستطيع فيها الطفل التمكن من الإمساك بالقلم والكتابة عما يدور بخلده أو تفكيره، كما أنه لم يصل بعد إلى درجة النضج الجسمي والعقلي التي تؤهله لممارسة النشاط الكتابي ممارسة كاملة، بخلاف مهارة التحدث التي يمارسها في سنينه الأولى بدءًا بالمناغاة.
ولذا فإن الطفل يعتمد في نشاطه اللغوي قبل التحاقه بالمدرسة على فني التحدث والاستماع دون غيرهما للاتصال بالآخرين. ومن ثم تتجلى أهمية فن التحدث في تمكين الطفل من الكفاءة الاتصالية، وتتمثل هذه الكفاءة في تمكين الطفل في جانبين، هما:
أولاً: الجوانب اللغوية، وتشمل ما يلي:
علم الأصوات وعلم الإملاء: حيث إن التحدث يُعين الطفل على اكتساب أصوات اللغة من الجماعة التي ينتمي إليها، كما أنه يتعوّد على طريقة التحدث وفق النظام العرفي الذي تواضعت عليه الجماعة اللغوية، أو ما يسمى باللهجة، علاوة على ربطه بين الصور الصوتية للحروف والكلمات وبين صورها الإملائية، ورسم هذه الصور في الذاكرة السمعية والبصرية في المخ لحين استدعائها. ويتضمن علم الأصوات ما يلي:
تعرف الأصوات المسموعة والتمييز بينها.
إنتاج الأصوات المميزة للغة ما، وتتمثل في إنتاج الحروف الساكنة وحروف العلة.
التنغيم المناسب للموقف، وإيقاع التحدث من حيث سرعة الكلام أو بطئه، أو ما يسمى بالإيقاع.
النحو: يكتسب الطفل النظام القاعدي للغته الشفوية من خلال اكتسابه بشكل فطري آليات تركيب الجمل والعبارات التي يتحدث بها، وكذلك دلالة هذه التراكيب على المعنى الذي يريد إبلاغه إلى الآخرين، فضلًا عن استخدام بعض الصيغ التطريزية للغة المتحدثة في تحديد المعنى المراد من خلال النبر والتنغيم، وكيفية اشتقاق الكلمات اشتقاقًا صحيحًا في ضوء القواعد الحاكمة للغة.
المفردات: يبدأ الطفل منذ بداية تعلمه للغة في اكتساب العديد من المفردات اللغوية التي يسمعها من والديه أو من المحيطين به، وعادةً ما يُدرك الكلمات الحسية التي لها كيانات مادية محسوسة بإحدى الحواس الخمس. ويقوم المخ الإنساني بتصنيف المفردات اللغوية في حقول دلالية، لكل حقل مجاله اللغوي الذي يندرج فيه؛ فهذه مفردات خاصة بالطعام، وأخرى ترتبط بالشراب، وثالثة بوسائل المواصلات.
الخطاب (النصية): يتعلم الطفل كذلك كيفية إنتاج الكلمات والجمل والتراكيب للتعبير عن أشياء أو أفكار يريد تبليغها إلى الآخر. فالخطاب قول ذو خصائص نصية، لكنه يمثل في الآن نفسه نشاطًا يجب أن يُخصَّص انطلاقًا من بعض شروط الإنتاج الموجهة سياقيًا، فالخطاب نص موجه بسياق اجتماعي وثقافي يوجّه الطفل في اختيار عباراته وكلماته عند تواصله مع الآخرين.
ثانيًا: الجوانب الواقعية، وتشمل ما يلي:
الوظائف: وتتمثل تلك الوظائف في الغايات التي يسعى الطفل لتحقيقها من جراء عملية التواصل مع الآخرين، أو بمعنى آخر الغرض الأساسي الذي يكمن وراء عملية الاتصال: هل هو لطلب شيء، أو إعلام بأمر، أو اكتساب خبرة... إلخ.
الاختلافات: وتتمثل في قدرة الفرد على التمييز بين المعاني المختلفة بناءً على الاختلافات اللغوية الموجودة في الحديث الذي يُقال، علاوة على قدرة الفرد على تحديد المعنى العام للموضوع.
المهارات التفاعلية: تتضمن مهارات التفاعل تبادل الرسائل اللفظية وغير اللفظية بين الطرفين، وذلك من خلال استخدام اللغة المنطوقة أو من خلال استخدام العلامات الإشارية المعينة على بلوغ الرسالة، فضلًا عن استخدام أجزاء الجسم المختلفة في تدعيم هذا التواصل؛ من تركيز بصر المستمع على المتحدث، واستخدام تعبيرات الوجه وإيماءات الرأس في التعبير عن الاستحسان أو الاستهجان لما يقوله المتحدث، أو لترغيبه في مزيد من الحديث، أو للتعبير عن ضجره وتبرمه مما يُقال.
الكفاءة الثقافية: يشير هذا الإطار إلى قدرة الفرد على فهم السلوك من وجهة نظر أعضاء الجماعة وما تحمله من ثقافة مميزة لها عن بقية الجماعات الأخرى، كما أنه يُيسّر السلوك والتصرفات المختلفة بطريقة تُقرّها الجماعة الثقافية. ولذا فالكفاءة الثقافية تركز على البيئة الاجتماعية للجماعة التي ينتمي إليها الفرد ويعيش بينها، وما تحمله هذه الجماعة من قيم ومعتقدات وأنماط سلوك، وكافة أنواع الأشكال الثقافية الحاكمة لسلوك هذه الجماعة.
أولاً: مفهوم التحدث
التحدث هو عملية يتم من خلالها إنتاج الأصوات، مضافًا إلى هذا الإنتاج تعبيرات الوجه المصاحبة للصوت، والتي تسهم في عملية التفاعل مع المستمعين. وهذه العملية عملية مركبة تتضمن العديد من الأنظمة، منها النظام الصوتي والدلالي والنحوي، بقصد نقل الفكرة أو المشاعر من المتحدث إلى الآخرين.
ولذا فقد أشارت جيورجون إلى أن عملية التحدث أشبه ما تكون بلعبة التنس؛ إذ يؤكد الباحثون أنه من المفيد أن نفكر في عملية المحادثة أو التحدث والاستماع باعتبارهما نظيرين للعبة التنس؛ فالحديث في حد ذاته هو كرة التنس، والمتكلم والمستمع هما لاعبان في هذه اللعبة، فالخادم (اللغة) يضرب التحدث إلى المتلقي (المستمع) الذي يصبح عندئذ ضاربًا (اللغة) ويضرب الحديث مرة أخرى إلى الملقم (المتلقي).
هذا بالإضافة إلى النغمة التي ينطق بها المتكلم اللغة حتى تؤدي إلى فهم الكلام فهمًا صحيحًا. ولذا فعملية التحدث بين شخص بالغ وطفل صغير هي عملية مشابهة للعبة الكرة مع طفل صغير، وعلى الكبار أن يؤدوا أكثر من عمل بتشغيل جولة واسترداد الكرة (الحديث) ورمي الكرة عمليًا (الحديث في آذان لاعب أقل خبرة).
ويرى محمد صلاح الدين مجاور أن التحدث أو ما يُطلق عليه اسم التعبير الشفوي هو ذلك الكلام المنطوق الذي يُعبّر به المتكلم عمّا في نفسه من هاجسة أو خاطرة، وما يجول بخاطره من مشاعر وإحساسات، وما يزخر به عقله من رأي أو فكر، وما يريد أن يُزوّد به غيره من معلومات ونحو ذلك، في طلاقةٍ وانسياب، مع صحةٍ في التعبير وسلامةٍ في الأداء. كما أنه فنّ نقل المعارف والخبرات والمعتقدات، ليس فقط من خلال عناصر الحديث الشفوي أو اللفظي، ولكن أيضًا من خلال استخدام اللغة المصاحبة للإشارات الجسمية، وتتضمن: درجة الصوت، النبرة، التنغيم، سرعة الحديث، والتأكيد على المعنى العام للموضوع.




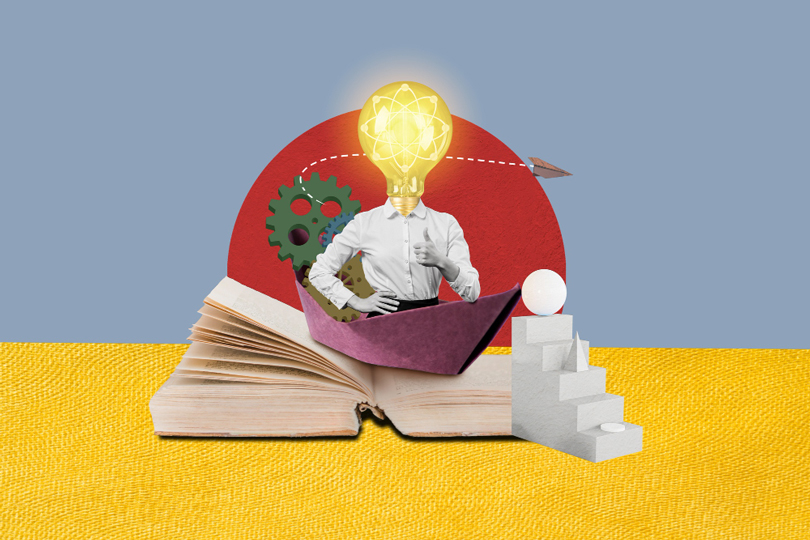











اضافةتعليق
التعليقات