في ذلك الصباح الصيفي بدت الشمس متوهجة أكثر من ذي قبل و كأنها قد دخلت في تحدٍ حام مع الطبيعة، لا تتزحزح عنه قيد أنملة، تبعث بلهيب أشعتها مكشرة مفعمة بالحيوية مليئة بالطاقة، و كأنها قررت تصدير اللهب بدل النور والشعاع، تعبث أناملها بأخاديد الخليقة الغضة النضرة حتى تكاد تسمع لهيث الزهور وهي تتلظى عطشا في الجزرة الوسطية منتصف الشارع.
عدت مسرعا من الدائرة تدغدغني نسائم الصباح جاهدة لتبريدي وهي تناغي حبات العرق المتساقطة
من جبيني دون انقطاع.
دخلت المنزل أتراقص فرحا و أنا أنادي
أمي!
أمي!
هات البشارة.
كانت أمي متوسطة الطول، مربوعة القامة، خطت أصابع الدهر في جبينها تجاعيد تكاد تخفى على الناظر منذ الوهلة الأولى.
كانت ترتدي (دشداشة) برتقالية مزينة بورد عباد الشمس فضفاضة تهبط حتى الكعبين.
شعّت عيناها ببريق الفرح و هي تصيح هات يا عامر; فلا أطيق الإنتظار!
-لقد تم تعييني في قسم الشؤون الصحية في دائرة الرقابة المالية، سأذهب لفترة إلى العاصمة; لا بد من دورة تمهيدية قد تستمر بضعة شهور.
امتزجت زغاريد الفرح بأجواء البهجة و السرور معانقة الروائح الشهية العطرة المنبثقة من الدهليز المؤدي إلى المطبخ.
وصلت في اليوم التالي قرب الظهيرة. كانت بغداد كسابق عهدها جميلة مليحة تروي للأحفاد قصص حضارات امتدت آلاف السنين خلفت بصمة دانت لها أمم الدنيا برحابة و تواضع.
راحت تولول في رأسي كلمات نزار قباني :
بغداد عشت الحسن في ألوانه
لكن حسنك لم يكن بحسابي
ماذا سأكتب عنك في كتب الهوى
فهواك لا يكفيه ألف كتاب
حللت ضيفا على خالتي الحبيبة.
كانت تفوح من جدران بيتها جل روائح الكرم و السخاء المذكورة في التاريخ، وتهدهد في حضنها كل روايات الحب و الحنان.
عالجت بشتى الطرق و الأساليب لتمنعني من استئجار مكان أقضي فيه فترة تدريبي، فقد كانت تملك مشتملا في فناء دارها، صغيرا يكاد يخلو من أثاث إلا سرير حديدي أكل الزنجار جانبه الأيسر، تتصدره ملحفة بيضاء فائقة النظافة بورود و أقحوانات أرجوانية طبعت بحرفية جرافيكية، تتدلى من طرفي السرير ملامسة الأرض أو تكاد، و لا تزين جدرانه سوى ساعة دائرية الشكل بيضاء واضحة الأرقام.
خالتي إنتصار موظفة في وزارة التربية و زوجها عبد المعطي أستاذ جامعي أحترمه للباقته و قدرته البليغة في إيصال الفكرة و المنهج بخفة و سلاسة لطيفة.
كانا يخرجان صباحا و لا يعودان حتى انتهاء الدوام قرب المساء ، ترجع قبلهما بساعة تقريبا ابنتهما سارة.
كانت في السابعة عشر من عمرها، مرحة بشوشة قلما أراها تجلس من دون أن تتلهى بفكرة كل ساعة ما بين دراسة أو ممارسة هوايتها في تغيير الديكورات و ترتيب المنزل حتى بدا كل غرض في مكانه و كأنه لم يتزحزح لدهر.
كنت أقضي وقتي بالدوام منذ الصباح حتى المساء بجدية ومثابرة تضرب بها الأمثال، ولم أفوت في تلك الفترة أي مقترح لعمل إضافي و ما شابه.
أما المساء كنت أقضيه برفقة بعض الصحبة و لا أرجع للمنزل إلا بعد أذان المغرب أستعد فيه للصلاة و العشاء و النوم مبكرا إستعدادا للعمل منذ الفجر في اليوم التالي.
تراكضت الأيام مسرعة و أنا متلهف لقضاء هذه الفترة فقد اشتقت لمدينتي و رفقة أصحابي و شذى رائحة الخبز المتصاعد من فرن أبي أمجد خبازنا الماهر في حي النقيب، و الأهم من ذلك، اشتقت للغوص في عيني أمي الحنون مرسى كل النهايات السعيدة في حكايات العالم.
رجعت في ذلك اليوم المشؤوم إلى البيت لأخذ كتاب نسيته كان لابد من تسليمه إلى الهيئة الرئاسية في الدائرة قبل انتهاء الدوام.
دخلت حجرتي و غيرت ملابسي بأخرى لائقة أكثر لإجراء المقابلة.
توجهت لمنزل خالتي، كان الباب نصف مفتوح هممت بطرقه تسبقه نداءاتي
سارة!
سارة!
أين أنت؟!
هات أوراقي الرسمية التي سلمتها لخالتي قبل أسبوع.
وقع نظري على الساعة من فتحة الشباك عبر زجاجه البلوري اللامع، كانت تقرب الواحدة ظهرا. بات ينفذ صبري، رحت أصرخ متعاليا ما بك سارة؟
هيا أنا في عجلة لا بد أن أصل قبل نصف ساعة ستتأخر المعاملة للأسبوع القادم عندها ستلقون بي في الشارع.
جاء صوتها خافتا، هادئا ، إنتظر لحظة أنا أستحم.
بدأ العرق يسيل من أم رأسي حتى أخمص قدمي، فاتجهت نحو غرفتي حيث الهواء الصناعي النقي الذي عولج بأصابع التكنلوجيا الحديثة المنبعث من المكيف.
كدت أصل الغرفة و إذا بصرخة سارة تنتشلني من بين ركام الأفكار ، قفزت على أثرها و لم أعرف كيف قطعت المسافة لغرفتها خلال ثوان، وجدتها ملقاة على الأرض دون حراك، نصف عارية لا تستر المنشفة سوى جزء من بدنها!!
أول ما خطر في بالي قبل أن أفكر ما الذي حدث لها و هل هي حية أم ميتة، لو رآني والداها في هذه الحالة ما الذي سيخطر في بالهم؟؟!!
سحبت شرشفا كان فوق سريرها و غطيتها به و رحت أقيس نبضها و أتفحص حرارتها التي بدت طبيعية مئة بالمئة،
أحاطت بي نوع من الطمأنينة فتحت لي المجال لأفكر ماذا يجب أن
أفعل؟ هل أتصل بخالتي أم بالطوارئ أم أترك المكان و أهرب مسرعا قبل أن تحدث كارثة؟!
كنت أتفادى النظر إليها بكل ما أوتيت من قوة؛
و إذا بها تفتح عيناها على حين فجأة و قد قفزت من خلفها فتاتان كانتا تختبئان خلف الستار و بيدهما هاتف جوال!
تطايرت شرارات الغضب من عيني فوقفت مستغربا مدهوشا تدفعني الحيرة إلى وادٍ سحيق!
راحت تبكي بغزارة و تعتذر بإصرار، تبين أنها دخلت في رهان مع صديقتيها على عفتي و خلوص نيتي، كنّ قد اتفقن على توثيق الأمر و تصويره بالجوال.
يا للمأساة ماذا كان سيحدث لو سارت الأمور بغير اتجاه؟!
كنت سأفقد كل شئ ثمين في حياتي فقد كانت سارة غادة جميلة هيفاء لا تنقصها امتيازات النساء.
ما الذي اختطفني كالشهاب من تلك الدوامة المتلاطمة؟!
قد يكون للبن الطاهر و الموالي
الذي غذتنيه أحضان العفة الزينبية هذا التسامي البليغ.
يحتاج المرء أحيانا إلى دافع واسع و رحب بوسع المجرات ليكون مصداقا ناجحا لاجتياز المطبات المهولة التي يركمها الشيطان في طريقه بحبكاته المدروسة منذ القدم.
كم بليغة السيمفونية الراقية التي غنتها العصور عبر الأجيال لترقى بالبشر جميعا نحو الإنسانية السامية، إنها كلمات مولى الموحدين، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: {الشجاعة صبر ساعة}.










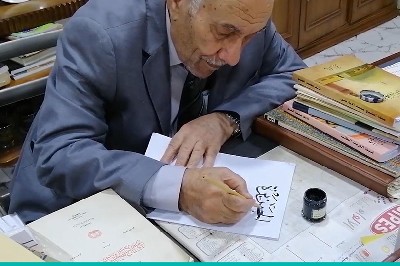


اضافةتعليق
التعليقات