أطل وجه أم (غايب) في غمرة الأجواء... حاملة الأقمشة السوداء، كدأبها في كل سنة عندما تفتح باب منزلها لاستقبال وضيافة زوار الأربعين، شأنها شأن ربات البيوتات الكربلائية في مركز المدينة القديمة... القريبة من الأضرحة المقدسة، وكعادتنا أنا وصديقاتي نجتمع عندها لتقديم الخدمة، إذ لا تقوى بمفردها على ذلك، وأعداد الزوار كبيرة جداً.
ضوضاء بيضاء هادئة لا يكدر صفوها سوى صوت التلفاز، هذا الجهاز البغيض ما زال يخربش بعنف عمق إنسانيتنا بأخبار الطواغيت والشعوب... الانفجارات... الحرائق والطوفانات... البراكين والسيول... تتلاطم فيه الصور والأصوات وتستفز مكامن الحزن اللامتناهي والخوف القابع تحت وهاد الأمن الكاذب.
طوت (أم مازن) مقدمات التعارف بعد زمن قصير من دخولها، امرأة بسنيها المنهكة وسط فتيات في مقتبل أعمارهن حفز شهيتها النائمة لسرد قصص الماضي القريب، وحثنا انبجاس اللطف في صوتها الخفيض على الاستماع، وهي تحكم وضع النظارة الطبية على عينيها قائلة:
- بُنياتي، كل استفهاماتكن المتحمسة الدفينة شعرت بها وأنتن تتناوبن على تقديم الطعام لي ثم الفاكهة، ما بال العجوز وما سر لثامها؟ لماذا لا تأكل ما نقدمه لها؟ ربما لو كنتن مكاني لفعلتن مثلي وأكثر، إنها قصة عين... وأذن... وأسنان.
- أين جهاز التحكم؟ لنطفئ التلفاز!.
سألتُ بعد دقيقة من السكوت الموشى بالترقب.
أطلقت المرأة حسرة عظيمة من صدرها أحسست لوهلة أنها ارتطمت بقلوبنا كحادث سير عنيف، حطمتها، وقفت تتفرج على أطلالها المتبعثرة دون اكتراث، ثم عادت لصدرها ثانية لتستقر كجبار عتيد، قبل أن تستأنف الكلام وهي تقول:
- 2005 هذه السنة المشؤومة، لحظة... لماذا هي مشؤومة؟ هي كسائر السنين عبوسة، شوهاء، دميمة، خرجت أودع فيها ابني الدكتور مازن قبل سفره للأردن، حصنته بالقرآن الكريم، رششت طاسا من الماء خلف سيارته، لكن عين وأصابته، عين لم تصل على النبي وآله، أعرفها هي عين جارتي أم سعيد، رمقته بنظرة حارقة غادرة وهو يضع حقائب السفر في السيارة، كيف لا وابني الطبيب نابغة، وزوجته الدكتورة فلقة قمر، وابنهما جمع الصفتين ولما يتجاوز عمره السنتين.
بكت بعدها بكاء مرا كمرارة خيبتها، ناولتها إحدانا علبة المناديل، أكملت حديثها وهي تمسح عينيها الهتون الدافقة كشريان مقطوع:
ذهب مع زملائه لحضور مؤتمر يضم نوابغ الطب في العاصمة عمّان، في فندق (راديسون ساس) بالتحديد، كنت أتصل به يوميا للاطمئنان عليه، فيشاكسني مثلما يفعل دائما:
- لستُ في العراق يا أمي كي تقلقي عليّ، أنا من يجب أن يقلق عليكم.
ثم يضحك ملء فمه، ويأتمنني على إيصال قبلتين واحدة لابنه وواحدة لي، والأخيرة يشدد عليها كثيراً!
اليوم الذي لم يرد فيه على الهاتف اختلجت فيه مشاعري واضطربت كأفعوانية صاعدة ونازلة ومقلوبة، لكني اضطهدتُ حاستي السادسة فأخرستها، وخدّرت حدسي الأمومي بافتراضات مسكّنة، ربما هو نائم أو مشغول أو يستحم أو ... أو............!!
قبضت بيدي المغمستين بقلة الحيلة على أمل ضنين باتصال مفاجئ يفني قلقي ويهدئ روعي، فما لبث الجهاز البغيض حتى راعني بخبر عااااجل في الشريط الأحمر، ما عساه يكون سوى أحمر.
انفجار ثلاثة فنادق في عمّان...
انتحاريون بأحزمة ناسفة والقاعدة تتبنى التفجيرات...
الضحايا من كل البلدان العربية بينهم دبلوماسيون وشخصيات كبيرة...
مقتل العشرات ونجاة العرسان...
قتلى وجرحى وما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين...
لا... لا...
حصنته... أخبرتكن إني حصنته...
انتظرت وانتظرت وبقيت أنتظر، سيرد الآن... بعد قليل... بعد كثير... أناخ الليل عليّ بكلكله دون رد...
هل تتخيلين أن تتشبث أرواحكن القلقة برنّة؟
في الصباح غير الصبوح رنّ الهاتف رنينا معربدا شرسا متواليا، قايض رغبتي ولهفتي للجواب توانيا وتراخيا، رقم أُردني، رفعت السماعة ببطيء درامي، ليس صوته.
- (البقية في حياتكم، عليكم المجيء لاستلام الجثة).
ابني الدكتور النابغة أصبح اسمه جثة!
تهويدة العمر الكليل، يا حلمي التيّاه في مفازات الألم، يا خميلة الزمن الكؤود، يا رؤى النجم البعيد، يا كوكب السَحر الآزف توا، أصبح اسمك جثة!
ضاقت بي هذي الحياة الفسيحة الشاسعة... المنكمشة... المتلاشية... اللعي..........!!
هي كذلك فقط معنا نحن المنسيون عمدا، المركونون في دهاليز الأزمان المتعاقبة في كرها، وأقبية الأزمان السالفة في فرها... يعلونا غبار الإهمال ونسيج خيوط التفريط على مرأى الساسة والحكام... نباطح الموت الشنيع، نغازل الأمل الجموح... لكن هل من محيص؟
صدقنني عندما رأيته بعد يومين كان مثلما تركته بل أوسم، وجه مشع رغم سمرته، جسد ريّان رغم صولة الموت فيه، حاولت مرارا وتكرارا إيقاظه، مازن... حبيبي مازن... طبيبي مازن، استيقظ لا تشكو من شيء، لا بتر، لا جرح، لا خدش، استيقظ وكفاك دلعا ودع عنك الكرى...
أخبرني الطبيب المتأثر لرزئي أو لرزء مهنته التي باتت بلا قيمة، أن شظية صغيرة دخلت من أذنه حتى نفذت إلى دماغه...نعم دماغه... وهل يفجر الحمقى إلا الأدمغة الذكية التي تعري وضاعتهم وخستهم؟
صرت أحركه، أشمه، أوسعه ضمّا، أنهال عليه تقبيلا عسى أن تفوق ثمالة روح فيه... تستفز بقايا نفس... تشتعل ذبالة نبض... عسى.
لكنه الموت الذي لا يقبل الرشى، إنه الموت الذي يلاحقنا، يداهمنا، يباغتنا ليفجعنا... إنه القناص الضليع مهما نأت الأهداف ومهما فرّت.
تمازج الأنين الجماعي مع طرقات خفيفة على الباب، وثبت إحدانا لفتحه، خيمة من البكاء أظلتنا، لم تستغربها الزائرات، فذا موسم الأحزان آن، والدمع عنوان الهيام... متينة فجائعنا كحبل مفتول ممتد من سالف كرب وبلاء، يُحكم على الأنقياء قبضة من بطش فراعنة العصور.
ويشج صوتٌ مسافات البعاد...
لا محيص... لا محيص...
أكملت بصوت مبحوح بعد انقطاع يسير:
ها قد عرفتن أي عين، عين أم سعيد كيف أنزلته القبر، ربما عينها أو عيون الحكومات الغافلة عن أمن شعوبها، الخائنة في غض طرفها، الساجية ساعة صفرها.
وها قد عرفتن أي أذن، أذن ابني الحبيب الذي عالج عشرات الآذان في مسيرته الطبية، لن أقول إن ذلك من سخرية القدر، هي أقدار خطت من لدن حكيم عليم وله الحمد، فلن يسمع بعد الآن ضبح الفساد في مضامير الرذيلة، وجلجلة الفاسدين في أزقة الدناءة، لن يصك أذنيه نحيب الثكالى اللواتي انضممت لقافلتهن، ولا صراخ اليتامى وقد التحق بركبهم ابنه الرضيع، ولا صوت النوائح والصوائح في العزاءات الأبدية لهذا البلد.
استعبرتْ وحوقلت ثم حمدت الله على كل حال... كلنا بكينا وبكينا رغم أننا لم نلج دنيا الأمومة المرهفة، لكننا توسلنا بالخيال الأثيري لوضع أنفسنا مكانها، وكأني بأم (غايب) توحدت مع ذاتها في عالم منفرد قصي تحدث نفسها، وتحمده أيضا على عقمها، هي التي صبرت عمرا لتناغي في مهدها الخاوي طفلا، ولم تترك طبيبة إلا وتعالجت عندها، عدم وجودهم خير من فقدهم بعد التعب والسهر والتعلق، العقم أفضل من الثكل... هذا ما توصلت إليه قناعتها في إطراقها الملّغز.
مرعب أنت أيها الموت، مرعب كخنجر في خاصرة البنفسج، كسرّ في بحر مسجّر، بل كمسخ ينهش الأحياء، أو رحى تمعن في طحن المهج، لكن البقاء بعد الأحباب أشد رعبا، أشد ألما، أشد... هي من تعرف كيف، ولماذا، ومتى، وأين هو أشد...
قوية هي أم مازن... شامخة... صلبة... حتى أماطت لثامها الأسود... أصبحت الآن ضعيفة... منكسرة... هشة حد التفتت.
رأيتُ أو سمعت أو قرأت كل مظاهر الحداد التي قد يمارسها إنسان على وجه البسيطة لأعز أحبائه في جوفها إلا هذه، لم تخطر في بالي ولا حتى تخطف. صعقنا جميعنا، تسمرنا في مكاننا كدمى خشبية مشرئبة الأنفاس، ظلت يدي ممدودة بلا حراك وهي تحمل منديلا، عينا صديقتي جمدتا، رقبة الأخرى ملفوفة كرقبة البومة ثابتة على المشهد، دمعة أم غايب أقسم أنها قاومت الجاذبية وظلت شاخصة في منتصف خدها مصدومة بدورها.
أكملتْ في لجج الذهول:
تتساءلون الآن أين أسناني الأمامية؟ كيف اختفت؟ أيعقل أنها سقطت لهول المصاب؟
أما إنها لو استطاعت لفعلت، لا تستغربن، قلعتها كي لا أضحك ثانية، لا أريد أن أضحك، أغادر سيرة الفرح العابر، أوصد فمي الخالي، وأغيب في حزن عظيم.
ويشج صوتٌ مسافات البعاد...
لا محيص... لا محيص... عن يوم خُطّ بالقلم.
ونذوب في دياجير العزاء.








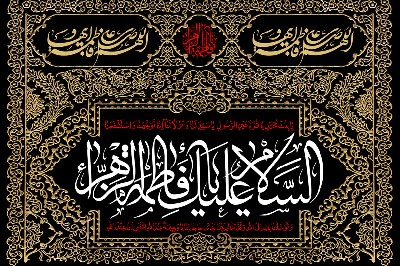





اضافةتعليق
التعليقات