قال تعالى: {شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (النحل : 121).
يقول العلامة الطبطبائي: "إن حقيقة الشكر هو الإخلاص في العبودية". والعبودية تعني الخضوع والامتثال والافتقار الدائم لله تعالى"، وكما ورد من تواضع لله رفعه، ولعل هذا من أسباب ملازمة مسألة الاجتباء مع الشكر، بل وتقديم الشكر على فعل الاجتباء الالهي له فالشكر موجب لزيادة النعم، والتعبد موجب لرفع العبد.
ففي قولها (عليها السلام): "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى جَدِي سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، صَدَقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ كَذَلِكَ يَقُولُ: ثُمَّ كَانَ َعاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ"، وكأن السيدة هنا تتكلم بذات النسق القرآني وهو الثناء على الله تعالى ثم ذكر الاجتباء، فياء الانتساب للنبي (صلى الله عليه وآله) الذي عرفت به نفسها إشارة لهذه الحقيقة أي حقيقة إنها أخذت من جدها الاجتباء الالهي، بل واختارت تعریف سید المرسلين، فالنبوة ختمت ولكن الرسالة لم تختم، فرسل الله تعالى لا ينقطعون وهو تعبير يشمل الحجج الالهيين من أولياء الله تعالى أمثال السيدة زينب (عليها السلام)، فهي ليست من رسل الله تعالى، ورسالیات زمانها بل وسيدتهن، كما إن رسول الله تعالى سيد الرساليين.
والإخلاص بالشكر يتجلى من خلال ذكر أنعام الله تعالى في السراء والضراء بل وشكره حتى على الأمور التي تصيبه وظاهرها ضراء وهذا ما تجسد في أفعال السيدة وخطاباتها في أشد المواقف عليها صعوبة وألما ومرارة، لكنها لم تكن تبتدأ كلامها إلا بالحمد والثناء على الله تعالى.
فلما أقبل عليها طاغية زمانها قائلا: الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. ردت عليه عقيلة بني هاشم (عليها السلام) قائلة: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد (صلى الله عليه وآله) وسلم و طهرنا من الرجس تطهيراً، وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر، وهو غيرنا والحمد لله.
فالسيدة لما ردت عليه قد بدأت وختمت بالحمد لله تعالى، فهو كان يريد أن ينسب فعله الله تعالى، ويظهر إن ما حصل إنما هو أمر الهي، لكن السيدة بردها افشلت مخططه وأظهرت له حقيقة المعبود الذي لا يصدر منه القبح، وخلاصة عبوديتها وقربها من الله تعالى وكرامتها عنده عز وجل.
وأيضاً مما يشير إلى وجاهة السيدة عند الله تعالى أن جعلها باب من أبوابه التي يقصدها الناس لقضاء حوائجهم، لبلوغ أمانيهم التي فيها صلاحهم، وأعظم الحوائج هي التي تجعل الانسان بإيمان أقوى وإلى ربه أرضى، وهذا المعنى نجده فيما لقبت بأنها باب حطة الذنوب، فكما قال الإمام (عليه السلام): "نحن باب حطة وهو باب السلام من دخله نجا، ومن تخلف عنه هوى".
فالذنوب ما هي إلا ظلمات، قلق اضطراب يعيشه الإنسان خاصة إن كان إنسانا ليس ببعيد عن الله تعالى، بل من المؤمنين لكنه ذو إيمان ليس قوي إلى الدرجة التي يردعه عن بعض المعاصي والذنوب، لذا دخوله لأبواب الله تعالى التي هي كلها، نور بلا شك ستنقشع عنه هذه الظلمات، فالتوسل والبكاء وطلب العون من ساداته.
وأمثال السيدة زينب (عليها السلام) وخاصة إن كان عن معرفة لمقامها وعظمتها ووجاهتها عند الله تعالى، فهذا موجب أن تحط عنه ظلماته وذنوبه ولا يكون دخوله كخروجه بل يتغير حاله ويرجع بنور يجعله أقوى، يعود بقرار أن يبتعد عما يجعله ضعيف أمثال هذه الذنوب.
إظهار الكرامة والوجاهة الالهية لهم، قال تعالى: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (آل عمران: 97).
من الأمور التي وضعها تعالى كعلامة من علامات وجاهة أوليائه وعباده المصطفين، وحججه على الخلق، أن لا يظهر كرامتهم في حياتهم فقط، كالمعاجز للأنبياء، والكرامات للأولياء، بل حتى بعد رحيلهم، لأن المتصل بالله تعالى لا ينقطع ذكره، وآثاره ووجاهته، برحيله كلا بل يبقى ببقاء ربه جل وعلا.
وهذه الوجاهة هي لا ترتبط فقط بقضاء الحوائج واستجابة الدعوات فقط، بل إنها تظهر من خلال الشعور بالأمان والاطمئنان والراحة النفسية عند ذكرهم أو التواجد في مقاماتهم التي فيها دفنت أجسادهم الزاكية المطهرة ومقياس ذلك هو التجربة، فكل من تواجد في مقامات أولياء الله تعالى لابد وأن يستشعر ذلك، ويصل لهذه الحقيقة، فكل من يذكر أو يتوسل بالسيدة زينب (عليها السلام) بل ويذهب إلى أي مقام لها، سواء قبرها الشريف أو المخيم الذي خيمت به العائلة والتل الزينبي الذي وقفت عليه لترى الامام بعد أن استشهد في كربلاء، فكل من دخلها كان آمنًا، أي سيشعر بالاطمئنان والسكينة.
مقتبس من كتاب (بطلة التوحيد) للكاتبة فاطمة نعيم الركابي



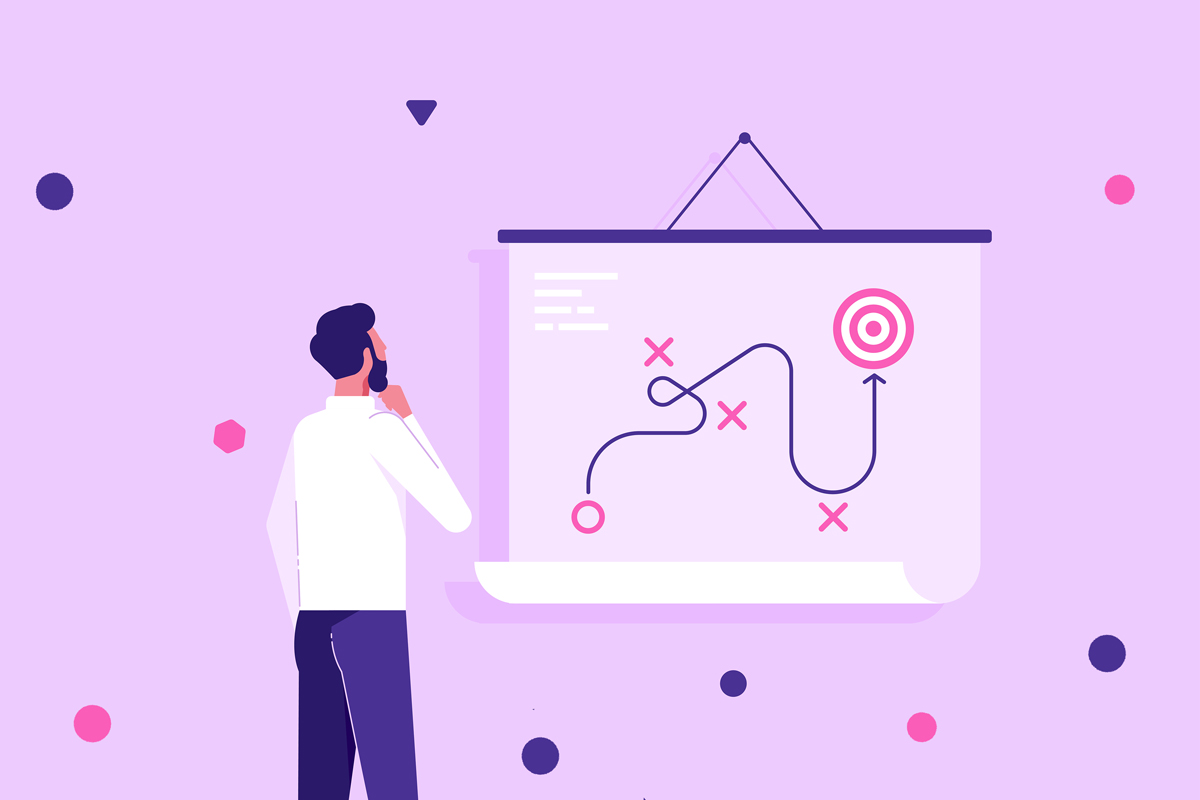



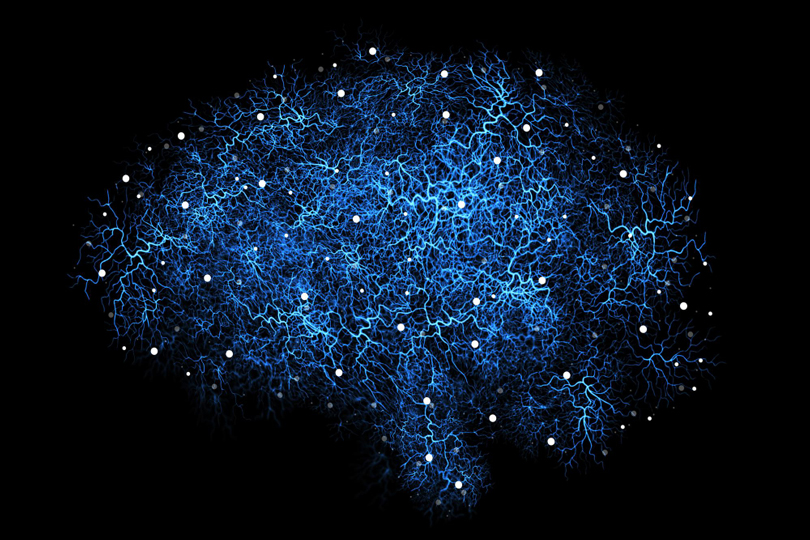








اضافةتعليق
التعليقات