إن المستفاد من الروايات، كما هو المستفاد من العقل والوجدان والتجربة، أن كل فعل له ردّ فعل يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه.
والمستفاد من الرواية الآتية: أن من يكفّ عن سباب الناس، ومطلق التهجّم عليهم، فإن الناس يكفّون عنه، أي بنحو المقتضي. والمفهوم منها عرفاً: أن من لا يكفّ عن الناس، فإنهم لا يكفّون عنه. وذلك من البديهيات الوجدانية، إضافة إلى جزاء النفي من قريش لمن قلّت مداراته للناس.
فلاحظ قوله (عليه السلام) في هذه الرواية:
عن علي بن إبراهيم، عن بعض أصحابه، ذكره عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
"إنّ قوماً من الناس قلّت مداراتهم للناس، فأنفوا من قريش، وأيمُ الله ما كان بأحسابهم بأس، وإنّ قوماً من غير قريش حسنَت مداراتهم، فأُلحِقوا بالبيت الرفيع."
قال: ثم قال:
"مَن كفّ يده عن الناس، فإنما يكفّ عنهم يداً واحدة، ويكفّون عنه أيدياً كثيرة."
وفي الرواية مطالب: أولاً:
إن قلة مداراة الناس مبغوضة عند الأئمة (عليهم السلام)، وإن مداراة الناس محبوبة لديهم. فهل يا ترى من مداراة الناس سبّهم على مستوى الفضائيات والجرائد والمجلات وما شابه؟!
من لا يداري الناس يكرهه الأئمة الأطهار (عليهم السلام).
ثانياً: ذكر العلامة المجلسي في تفسير الرواية وجهين، فقال:
والحاصل: أن الكلام يحتمل وجهين:
أحدهما: أنه لا بدّ من حسن المعاشرة والمداراة مع المخالفين في دولاتهم، مع المخالفة لهم باطناً في أديانهم وأعمالهم.
فإنّ قوماً قلّت مداراتهم للمخالفين...
من لا يداري الناس، يكرهه الأئمة الأطهار.
وقد تَفاهَمَ خلفاء الجور والضلالة من قبيلة قريش، وضَيّعوا أنسابهم وأحسابهم، مع أنه لم يكن في أحسابهم بأس، وإنما كان النقص بسبب ترك المداراة والتقية،
وإن قوماً من قريش لم يكن فيهم حسب ولا في آبائهم شرف، فالحقهم خلفاء الضلالة وقضاة الجور في الشرف والعطاء والكرم بالبيت الرفيع من قريش، وهم بنو هاشم.
ثانيهما: أنّ المعنى: أن القوم الأول، بتركهم متابعة الأئمة (عليهم السلام) في أوامرهم ـ والتي منها المداراة مع المخالفين في دولاتهم ومع سائر الناس ـ نفاهم الأئمة (عليهم السلام) من أنفسهم، فذهب فضلهم، وكأنهم خرجوا من قريش، ولم ينفعهم شرف آبائهم.
وإن قوماً من غير قريش، بسبب متابعتهم للأئمة، أُلحِقوا بالبيت الرفيع، وهم أهل البيت، كما في قوله (عليه السلام): "سلمان منّا أهل البيت"، وكأصحاب سائر الأئمة (عليهم السلام) من الموالي، فإنهم كانوا أقرب إلى الأئمة من كثير من بني هاشم، بل من كثير من أولاد الأئمة (عليهم السلام).
أقول:
فعلى المعنى الثاني، فالأمر خطير جداً؛ إذ إن الإمام (عليه السلام) يقول بأن الذين لا يدارون الناس، ينفيهم الأئمة (عليهم السلام) من أنفسهم، فيذهب فضلهم، وكأنهم خرجوا من قريش، ولم ينفعهم شرف آبائهم.
عكس الذين يدارون الناس، فإنهم يُلحَقون بأهل البيت (عليهم السلام)، كقوله (عليه السلام): "سلمان منا أهل البيت".
وعلى المعنى الأول، فلا ريب أنه ظاهر في كراهة الإمام لترك مدارات الناس، ولذا عبّر العلامة المجلسي بـ:
"لا بدّ من حسن المعاشرة والمداراة"
ولم يقل: "يُستحسن" أو "يُحبّذ" فقط.
وقوله في (دولاتهم): إشارة إلى الإطار العام للحكم، حسبما يراه العلامة المجلسي.
والتاريخ يشهد بأن الدولة ـ بشكل عام ـ هي للمخالفين على امتداد الزمن.
ألا ترى أن حكومة أهل الخاصة كانت، زمناً ومساحة، أقل بكثير من حكومة أهل العامة؟
فعامة الدول الإسلامية في زمن الأمويين والعباسيين والعثمانيين، وفي هذا الزمن أيضاً ـ حيث توجد نحو خمسين دولة إسلامية ـ كلها تقريباً بأيدي أهل العامة.
وقد خرج القليل منها، إما زمناً أو مساحة، بل المستظهر من بعض الروايات أن الأمر سيبقى كذلك عموماً إلى زمن ظهور قائم آل محمد (عليه السلام).
فاللازم حسب هذه الرواية مداراتهم في دولاتهم، بل حتى لو كانت الدولة لنا، فيجب أن نلاحظ حال المستقبل، فنداري في دولتنا كي لا ينتقموا في دولتهم القادمة.
وقد ورد في بعض الروايات:
إن ما صنعه أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الجمل من العفو عن عامّتهم، كان من أهم الأسباب في حفظ ذريته والشيعة من بطش الأمويين، بمعنى أنهم افتقدوا أقوى دليل للانتقام.
ومن الروايات ما جاء في الكافي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بكر الحضرمي، قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
"لسيرة علي (عليه السلام) في أهل البصرة، كانت خيراً لشيعته ممّا طلعت عليه الشمس،
إنه علم أن للقوم دولة، فلو سباهم لسُبيت شيعته."
ثم إن هذه الطائفة الخامسة من الروايات تنفي الجهر بالسباب، لكونه منافياً للمداراة، دون أن تنفي أصله.
لا يُقال: فما بال أمثال أبي ذر والمعلّى بن خنيس، حيث جهروا بمرّ الحق وسبّوا الطرف الآخر؟
يُقال:
أولاً: الجهر بالمعارضة أمر، والسباب أمر آخر، ولا دليل على صدور السباب منهم.
غاية الأمر هو السباب الوصفي، أي ذكر أوصافهم السيئة، دون السباب العلمي الصريح.
ثانياً: الظاهر أن أبا ذر وبعضاً من أصحاب الأئمة كانت لهم إجازة خاصة، حسب الظروف الموضوعية آنذاك.
ولم تُعطَ هذه الإجازة لعامة الناس، ولا لأكثر خاصتهم، بل جرى التأكيد على المداراة والتقية وشبهها.
ثالثاً: أما المعلّى، فقد ضعّفه النجاشي، ووثّقه الطوسي، ونقل الكشي في ذمّه روايات، وفي مدحه روايات.
ولعل منها أنه إنما ذاق بأس الحديد لأنه لم يكتم سرّهم، والظاهر وثاقته وسلامته، إلا أنه أخطأ في عدم الكتمان.
وقد ورد في الحديث:
"علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد الخزّاز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من أذاع علينا حديثنا، فهو بمنزلة من جحدنا حقّنا."
وقال (عليه السلام) للمعلّى بن خنيس:
"المذيع حديثنا كالجاحد له." والتحقيق في ذلك في محلّه.










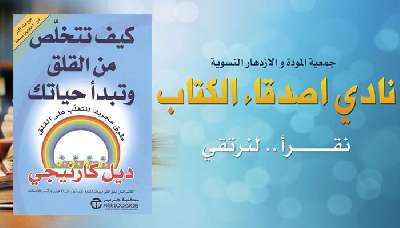



اضافةتعليق
التعليقات