الثقافة، إن هذا المفهوم يكون في الواقع المقياس الصحيح للمستوى الحضاري في بلدٍ معيّن، وللطاقة الكامنة في المجتمع، أكثر مما يقدمه مقياس الآلات وعددها.
لم تكن ألمانيا تملك سنة 1945م الآلات ولا الماركات ولا الدولارات، ولا حتى السيادة القومية، لم تكن تملك سوى رأسمال واحد، لا يمكن تدميره، الحقيقة أنه لم يكن للقنابل الفوسفورية ولا للدبابات القدرة على أن تدمّر ثقافة ألمانيا، وأنا لا أقول (علمها) ولا (تقنيتها) وهما إلتباسان آخران يشوشان كذلك معنى الثقافة؛ لأنّهما يضعان هذه الأخيرة تحت سلطة المدرسة أو المصنع، ذلك أن من أعاد بناء ألمانيا بعد سنة 1945 ليس العالم ولا التقني، فضلاً عن أن معظم العلماء والتقنيين مثل:
(فون براون) كان قد استولى عليهم الأميركيون أو السوفيات وعدوهم غنائم حرب، إنّ من أعاد بناء ألمانيا هو الروح الألمانية، روح الراعي والفلاح والعامل والحمال والموظف والصيدلي والطبيب والفنان والأستاذ.
وبكلمة واحدة، إن الثقافة الألمانية دون التباس، ودون تضييق اجتماعي أو فكري لمعناها هي التي أعادت بناء بلد (غوته) و (بسمارك).
إن رجل (المعجزة الألمانية بعد الحرب ليس (إيرهارد) كما تدعي الصحف والإعلام، فقبل الحرب وقبل (إيرهارد) هناك (شاخت) وهناك(معجزة ألمانية)، وهذه الأخيرة ستتكرر طالما بقي هناك ثقافة ألمانية، أضف إلى ذلك أن حدود (المعجزة) هي حدود ثقافية لا يمكن للمعجزة أن تُوجد خارجها، لقد اتضح لنا هذا الأمر مع الدكتور (شــاخت)، فهو لم يستطع البتة أن يُكرّر هذه المعجزة التي أنتجتها ولا تزال تنتجها بلاده، في بعض الدول الآسيوية التي استقلت حديثاً، والتي استدعته لهذا الصدد، لقد بذل جهداً كبيراً، وشمر عن ساعديه، وضرب بعصاه السحرية، ولكن شيئاً لم يخرج من علبة هذا الساحر، اللهـم ســــوى بعض الخيبة.
علينا أولاً أن ننتهي من البلبلة الفكرية المضرة جداً، والتي تجعل من كلمة ثقافة مرادفاً لكلمة (علم).
هناك كلمة لـ (رابليه) تبت في هذه القضية بتاً قاطعاً، يقول هذا الأب الروحي (للأنسية) الفرنسية: «العلم بلا ضمير مفسدة للروح». إن العلم يُعطي المعرفة، إنّه يُعطي اللباقة والمهارة، وفقًا للمستوى الإجتماعي الذي يتمّ عليه البحث العلمي والعلم يُعطي امتلاك القيم التقنية التي تولّد الأشياء.
والثقافة تعطي العلم، إنّها تُعطي السلوك والغنى الذاتي الذي يتواجد على كل مستويات المجتمع والثقافة تُعطي امتلاك القيم الإنسانية التي تخلق الحضارة.
الثقافة والعلم ليسا مترادفين.
الثقافة تولّد العلم دائماً، والعلم لا يولّد الثقافة دوماً، ولا يمكن استبدال أحد هذين المفهومين بالآخر، إنّ هذا التمييز أساسي، أولاً لدى وضع برنامج يهدف إلى الارتفاع بثقافة بلدٍ ما إلى أعلى مستوى من مستويات الحضارة وثانياً في فهم الظواهر الاجتماعية والسياسية ذات الأهمية الأساسية.
أضف إلى ذلك أن العلم غير شخصي (موضوعي)، بمعنى أن رجل العلم يكون دائماً إنساناً يراقب الأشياء، ليسيطر عليها، وليحسنها، تلك هي النظرة المنهجية (الديكارتية) لعالم الظواهر.
ولكن الثقافة أكثر من ذلك، إنها تخلق الإنسان الذي يُراقب، ويُراقب ذاته في بادئ الأمر، تلك هي نظرة (الغزالي) أو (باسكال) اللذين كانا يبحثان عن تناسق بين عالم الظواهر وعالم الداخل، تلك هي النظرة التي تسمح للإنسان أن يسيطر على ذاته، وأن يُسيطر على الأشياء التي ابتدعتها عبقريته، أي بكلمة مختصرة: أن يتحضر.
إنّ من العسير أن نصل إلى تمييز موضوعي بين دور الفكرة ودور الشيء في ظاهرة التثقيف، إذ أننا ندرس عامة هذه الظاهرة في مرحلتها الحركية، أي في الحالة التي تكون فيها عناصرها مندمجة في حركة متواصلة، وفي هذه الحالة يُصبح من العسير أن نُحدّد أياً من العناصر كان سبباً في الحركة، فالحكم في هذا الموقف العسير يصحبه دائماً نوع من التطرف والغلو، الذي يظهر في صورة نزعة إقليمية ثقافية، وعلى هذا نستطيع أن نتصور عملية التثقيف في مرحلتين متميزتين: المرحلة الحركية (الديناميكية) والمرحلة الساكنة (الاستاتيكية) التي تسبق المرحلة الديناميكية مباشرة، ولسنا نهتم هنا إلا بتلك المرحلة الأولى.
فالفكرة والشيء إذن مرتبطان ومتعاونان تعاون الذراع والعجلة في الآلات التي تغيّر حركةً أفقيةً إلى حركة دائرية: فالذراع هو الفكرة، والعجلة هي الشيء، والذراع هو ولا شك العضو المحرك، ومعلوم أنه لا يستطيع أن يتجاوز ما يُطلق عليه النقط الميتة في حركته، إذا لم تساعده العجلة على اجتيازها بفضل ما لديها من طاقة مختزنة.
فلا مجال إذن في المرحلة الديناميكية لأن نغض من قيمة الدور الذي يؤديه الشيء في ظاهرة التثقيف ولا مجال أيضاً لأن ننكر دور الشيء في خلق الثقافة، ولكنا لا يمكن بحال أن تخضع له الفكرة، بل ينبغي أن نعترف لها بأسبقية معينة في هذا المجال، وبقدر ما يصعب علينا ملاحظة هذه الأسبقية في المرحلة الديناميكية، في نمو ثقافة معيّنة وفي حركتها، فإنّها تكون ظاهرة في المرحلة الإستاتيكية، أي في بداية تحريك الذراع والعجلة، عندما تبدأ عملية التثقيف.
ان الفرد إذا ما فقد صلته بالمجال الحيوي قررنا أنه مات موتاً مادياً، وكذلك الأمر إذا ما فقد صلته بالمجال الثقافي فإنّه يموت موتاً ثقافياً. فالثقافة إذن إذا ما رددنا الأمور إلى مستوى اجتماعي هي حياة المجتمع التي بدونها يُصبح مجتمعاً ميتاً.
إن مقاييسنا الذاتية التي تتمثل في قولنا: (هذا جميل) و(ذاك قبيح) أو (هذا خير) و(ذلك شرّ) ، هذه المقاييس هي التي تحدد سلوكنا الاجتماعي في عمومه، كما تُحدّد موقفنا أمام المشكلات قبل أن تتدخل عقولنا، إنها تُحدّد دور العقل ذاته إلى درجة معينة، وهي مع ذلك درجة كافية تسمح لنا بتمييز فاعليته الإجتماعية في مجتمع معين بالنسبة لمجتمع آخر، إنها تحدد في الواقع المباني الشخصية في الفرد، كما تُحدد المباني الاجتماعية، أو ما أطلقنا عليه من قبل (أسلوب الحياة)، أعني: خاصية الثقافة، وهي بهذا نفسه تُحدّد رقعتها وحدودها.
وهذا يفسر لنا الفروق العامة في سلوك طبيبين ينتميان إلى ثقافتين مختلفتين، كما يفسر لنا الفروق المنطبعة في أسلوب الحياة في مجتمعين تفصل بينهما حدود ثقافية، حتى لو كانا يتعايشان في مكانٍ واحد، كجالية صينية مثلاً في نيويورك، ومجتمع نيويورك نفسه، فتكوين هذه المقاييس بعد إذن أهم أساس في ثقافة المجتمع، والطريقة التي ينقل بها هذا المجتمع إلى كلّ فرد راعياً أو طبيباً تراث هذه المقاييس الذاتية، في صورة عقائد وتقاليد وأعراف وعادات؛ هذه الطريقة تمثل جانباً جوهرياً في ظاهرة التثقيف.
ثقافة الفرد تحددها بيئته الاجتماعية أساساً
فأشياء الوسط الاجتماعي وأفكاره التي تحوط الفرد، يتمثلها الفرد بواسطة نوع من التحليل يدمجها في كيانه الروحي، تماماً كما تتجمع عناصر الوسط الحيوي التي تحوطه وتندمج في كيانه المادي بواسطة التنفس والتمثيل.
والفرد منذ ولادته غارق في عالم من الأفكار والأشياء التي يعيش معها في حوار دائم، فالمحيط الدّاخليّ الذي ينام الإنسان في ثناياه ويصحو، والصورة التي تجري عليها حياتنا اليومية، تكوّن في الحقيقة إطارنا الثقافي الذي يُخاطب كلّ تفصيل فيه روحنا بلغةٍ ملغزة ولكن سرعان ما تُصبح بعض عباراتنا مفهومةً لنا ولمعاصرينا، عندما تفسّرها لنا ظروف استثنائية تتصل مرةً واحدةً بعالم الأفكار وعالم الأشياء وعالم العناصر، فإذا بها تكشف عن مضمونها .. فلكل تفصيل لغة لا تدرك قدرتنا العقلية أحياناً معانيها، وهي مع ذلك واضحةً لذاتيتنا، فتلك التحفة الصغيرة أمامنا في حجرة النوم أو العمل ليست أبداً خامدة، إنّ فيها بعض شيء، بعض ما يشبه الروح يدعونا إلى الكلام كما ندعوه.
وفي الإطار الثقافي يحدثنا الشيء بما فيه من مادة بلغة موضوعية تهم الكيميائي أو التاجر، كما يتحدث بما انطوى عليه من روح بلغة ذاتية، تؤدي إلى روح الطفل والشاعر والموسيقي والمخترع رسالة ملغزة، قد ينكشف مضمونها في إحدى لحظات فقدان الشعور، وبذلك نستطيع أن نفهم أنّ (شيئاً) ما قد يموت بصورة ما إذا ما قطع عن وسطه الثقافي المعتاد، إذ أنّ لغته خارج هذا الإطار تفقد معناها.




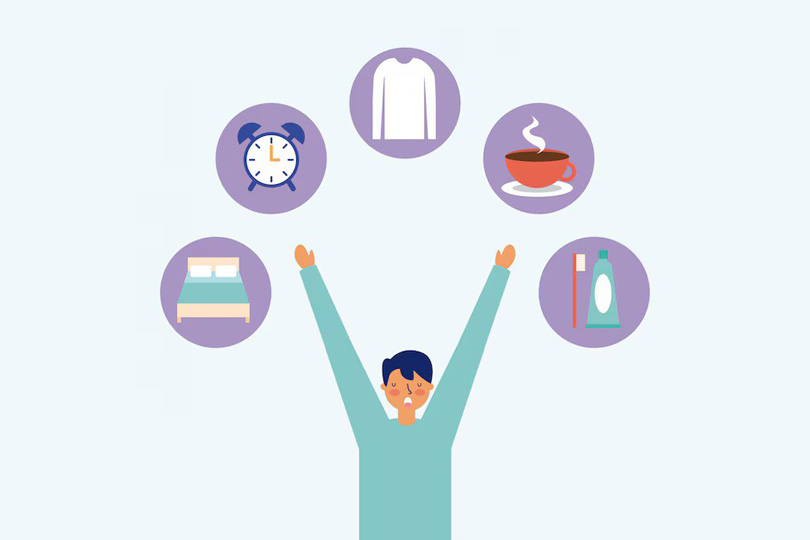











اضافةتعليق
التعليقات