كرمَ اللّه سبحانهُ وتعالى رسولهُ محمد "صل الله عليه وآله" على سائر خلقهِ والأنبياء، وشكل بالأسلام حضارة انسانية كبيرة؛ أظهرت سموها ورقيها على باقي الأمم؛ لما يمتلك من مساحة كبيرة من الحب والتسامح واحترام الآخرين والإهتمام بالإنسان وقضيته الكبرى، وتوفير الحياة السليمة في ظل الرحمة الإلهية، كل ذلك بأساليب، مختلفة، وجميلة، مصدرها السماء لا غير، ولأن أهل الأسلام يعتقدون بعصمته وهذا ما صرح به الكتاب الكريم بقوله تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى).
ثم سار على نهجهُ أهل البيت وهم عنوان مضيء في حياة الإنسانية لا يستطيع أي باحث منصف أن يتجاوزهم كونهم أعلام الهدى وقدوة للمتقين عرفوا بالعلم والحكمة والتقوى والأخلاص لله ولرسوله، هم منهل العلم ورواد حركة الإصلاح من خلال الطريق الذي رسموه للناس بأقوالهم وأفعالهم التي صارت منهجا تربويا سليما.
وفيما يمجد الغرب بعلوم أهل البيت، ويقفون علي أهمية العلوم والمعارف التي ذكرت في القرآن؛ ما زالت المواقف على حالها ليومنا هذا توجه أصابعها لعبقرية الأمام علي(عليه السلام) مليئة بالشك والحقد اتجاه فكر الأمام علي (عليه السلام) وعلمه، وتخطيه حدود الزمان والمكان بحيث أصبح فكراً خصباً للباحثين العالميين الغربيين والشرقيين والمستشرقين، ومما يختلج القلب لم يُأخذ من مناهل علوم اهل البيت وطبق في الحياة إلا النزر القليل منها، وخاصة علوم الإمام علي "عليه السلام".
فهو أولى للتعليم والتربية اهتماما كبيرا، إذ لم يعهد عن أحد من الخلفاء أنه عنى بالناحية التربوية أو بشؤون التعليم كالإمام علي (عليه السّلام)؛ وإنما عنوا بالشؤون العسكرية وعمليات الحروب وتوسيع رقعة الدولة الإسلاميّة وبسط نفوذها على أنحاء العالم ومن ثم كانت حقول التربية الدينية ضعيفة للغاية؛ الأمر الذي أدّى إلى انتشار القلق الديني وقلّة الوعي الإسلامي وكان من نتائجه ظهور الحركات الإلحاديّة والمبادئ الهدّامة في العصر الاُموي والعباسي.
وكان قد اتخذ من جامع الكوفة معهداً يلقي فيه محاضراته الدينية والتوجيهية وأثمرت علومه الغزيرة في اظهار فلسفة التوحيد، وكان على بصيرة من أمره؛ أن لا سبيل لنجاة الأنسان سوى إلمامه بمختلف العلوم ولن يتمكن من ممارسة الخلافة كما أوجبها الله ما دام ضعيف الحجة، مسلوب الإرادة، قليل الإيمان.
هذه الأمور أوجبت أخذه بالتربية والتعليم حتى تستقيم نفسه ويقوى على مقاومة الضلالة والفساد. إلا أن هذه التربية، لا تستند فقط إلى مبادئ نظرية لا صلة بها بالواقع، بل تتخذ منها طريقاً ومنهجاً يعضده العلم والعمل والإيمان بهدف منفعة العباد وخيرهم، كل أهل البيت. ولقد أدرك الإمام علي (عليه السلام) هذا الأمر وطبقه على سائر مجريات حياته، وكان يدعم القول بالعمل؛ إذ لا خير في علم بلا عمل. ولابد للعارف من أن يكون عاملاً حتى لا يكون علمه حجة عليه.
وعلى أي حال فإن الإمام أقام حكومته على تطوير الحياة الفكرية والعلمية وبث المعارف والآداب بين جميع الأوساط. والعلوم الأخرى مستهدفا من ذلك نشر الوعي الديني وخلق جيل يؤمن بالله إيماناً عقائدياً لا تقليدياً وكانت مواعظه تهزّ أعماق النفوس خوفاً ورهبة من الله.
وقد تربى في مدرسته جماعة من خيار المسلمين وصلحائهم؛ أمثال: حجر بن عدي وميثم التمار وكميل بن زياد وغيرهم من رجال التقوى والصلاح في الإسلام، وكانت وصاياه إلى ولديه الحسن والحسين (عليهما السّلام) وسائر تعاليمه من أهم الاُسس التربوية في الإسلام؛ فقد قُنّنت اُصول التربية ووُضعت مناهجها على أساس تجريبية كانت من أثمن ما يملكه المسلمون في هذا المجال.
أما التعليم فقد كان الإمام (عليه السّلام) هو المعلم والباعث للروح العلمية فهو الذي فتق أبواب العلوم في الإسلام؛ كعلم الفلسفة والكلام والتفسير والفقه والنحو وغيرها من العلوم التي تربو على ثلاثين علماً وإليه تستند ازدهار الحركة العلمية في العصور الذهبية في الإسلام حسب ما نص عليه المحققون.
لقد كان الإمام (عليه السّلام) المؤسس الأعلى للعلوم والمعارف في دنيا الإسلام، وقد بذل جميع جهوده على إشاعة العلم ونشر الآداب والثقافة بين المسلمين وكان دوماً يذيع بين أصحابه قوله: "سلوني قبل أن تفقدوني سلوني عن طرق السماء فإني أبصر بها من طرق الأرض"؛ ومن المؤسف والمحزن حقاً أنهم لم يستغلّوا وجود هذا العملاق العظيم فيسألوا منه عن حقيقة الفضاء والمجرّات التي تسبح فيه وغيرها من أسرار الطبيعة التي استمد معارفها من الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله).
لم يسألوا عن أي شيء من ذلك وإنما راحوا يهزؤون ويشككون بعلم الأمام علي "عليه السلام"، "حتى عاش الإمام غريباً في وسط ذلك المحيط الجاهل الذي لم يعِ أي شيء من أهدافه ومثله ولم يعرف حق قيمته ولم يثمن عبقرياته ومواهبه.
وحتى في وقتنا الحاضر، يلاقي علوم اهل البيت مظلومية كبيرة في مناهج التعليم التربوي أو الأعلامي فيما تمجد فيه مراكز الاعلام الغربية! بل حتى بعض الأقوال للرسول وبعض الأمة الأطهار تكتب ويتداول بها في بعض من جوانب الحياة لما لها من أهمية بالغة ومنفذ من منافذ التنمية البشرية والتوعوية، لأن مصدرها الله جلى وعلا.
وبما إن العمل والتطور قد يجر الويل على المجتمع، وإذا لم يستند إلى أساس روحي خلقي وما نراه اليوم دليلاً على ذلك، فالذرة قد تستعمل للبناء وقد تستعمل للفناء والدمار والذي ينحى بها هذا المنحى أو ذاك، هو الإنسان ذاته الذي اكتشفها، لذلك كانت التربية الروحية الخلقية لابدّ منها في صياغة كيان الفرد وتفكيره وخلقه.
والأسلام إرتقى بكل أنواع المعارف وجمع بين التربية الدينية والدنيوية بقوله تعالى: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا)، هذه النظرية للتربية التي انفرد بها أهل البيت، وأسس منهجها الأمام علي "عليه السلام" وهي أكثر شمولاً وعمقاً من تلك التي أوحت بها التعريفات السالفة الذكر، فبينما نرى أن فلاسفة التربية قد قصروا نشاطها على جانب معين من حياة الفرد (أفلاطون ـ ارسطو ـ جولز سيمون) يتوسع الإمام (عليه السلام) في هذا النشاط ليشمل جميع نواحيه الفكرية والاجتماعية والأخلاقية والدينية والدنيوية. حيث شمل في برنامجه التعليمي والمعرفي كل العلوم التي تحدث عنها الفلاسفة والعلماء في كل عصر وجيل.
الإنسان في هذا الوجود خُلق لتحقيق غاية شريفة كاملة عبر عنها القرآن الحكيم بشكل صريح في قوله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) وتحقيق العبادة أمر ليس ميسوراً جداً، بل بحاجة الى جهد كبير.
وعلى أي حال فإن الإمام أقام حكومته على تطوير الحياة الفكرية والعلمية وبث المعارف والآداب بين جميع الأوساط. ووضعها في متناول العاشقين والراغبين في التزود من علمه.
وهو القائل: "لاتستوحشوا طريق العلم لقلة سالكيه"، هو كان يعرف ماتؤول إليه أحوال الأمة بعد فقد نبيها الكريم! ولكن أراد الله أمراً كان مفعولاً. وبما أن أهل البيت هم صوت الحق والقرآن الناطق على الأرض، ستجد صعوبة بالغة في نشر علوم أهل البيت، فلابد من وقفة جادة لإظهار تلك الكنوز الوافرة من المعرفة في كل المجلات المعرفية وزجها في مناهج التربية والتعليم والإستفادة من تلك الموسوعة العظيمة لأهل البيت، وتطبيقها عملياً في الحياة فعلم أهل البيت هو علم لكل الأزمنة ولا يقتصر على عصر معين.


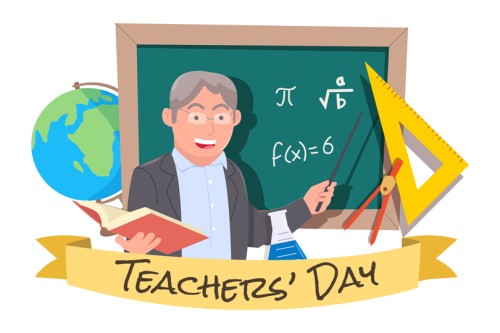

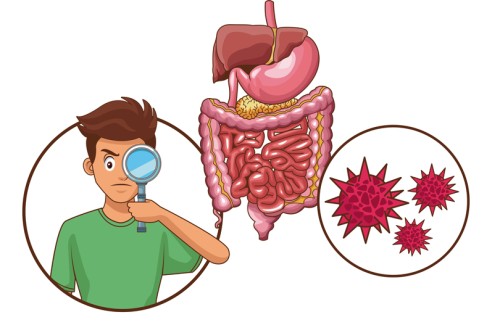









اضافةتعليق
التعليقات