لأول مرة في حياتي كنت أستمع لدقات قلبي واضحة بهذه الرتابة، تتراكض نبضاتها وكأنها تهرب من التوقعات، خلتها ستقفز مبتعدة عن جوفي، تاركة إياي أواجه قدري، وحيدة عزلاء أمام رجل بدا لي في أول وهلة هادئاً غير آبه، ولكن سرعان ما كشفت حركة رجله الإهتزازية عكس ذلك.
قال بلهجة دافئة تموج فيها الحرج:
_ هل سوف تأتين في الموعد؟ نتكلم فقط والرأي لك!
شعرت كأنني أجول شوارع مدينة كثر فيها الغرباء، مرّت كلّ السنون الأربعون التي تعلّقت بتلابيب الخواطر كومضة سريعة.
خطفتُ نظرة في وجهه، هل كانت عيناه بنية تشبه عيون القطط البريّة كل هذا الوقت؟! عجباً لم أنتبه لذك!!
كطلقة نافذة انتزعت تلك النظرة من فمي، كلمات نازَعَت المكابرة والعناد المتجذر في دماغي، لتُشعل فيه البصيص الذي نجا من وابل طلقات اليأس.
أجبته بتلعثم:
- حسناً لا بأس! ولكن لا تراهن على النتائج كثيراً.
فاضت ما بين شفتيه ابتسامة عكست في وجهه شيطنة لطيفة‘ أغلق باب المكتب خلفه؛ فأصدر صوتاً أعاد أنفاسي الحبيسة خلف قضبان الإرتباك.
لا أعرف لماذا كنت ممتعضة‘ ربما لأنني تعوّدت رفض المواعيد واللقاءات، وكلّ الحركات التي توحي ببداية ارتباطات طويلة.
فجأة رنّ جرس الهاتف فانتفضتُ واقفة كجنديّ في معسكر‘ سرت قشعريرة في كلّ أوصالي عندما قرأت مكالمة واردة من (أمجد).
كان أمجد رجلاً وخط نهايات الأربعين من عمره، كثيف الشعر تغلب في محياه ملامح الطيبة، مربوع القامة هادئاً في أغلب الأحيان، عدا تلك التي يتحدّث فيها مع رفاقه عن مستجدات الأمور السياسيّة.
أجبته:
- نعم تفضل!
- آسف علي الإزعاج‘ نسيت إعطاءك العنوان‘ سأرسله على الجوّال، سوف أنتظرك في المنزل.
للحظة أيقنت أنّني هويت في فراغ، أخطأت في قبول عرضه، ها هي نواياه تتكشّف رويداً رويداً.
- أجبته دون تريّث:
- إنك مخطئ يا أستاذ أمجد، لا أستطيع المجئ، أعتذر جداً، والآن لدي عمل متراكم لا بدّ لي من الذهاب وداعاً، وأغلقت الخط!.
إنحدرت دموعي دون استئذان وسارت على الأخاديد تشقّ طريقها نحو الفناء.
رنّ الهاتف مرّة أخرى، وأخذ يهتزّ على طاولة المكتب مصدراً صوتاً كأزيز النحل.
جاء صوته راجياً متوسّلاً:
- أرجوك لا تقفلي! إستمعي إليّ، لقد إستعدت لهذا اللّقاء منذ فترة. لست وحيداً في المنزل، معي والدتي، كما أنّ العاملة أمّ جاسم موجودة أيضاً، ثم أنّك تستطيعين الحضور مع من شئت، أردت فقط أن تتعرّفي على أسرتي من قريب.
هدّأ كلامُه من روعي، على الأقل إنّه لم يفكر تجاهي بسوء.
- حسناً سوف آتي مع الوالدة.
إرتديت فستاناً طويلاً، أخضر، غامقاً بلون الطحالب، متدلياً من أعلى الكتف حتى الساق‘ زيّنه في المنتصف حزام يلتفّ برشاقة يوحي بخصر نحيل، كما أخبرت والدتي بأنّه تعارف فقط، بما أنّها لم تتوقف لحظة عن طرح الأسئلة.
- لماذا لم يتقدّم هو كما يفعل الناس؟!
إنّي لم أر فتاة تذهب للقاء خطيبها، لا بدّ أنّك جننت؟!
سقطت منها كرة الصوف الأرجوانية التي كانت منشغلة بحياكتها متدحرجة نحوي، التقطتُها وبدأت بلفّها مرّة أخرى، وأنا أتقدّم نحوها:
- أريد أن أرى الناس الذين سيحيطون بي كيف يعيشون؟! ماذا يلبسون؟! كيف يأكلون ويتصرفون؟! أريد أن أتعرف للبيئة التي سأقطنها.
لا أخفي أنّني كنت أرتاح لذلك الشعور الذي يغمرني بالإرتباك عند ذكر اسمه وينقلني إلى عوالم خفية أغوص مندهشة في أغوارها.
ضغطت زرّ التشغيل في السيّارة وتوجّهت على العنوان الذي كان قد أرسله لي، تجاوزنا الباب الخارجية؛ كان المنزل فسيحاً يتوسّط حديقة غنّاء، زادتها نتف الثلج البيضاء حلاوة وبهجة، كعروس تلتهب في ثوبها الأبيض تألّقاً وحرارة، يحدوها من أحد الجوانب حوض للسباحة تقابله مسطبات وكراس وضعت للإستراحة والإستجمام، استباحها الشتاء بجرأة وصلافة.
طرقنا الباب، ففتحت لنا فتاة لا يتجاوز عمرُها الخمس سنوات شقراء، لوزيّة العينين، تناثر شعرها مسترسلاً قد غطّى رقبتها متدلّياً نحو الأسفل، نظرت إليّ بتمعّن ثمّ قالت:
- قال والدي إنّنا ننتظر ضيفاً مهمّاً هل أنتِ ذلك الضيف؟
نكزتني والدتي قائلة بنصف شفة مفتوحة:
- لديه فتاة صغيرة إنتبهي جيداً لما تريدين فعله!
جلستُ لمستوى الفتاة وخاطبتها: أظنّ ذلك يا عزيزتي أنا اسمي وداد ما اسمك؟
ردّت بحلاوة:
- غيداء!
- حسناً غيداء هل تخبرين والدك بقدومنا؟
تناهى من الداخل صوت امرأة نادت متسائلة:
- غيداء من الطارق؟
- إنّهم الضيوف يا جدّتي!
جاء أمجد لاستقبالنا، كان أنيقاً، جميلاً، قد ارتدى بدلة كحليّة بقميص أبيض مائلاً للزّرقة، وربطة عنق حريريّة. اختلط عطره بأنامل البرد التي أخذت تتلاعب بالمشاعر دون استئذان.
ما إن دخلنا الصالة حتى رأيت وجه أمي قد تغيّر وتماوج فيه طيف من الألوان المتقلّبة، بعدما شاهَدَت المنظر المفاجئ؛ أظهرت منديلاً من ورق المحارم وأخذت تمسح به العرق النازّ من جبينها.
فتاتان تتراوح أعمارهنّ بين العاشرة والثانية عشرة مع صبيّ قد اصطفّوا لاستقبالنا، تراكَضَت بعد ذلك غيداء لتصطفّ آخر المطاف.
أخذ أمجد يعرّفهم علينا:
- نجلاء في الصف الثاني الإعدادي
- حوراء في الصف الرابع الإبتدائي
- منتظر في الصف الثالث الإبتدائي
- وهذه غيداء
شعرت بسيل من الأحاسيس المتضاربة تنتقل في كلّ عصب من رأسي وأنا أحاول جاهدة معرفة السبب الذي جعلني أظنّ أن أمجد لم يكن يمتلك أولاداً!!
جلسنا وتداولنا في جوانب مختلفة من الأحاديث الجانبيّة.
كان الأولاد في غاية الأدب والإحترام، في ملامحهم قاسم مشترك من الحزن الضارب في أعماقهم؛ هناك في نقطة القاع البعيدة جداً.
أما والدة أمجد فقد كانت امرأة في الستين من العمر، سمراء البشرة، ترك الزمان في سحنتها بصمة واضحة أخفتها بشاشة الترحيب.
بينما كانت أمي غارقة في سكون مطبق؛ كنت أخاطب نفسي طوال الوقت هل علي أن أربّي أربعة أولاد لشخص لا أعرفه سوى معرفة سطحيّة؟!
ثم على فرض أنّي قبلت، ألا أستحق أن أحظى بأولاد لي؟! على سبيل المثال لو أنجبت ثلاثة إخوة لهؤلاء الأربعة سوف يصبحون سبعة!!
في هذه الأثناء ركضت غيداء وجاءتني بدفتر كتبت فيه:
- دادا دور دادا نام وهي تقول:
- آنسة وداد!
آنسة وداد!
هل ستوقعين لي ملاحظات الست رؤى كلّ ليلة؟!
إنشغل أمجد بمكالمة هاتفيّة استأذن قبلها للخروج؛ فاستغلت والدته الفرصة وقالت:
- كانت (أمينة) أماً أمينة بحق، أجادت في تربية أولادها، حتّى في مرضها لم تتوان عن مسؤولياتها، مع الأسف، اكتشفنا المرض متأخرين، كان أمجد يهيم في حبّها حتى خشيت عليه الإنهيار بعد فقدها، على الأرجح أنّه قاوم من أجل الأولاد؛ يتامى زوجته الحنون التي قضى معها أحلى الأوقات وأبى أن يفكّر بواحدة سواها, لولا إصراري وتهديدي بأنّني لن أرض عنه إذا لم يُقدم على الزواج، الأولاد يحتاجون لأم ترعاهم حتى لو فقدوا الأولى التي أنجبتهم؛ رضي بعد لأي بشرط...
قطعت كلامها غيداء:
- آنسة وداد!
أنظري أنا أعرف كتابة اسمك فقد أخذنا كلَّ حروفه:
و د ا د
تفتّحت الإبتسامة في ثغرها كجنبذة صغيرة، احتضنتُها وقبّلت وجنتيها الحمراوتين فتشابكت أحاسيسي بحلاوتها مكوّنة عقدة لا يمكن حلّها.
كانت نجلاء تنظر إلينا بطرف عينيها، قطّبت جبينها، بينما راح منتظر ينقر في صفحة الجوال وقد طغت في ملامحه علامات البرود.
استأنفت أم أمجد متنهّدة:
- قال أنّ هناك زميلة لي في العمل، إن قبلت الإقتراح فبها، وإلا لن أتزوج أبداً؛ لا أئتمن على أولادي عند غيرها!!
ساد الصمت للحظات، كنت أتأمّل غيداء وهي تلاعب دمية وتصفّف شعرها كأم حنون. ما هي إلا لحظات حتّى انقشعت غيوم الصمت وجال في الأرجاء صوت طفل يبكي! ثمّ دخلت العاملة تحمل في يدها طفلاً لا يتجاوز السنتين!!
جحظت عينا أمي وأصابني البهت كصفعة مفاجئة، يا إلهي إنّه طفل رضيع!
طوال خمسة أعوام كنت أشعر بالإعتزاز أنّني تكفّلت عشرة أيتام في إحدى المؤسّسات الناشطة في هذا المجال، أدفع رواتبهم الشهريّة كلّما استلمت وجبة من عملي كمحامية في المحكمة، وعميلة لبعض الشركات المعروفة في المجتمع. ولكنّني لم أتصور يوماً أنني أتكفل تربية واحد منهم.
كان صبياً أبيض الّلون يميل نحو السمنة، بشعر مجعّد أشقر، وعينين زرقاوتين كعيني جدّته.
قالت أم أمجد بصوت هدّجه التأثّر:
- هؤلاء الأولاد يعيشون أزمة نفسيّة لا يتجاوزونها إلا إذا شعروا بالحنان تجاه أم ترعاهم.
تقوم أم جاسم بكل أعمال المنزل، وأنا أيضاً أحاول أن لا أقصّر كلّما سنحت لي الصحّة، وحلحلت عنّي الأوجاع حبالَها؛ سوف لن يتضرّر عملك بشئ!.
كانت يداي باردتين، حينما أخَذَت حبّات من العرق تتقاطر سالكة طريقاً مستقيماً من رقبتي حتّى أسفل ظهري.
شيّعنا أمجد إلى الباب، كان الليل هادئاً كالمحيط‘ سطحه ساكن لكنّ أعماقَه تهدر بالحركة.
لاحظت في عينيه عالماً ضاجّاً بالجدل والتحليلات، سبقتني أمي إلى السيّارة، حدّق في وجهي بجدّ أكبر وهو يقول: فكّري يا وداد جيداً، ثمّ انتبهي، لا يكون الوضع هادئاً دوماً كما رأيته الآن! نطق بهذه الكلمات وقد غصّ حلقُه، واختلج صوتُه وكأنّه صعد فجأة سطوح المنطق.
رفعتُ رأسي ونظرت في عينيه مباشرة بجرأة باغتتني لثوان معدودة، وهممت بالرحيل ثم تذكّرت شيئاً نسيته في الداخل، ناديت:
- غيداء! غيداء!
أعطني دفترك نسيت أن أوقّعه!
فتراكضت نحوي الفتاة مهرولة تاركة لعبتها، تحمل قلماً بيد ودفتراً بيدها الأخرى.











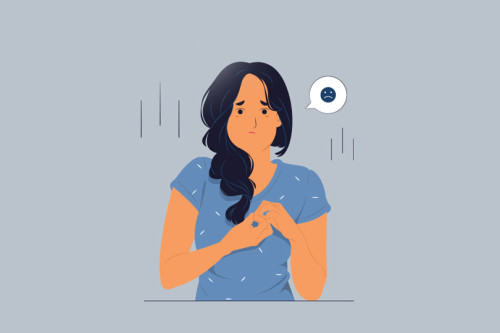


اضافةتعليق
التعليقات