رسالة الحب غير المشروط: أحبّك لأنك إبني، أحبّك مهما فعلت، أحبّك مهما كنت.
لا شك ولا ريب في محبة الآباء والأمهات لأبنائهم، كما لا شك في مقدار عطفهم وحنانهم تجاه فلذات أكبادهم، فالقاسم المشترك بين الآباء والأمهات الأسوياء، أنهم مفطورون على الرحمة التي انزلها الله في قلوب عباده..
من تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
(الله رحيم بعباده. ومن رحمته أنه خلق مائة رحمة جعل منها رحمة واحدة في الخلق كلهم. فبها يتراحم الناس، وترحم الوالدة ولدها)..
إلا أن المشكلة الأساسية التي تخل بالثقة، هي أن الأبناء لا يعلمون ذلك، ولا يدركون مقدار حب والديهم لهم. ولو جئنا وسألنا هؤلاء الأبناء سؤالا محددا: متى يحبكم آباؤكم وأمهاتكم؟
لوجدنا قائمة شبه تعجيزية على الأبناء أن يحققوها ليحبّهم آباؤهم وأمهاتهم، وبطبيعة الحال أن الإبن يستجيب في العادة لما يتصوره ذهنه، وما يمليه عليه فكره، فإن اعتقد أنّ الأم لن تحبّه إلا إذا كان متفوقا في صفه وبين زملائه، وأنه يطيعها ويبادر إلى طاعتها تحت كل الظروف، ويأكل كل الأطعمة التي لا يحبها، ويحاول ارضائها وكسب مودتها في اطالة ساعات الدراسة والانهماك بالدروس، والامتناع عن الأمور المبهجة بالنسبة إليه، فإذا لم يفعل كل ذلك سيشعر بالإحباط، وسييأس من نيل محبة أمه، وعندها تُفقد الثقة.
هناك للأسف بعض الآباء والأمهات، يستثقلون كلمة: احبك على ألسنتهم، بل تكاد تكون مفقودة من قواميسهم التربوية، فنحن نجدهم بارعين في اللوم والعتاب والتجريح لكنهم يفتقدون مهارة زرع الحب في نفوس أولادهم، ما الذي يضير الأب مثلا أن يغدق على إبنه ثلاثة وجبات دسمة باليوم مدافة بكلمة أحبك؟ ولماذا لا تستطيع الأم أن تترجم حبّها لولدها بقول: أحبك؟ فهل ينقص من رصيدها شيئا؟ أين يكمن الخلل ياترى؟
أعتقد أن الخلل يكمن فيما توارثه الآباء والأمهات من أسرهم سابقا، فالأبناء هم مرآة لوالديهم، وانعكاس تصرفاتهم، وبما إنّ الأم والأب كانا يفتقدان لسماع هذه الكلمة في طفولتهم، فلا تنتظر منهما أن يعبّرا عن حبّهما لأبنائهم، ويعلنان لهما بسبب أو بلا سبب عن مكنون الحب بداخلهم.
ولعل من أكثر الأمور _ كما يقول التربويون _ التي تشعر الأبناء بمحبة آبائهم وأمهاتهم، هي مصادقتهم، ومحاولة مد جسور المحبة من خلال اللعب معهم، ومشاركتهم ساعات فراغهم بما ينمّي ويوطّد علائق الحب بينهم.
(فإذا أراد الأب مثلا أن يصادق إبنه، عليه أن يتذكر أنّ فم ابنه أكثر يقظة من عقله، وأنّ الحلوى عادة أفضل من الكتاب الجديد، وأنّ الثوب الملوّن أحبّ إليه من القول المزخرف، وأنّ اللعبة البسيطة التي تلعبها معه، والنشاط الممتع الذي تشاركه فيه، والرحلة الشائقة التي يجدك معه فيها، أحبّ إليه من عشرات الآلاف التي تنفقها عليه وعلى دراسته وعلى البيت).
وكم هو جميل ومفرح دخول الأب إلى بيته، وهو يحمل بين يديه ما يدخل الفرحة إلى قلوب أبنائه؟ وكم يترك من أثر ايجابي في نفوس أولاده، دخوله وهو محمّل بالهدايا والتحف، فيشيع جو الأسرة بالحبور والهناء؟
فمصادقة الأهل لأبنائهم من الذكاء بمكان يستطيعون من خلالها ردم الفجوات وزرع الثقة والمحبوبية في الأبناء، فالصداقة تشعرهم بأنهم مرحبّا بهم في وسط العائلة، وأنهم أطفالا مرغوبين، وأنهم لولاهم ما اكتمل بنيان الأسرة، وأنهم بهجة البيت وسروره.
إلّا أنّ ما يدعو للحيرة حقا، هو أنّ جميع الآباء والأمهات يرغبون في مصادقة أبنائهم، والتقرب إليهم بمختلف الطرائق والسبل، ولكنهم للأسف لا يفعلون ذلك، هل تعلمون لماذا؟
لأنهم غير مستعدين لدفع الثمن، وهو التخلي عن السلطة والتحكم . فالأهل يتمسكون بزر التحكم إلى ما لا نهاية، وهذا هو الخطأ بعينه.
وعودة على بدء... الحب بلا شروط مسبقة، تخلق أولادا أسوياء نفسيا وعاطفيا، لأن الحب له سحره العجيب، في استمالة القلوب، وتنقيتها من شوائب الكدر والغيظ والكراهية.
فلا مناص للوالدين من الكرم، ولا مهرب أمامهما سوى طرق باب المحبة بيد ملئى بالود والحنان..
وقول: أحبّك ياولدي كما أنت، هي أولى سلالم التوازن النفسي، فهل سنرتقي تلك السلالم وفي جعبتنا سلال محبة وامتنان؟
إذاً لنبادر إلى البناء فورا..
ولنستبدل بالتعنيف التفهم والإحتواء.. وبالعصبية الحوار الهادىء، ونستبدل اللوم والتقريع بكلمة: أحبّك.. فهل سنسعى نحن الآباء والأمهات لخلق التوازن النفسي المطلوب في حياة أبنائنا، كمهمّة أساسية من مهام دورنا التربوي؟ أم نظل عالقين في مساحة جدباء تفتقر للحب ومشاعر التطمين؟.




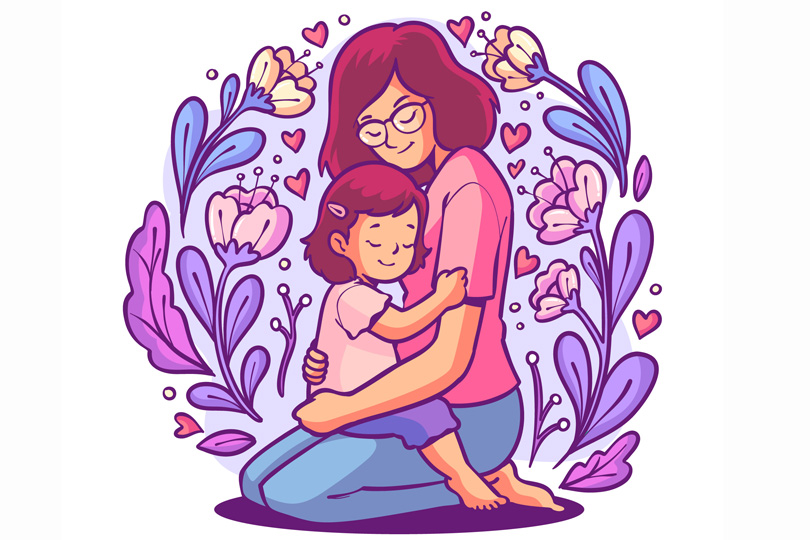
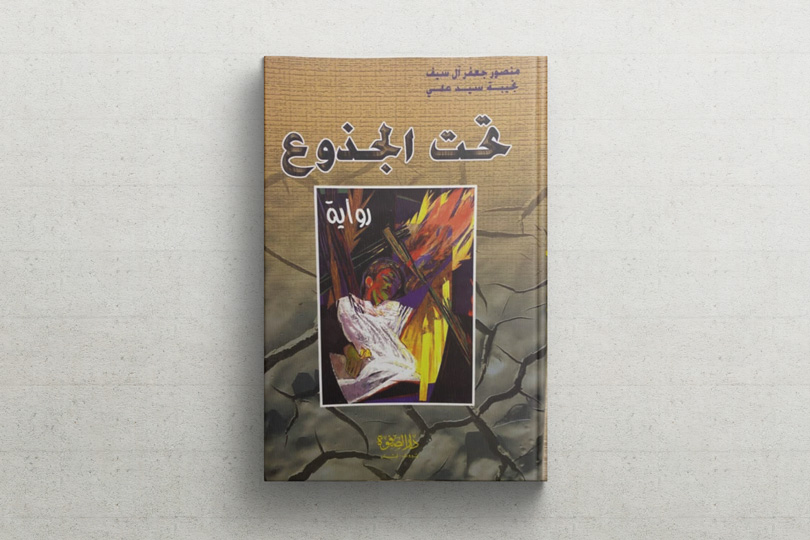










اضافةتعليق
التعليقات