يقول أرسطو طاليس: "إن أعلى مراتب السعادة الإنسانية هي السعادة التي تنشأ عن الحياة العقلية؛ لأن العقل هو الذي يميز الإنسان على غيره من الكائنات، وسعادة كل كائن إنما تقوم على ما تتميز به طبيعته، فرأس الفضائل هو الحكمة"، وفي المرتبة الثانية بعد الحكمة يضع أرسطو طاليس الفضائل الأخلاقية مثل: الشجاعة والعدل؛ فالسعادة التي تنشأ عن التخلق بهذه الفضائل تالية في درجتها لسعادة الحياة العقلية.
والسعادة الإنسانية التي يتكلم عنها أرسطو طاليس ليست هي التمتع، ولا هي اللذة؛ فهي لا تقوم على الشهوة، ولا على الشهية؛ لأن الشهوة والشهية من صفات البهائم أما سعادة الإنسان فتسمو فوق التمتع وتعلو على اللذة بقدر ما يسمو الإنسان، ويعلو على البهائم، والسعادة بهذا المعنى الرفيع هي الخير في أعلى مراتبه، وهي الغرض من حياة البشر، والفضائل الإنسانية إنما تقاس بنسبتها إلى هذا الغرض الأسمى، وعلم الأخلاق هو البحث في الفضائل والمقارنة بينهما، ونسبتها إلى خير البشر وسعادتهم.
والذي يستلفت النظر في فلسفة أرسطو طاليس الأخلاقية أنه يجعل الحياة العقلية، أو الحكمة رأس الفضائل جميعًا، بل إنه ليذهب إلى أبعد من ذلك؛ فالتفكير أو التأمل في نظره هو السعادة التامة، وهو الغرض الأسمى من الحياة الإنسانية، ويدلل على هذا بأدلة مختلفة، منها: أن التأمل أكثر الأفعال البشرية استقلالا عما سواه، وأنه أكثرها اتصالا واستمرارًا، وأدومها أثرًا، وأنه غاية في ذاته وليس وسيلة إلى غيره، ويرفع أرسطو طاليس الفكر البشري إلى مرتبة التقديس فالحكمة والعلم من صفات الألوهية؛ ولذلك كان الاشتغال بالعلم عملاً لا كغيره من أعمال البشر العادية بل يرتفع فوقها جميعًا لاتصاله بنفحة ربانية مودعة في النفس البشرية.
فالاشتغال بالعلم أمر له خطره، وعمل له قدسيته، ورسالة العلم رسالة خالدة، لا يحملها إلا من تطهرت نفسه، وعلت همته، ولا يتلقاها إلا من خشع قلبه للحق واستنار فيه ذهنه بنور اليقين، وطلب العلم إن لم يكن رأس الفضائل جميعًا كما قال أرسطو فهو منبع من أصفى منابعها، فطالب العلم طالب حقيقة، ومن طلب الحقيقة أحب الحق.. ومن أحب الحق كان صادقًا ومن كان صادقًا كان شجاعًا.. ومن كان شجاعًا كان ذا مروءة.. ومن كان ذا مروءة كان كريماً ومن كان كريماً كان رحيما، وأحب الخير، وناصر العدل، وأمر بالمعروف، ونهى عن المنكر.
ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى انتشار الروح العلمية بيننا، فالنظرة العلمية إلى الأمور نظرة بعيدة عن الغموض لا تشوبها الشهوة، ولا تتسلط عليها الأنانية، وهذه النظرة هي وحدها التي تصلح لمعالجة المشكلات العامة، وحل المسائل القومية، سواء أكان ذلك في ميدان الاجتماع، أو ميدان السياسة، أو ميدان الشؤون الاقتصادية والمالية، وكثير من المشاريع والأعمال تخفق أو تُطوى بسبب الأنانية، وتغلب النزعة الشخصية على النظرة الموضوعية؛ فيحجب وجه الحقيقة، وتضيع معالم البحث، ويحل التنابذ والتطاحن محل التفاهم والتعاون وإذا كان هناك بحث فإنه في الغالب بحث لفظي، قوامه الجمل المنمقة، أو الجدل الأجوف الذي لا يرتكز على تجارب، ولا يعتمد على حقائق، فهو جدل بغير علم ولا هدى.
حدثنا عالم من علماء الهنود زار إنجلترا، وشاهد الطريقة التي اتبعتها هذه الأمة في حل مشكلاتها، قال إن اللجنة المكلفة بالبحث تؤلَف من الفنيين في نواحي البحث المختلفة، وقد حضر اللجنة وهي تجمع بين أستاذ للرياضيات في أحد طرفيها، وعامل من عُمّال صناعة الزجاج في الطرف الآخر، بينهما حلقات متصلة من العلماء والفنيين والمهندسين، وقد وضع تحت تصرف اللجنة الإحصائية الوافية عن مهمتها، والمعامل اللازمة لإجراء التجارب العلمية، فلا تلقى الخُطب، ولا تحتدم المناقشة، ولا تدخل النزاعات الشخصية، بل تسود الروح العلمية روح البحث عن الحقيقة أنى وجدت، فالكل مجتمع على غرض واحد ومعني بأمر واحد هو الحق، وهو الخير في جو من حرية الفكر، فالقول السديد مقبول قبولاً حسنًا أياً كان قائله؛ إذ العبرة بالحقائق لا بالأشخاص، ولا عجب أن هذه الأمة الكبيرة، هذه الأمة العالية المفكرة قد وُفقت إلى حل.
فالعلم أكبر عامل على رفع الأخلاق في الأمة؛ لأنه يرتفع فوق الصغائر والدنايا إلى سماء الحقيقة الخالدة، والعلم علم من أعلام الفضيلة؛ لأنه يسمو فوق الشهوات، ولا يحفل بالمآرب الفردية، وهو مطهر للنفوس من أدناس الأنانية؛ لأنه يحمل شعلة مقدسة، تذيب الأثرة، وتمحو حب الذات، وتحمل محلهما الإيثار والرغبة في خير المجتمع.
ولما كان العلماء أعرف الناس بالخير وأقربهم إلى الفضيلة، فإن عليهم واجبًا من أقدس الواجبات في الأمة، بل وفي المجتمع البشري على بكرة أبيه، ذلك الواجب هو الدعوة إلى الخير، والدعوة إلى الفضيلة والتمسك بالحق، والدفاع عن الأخلاق القويمة، ولست أقصد بهذا أن يتحول العلماء إلى وعاظ، يُلقون على الناس عبارات النصح والإرشاد، بل إن واجبهم أكبر من ذلك، وأعظم خطرًا، وأساس هذا الواجب أنهم يؤمنون بقدسية العلم، وقدسية الحق، وقدسية الفضيلة، وأنهم يزنون الأمور بقسطاس الحق، ويقيسون الأشياء بمقياس الخير، وبذلك يخرج حكمهم منزهًا عن الهوى، مُتفقاً مع القيم الروحية الصحيحة، ومن أوجب الواجبات على الدولة أن تترك العلماء أحراراً في حكمهم على الأمور أن تشعرهم باستقلالهم؛ لأنهم قادة الفكر، كما أن على العلماء أن يتمسكوا بهذا الاستقلال، فاستقلال العلم والعلماء شرط لا بد منه لحياة العلم والفضيلة على حد سواء، وإذا ضاع استقلال العلم، وضاعت الفضيلة، بل ضاعت الأمة، وقد بقيت أوربا ألف عام في ظلمات العصور الوسطى؛ لأن أمورهم كانت في أيدي قوم لا يؤمنون بالحق، ولا يؤمنون باستقلال العلم، فاضطهدوا العلماء، وحاربوا حرية الفكر، وانغمسوا في الجهالة مُحتمين وراء الجدل اللفظي الأجوف، فعمّ الظلم والضلال.
ومن أكبر الشرور في أمة أن يخضع علماؤها لمقاييس جُهالها، فيكون حكمهم على الأشياء مبنياً على المصلحة الذاتية العاجلة، بعيدًا عن المُثل العليا، فهذه الأمة ليس فيها من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، ولذلك فهي أمة ضالة، مآلها الاستبعاد، أو التشتت أو الزوال، وكلما ارتفع المستوى الخُلقي لقادة الفكر في الأمة، واقتربت القيم في نظرهم من القيم المثالية الروحية سمت الأخلاق وعلا مستوى العلم والفضيلة، وتحققت السعادة الإنسانية بين الأفراد.
من كتاب (العلم والحياة) تأليف علي مصطفى مشرفة








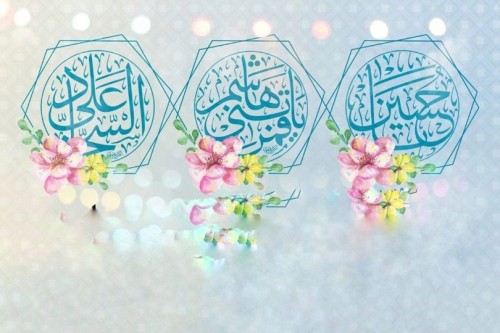







اضافةتعليق
التعليقات