يبزغُ خيط الفجر الصادق، وكميل ما زال جالساً يُرتل القُرآن، يلمحُ طيفاً سماوياً كأنه سيده علي!
أهذا أنت مولاي؟
فـ ينقشعُ الضباب ويلوحُ علياً في الأفق قرآناً ناطقاً..
فينثرُ السلام والسكينة على روح كُميل، ليستعد لما سيحمل ثم يطلبُ منه أن يسيرا، ولأنَّ كميل يحتاج لقرآن ناطقٍ يفكُ طلاسم قرآن الجليل يدركُ معنى مسراه مع سيده..
يمران على شيخٍ يُرتل القرآن، جميل الصوت ليوقع في قلب كُميل لذة هذا الجمال فـ يُعجَّب به!
لله در هذا الشيخ كيف يقرأ القُران؟ تمهَّل يا كُميل! مالك والظاهر؟ وأنتَ تسكنُ بين أحشاءكَ بواطن المعرفة؟.
كم قارئاً للقرآن والقُران يلعنه!
إعلم يا كُميل إنكَ في كل حركة تحتاح فيها الى معرفة!
حين نتصفح هذه الحادثة نقفُ في طريقٍ يحملُ كل المتضادات التي من الممكن أن يقع العقل في إشكالياتها!.
فكيف يمكن لقارىء القُرآن أن يكون جاهلاً بالذي يقرأه؟ بل كافراً به؟ وعليه ترتبَ اللعن والطرد من رحمة الله؟
مفارقة أعجب قد يضعنا بها السيد الأكمل تجعلنا نعيد كتابة المشهد قبل أن يُسدل الستار بالنهاية التي لا نرغب بها..
فيقول في نهج البلاغة من ضمن سلسلة كلماته القصار بحروفها والعظيمة بمضمونها والتي لو أدركنا معانيها وعملنَّا بها لحظينا بالعيشة الراضية تلك التي لا تعرف للضنكَ سبيل:
"أوضَعُ العِلمِ ما وُقِفَ على اللَّسانِ وأَرفَعُهُ ما ظَهَر في الجوارح والأركان"..
منظومة أخلاقية يضعها المولى بين أيدينا، معالجة لكافة المشاكل التي من الممكن أن تجتاح مجتمعاتنا وتُطيح بها في مستنقعات التخلّف والجهل..
العلم يُزين صاحبه، يرقى به نحو مدارج الكمال المعرفي، يمنحه وسام الخلود حين تُفنى الأجساد والرسوم، ولكن هل من الممكن لهذا العلم أن ينزل بصاحبه الى منازل الوضاعة؟.
حين نستقرأ الحديث لنجيب على سؤالنا نجد أن الفئة المُستهدفة منه هي فئة أهل العلم إذ أنه لا يُخاطب من لا علم له، ثم يرجع لـيُقسم العلم الى قسمين:
الأول: من ينزل بصاحبه منزل الوضاعة، وهو أدنى مرتبة قد يصلها طالب العلم، حين لا يملك من علمه إلا الأسم!.
الثاني: من يرفعه علمه نحو منازل المعرفة الوقادة فتظهر على أركان البدن والروح..
متى يمكن أن يُسلب من العلم جوهره؟ ويكون صاحبه كـ من يلهثُ وراء سراب؟
يحذر المولى العلي من مطب تكمن خطورته في إنه قد يتلبس بـ لباس الحق وبالتالي قد يسلب صاحبه المنزلة الرفيعة ويحط به نحو الأسفل، فـ يقول أن هناك حاكماً أعلى سُلطة من العلم، يخضع له بل يعتبر هو المقياس في اذا ما كان هذا علماً وضيعاً أم رفيعاً، وبالتالي فإنه يزيل الشبهة التي صار البعض يتغنى بها ويتأخذها حُجة يتخفى وراءها حين يقول حسبكم إني صاحبُ علمٍ وهذا يكفي، بل يشفعُ لي كل رذيلة تتعلقُ بأذيالي..
فالعلم بما له من الأفضلية والشأن الرفيع إلا أنه قد يتجرد من كل هذا الشأن ويصبح عديم القيمة؟ متى؟
إذا ما إقتصر هذا العلم على جارحة اللسان دون أن يملك السلطة التي تجعل صاحبه يخضع له فيتزين به قولاً وفعلاً، بل يصبح أسيراً لأهواء صاحبه، يتكسَّب به، ينال الوجاهة ولكن لا يرقى ليكون ذا تأثير عليه وهذا هو أوضع العلم إذ إنه لا يتجاوز مرحلة الظاهر، ينادي به صاحبه باللسان ويكونُ غائباً بالأفعال والأركان..
ولكن يبقى السؤال لماذا لم يقل المولى عنه جهلاً؟ او ينعته بأي صفة أُخرى؟ لماذا نَّزل بـ العلم الى منزل الوضاعة؟
والسبب هُنا لأن صاحبه يكون ذا علماً حقاً، إذ إنه قد يحمل شهادة ما في مجال من مجالات الحياة وقد يبهركَ بكثرة علمه ومعلوماته ولكن حتى تضعه بمجهر السلوكيات والأخلاق ترى إنه لا يحمل من علمه هذا سوى الأسم، كـ صاحب الصوت الجميل في ترتيل القُرآن والقُرآن يلعنه!.
فمن مُقتضيات العقل أن يكون حامل الشيء مُؤمنُ به، عاملُ به، يُجلله من حُلله!
فما فائدة العلم إن لم يُقترن بالأخلاق والعمل؟
لا يكون مسلوب القيمة فقط بل يعودُ عليه بـ السَلب وينزلُ به نحو منازل الوضاعة!
إما اذا ما خضَّع هذا الطالب لعلمه فظهرت عليه علامات الخضوع، وتلبّست جوارحه وأركانه بهذا العلم حتى صار صورة معكوسة له، حينها فقط سوى يرتفع ويرتفع حتى يبلغ معارج النور المعرفي..
فحين يُعجن هذا العلم مع الأخلاق تظهر آثاره على سيماء حامله وبهذا تتحقق المعرفة التي قال فيها ابو الحسن صلوات الله عليه، إننا في كل حركة نحتاج الى معرفة لماذا؟
لأنه متى ما تحققت المعرفة بكوامن هذا الطالب أدرك حقيقة العلم وجعلها تنحدر على أركانه وجوارحه فيكون العلم بذلك هو المقياس الذي على أساسه تُوزن الأمور..
قد نحملُ الكثيرُ من الشهادات البراقة والمُسميات الكبيرة والنظريات المعرفية، وقد نفني سنوات طوال من أعمارنا نطلبُ العلم ولكن إن لم يخترق كوامن ذاتنا وتُحطم فينا الأنا الجاهلة، التبريرية والمتكاسلة المغرورة لن نكن سوى لساناً ينقرُ علماً ويُحطم فعلاً..








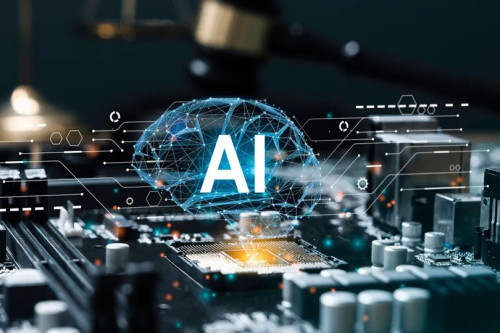
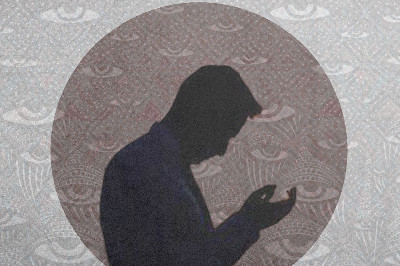



اضافةتعليق
التعليقات