يعير عن الفكرة المحورية بأنها رؤيةً مشتركة في ذهن مجموعة من الناس تنتج تآلفا وانسجاما بينهم، وينبثق عنها كيان موحد يتسع ويكبر بقدر فاعلية هذه الفكرة وسعة انتشارها، وقد تتمثل الفكرة المحورية بمفهوم وحدة الدم والنسب، كما هو الحال في التشكيلات ذات الطبيعة القبلية، والمجتمعات التي تنتمي إلى سُلالةٍ معينةٍ كالجنس الآري، أو لغة واحدة كالعرب والإنجليز؛ وقد تتمثل بوحدة الأرض التي يعيشون عليها - والمعبّر عنها بالوطن - أو وحدة المعتقد (الدين أو الطائفة)، أو وحدة الرؤية الفلسفيّة أو الاقتصادية أو السياسية، أو وحدة المهنة التي يتشكل عنها النقابات والجمعيات، أو وحدة الهدف والبرنامج كما في الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، أو وحدة الأسرة (الزوجية) وغير ذلك، فإنّ أي تجمع لا يمكن أن يتحقق ويحصل التآلف بين أفراده ما لم تكن لديه رؤية مشتركة يؤمن بمحوريتها ويلتزم بلوازمها، فتكون هي معيار الانسجام أو الاصطدام.
وكلما كانت الفكرة المحورية حيّة في أذهان الناس متجذرة في نفوسهم، ازداد تماسكهم واشتد ترابطهم وتآلفهم، نظامهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وازدهار حياتهم. فينتعش أمنهم الاجتماعي، وتضمحل روح الجريمة في فاعلية وظهورًا تمثل خلايا نائمةً في ذهنية الفرد والمجتمع ، وتنحسر العداوات بين أفراده ممّا يستتبع استقرار، ووجود الفكرة المحورية في أذهان الناس لا يعني خلوّ أذهانهم من أفكار أخرى، فثمة أفكار كامنة وخاملة أو أقل فرصة النهوض والانقضاض عليها والحلول محلها. وهذه الأفكار متى ما نشطت في ظروف خاصة بتأثر أو تأثير وتشكل تهديدًا مستمرا لمصير الفكرة المحورية وتنتظر عوامل داخليّةٍ أو خارجيّةٍ تشتدّ فاعليتها وتفرض وجودها بالتغير التدريجي إزاء الفكرة المحورية لتتحوّل عنها إلى حاكميتها على سائر الأفكار الأخرى، فتأخذ قناعات الناس الفكرة الجديدة فتكتسب الفكرة الجديدة صفة الأولوية بسبب المتغيرات والمعطيات؛ لتحتل موقع المعيارية للألفة والانسجام أو الفرقة والاصطدام، وعندها تصبح سببًا لحصول تغيّراتٍ اجتماعيّةٍ أو تحوّلاتٍ ديموغرافيةٍ جديدةٍ.
تؤدي إلى ازدياد أو نقصان في عديد الأفراد المتمحورين حول هذه الفكرة، فنكون أمام مجتمعات أضعف أو أقوى من الحالة السابقة ولذلك فإن تبدّل الفكرة المحورية ليس أمرًا سلبيًّا دائما، بل قد يكون إيجابيًا إذا انطلق المجتمع منها إلى فكرة واقعيّةٍ وساميةٍ فيها صلاحه وتقدّمه وسعادته، وهذا ما يسعى إليه المصلحون والحكماء كافةً، قال تعالى: (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةٌ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ...)، فالناس كانوا على فكرة مركزية ومحورية تجعلهم أمةً واحدة، غير أنّها فكرةً تدعو إلى الشر والباطل والفسق والفجور وامتهان كرامة الإنسان واحتقار القيم الإنسانية، وبالتالي فإنها تدعو إلى التسافل البشري وتدنّيه إلى مستوى البهيمية أو ما هو أدنى، فبعث الله الأنبياء مبشرين ومنذرين، مبشرين بفكرة محورية جديدة متسامية ومنذرين من سالفةٍ متسافلةٍ، فهم يستبدلون تلك الفكرة الوهميّة ويزيلون ركام الثقافات الفاسدة، وينفضون الغبار عن الفكرة المحورية الواقعية المنسجمة مع الفطرة البشرية، قال تعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا)، وقد أنذر الأنبياء وحذروا الخطر العظيم الناس من عواقب ما هم عليه، ومن ينتظرهم، فانتزعوا منهم أمةً مؤمنة تدعو إلى الخير والصلاح، قال تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
هذه الأمّة تتمحور حول فكرة الربّ الواحد الذي ينبغي للمجتمع الاتصال به وأخذ قوانينهم العمليّة منه؛ لأنّه هو خالقهم وهو أعلم بما يحتاجون في سبيل تكاملهم؛ وبسبب هذا الأمر حصل الصراع الحقيقي بين أمة الخير وأمة الشر، وسوف يستمر هذا الصراع حتّى يرث الله الأرض ومن عليها.
ثم أن الفكرة المحورية قد تكون إيجابية وواقعية غير أنها تفتقر للجاذبية والزخم الذي يحمل الناس للتمحور حولها، الأمر الذي يجعلها فاقدةً عنصر الاستقطاب الذي تستحقه؛ لأنها - وإن حظيت بقوّةٍ من جهة واقعيتها - بيد أنّها ستتقزم أمام أفكار وهميّة ذات قدرة استقطابية عالية.
والفكرة التي تستحق أن تتصدر الأفكار ويكون لها المحورية هي التي تتوفّر على مقومات وإيجابيات كيفية وكميّةٍ معا، بمعنى أنها واقعيةً وتحتوي على زخم وجاذبيّة تستقطب خلاهما كما جماهيريًا يؤهلها لأن تتصدّر المحورية في أذهان الناس، وينشأ في ضوئها كيان المجتمع. وهذه الفكرة هي التي تكون أكثر صمودا أمام التهديدات والتحديات الداخلية والخارجيّة، وأكبر مقاومةً لثنائية الأفكار الخاملة، كما أنّها تمتلك قدرة الوقوف أمام السجالات الفكرية المختلفة.
ويتضح أن الجانب الفكري للإنسان هو مبدأ كل التحولات الاجتماعية، وإن دخلت عوامل أخرى بعد كالشعور والإرادة، فالثورة على الظلم والفساد من أجل الارتقاء نحو القيم الفاضلة والمبادئ السامية، وتستمر هذه التحولات إلى أن يصل المجتمع إلى فكرة محورية واقعية منسجمة مع متطلباته الإنسانية وتكون منطلقا لتشييد حضارته.
وبطبيعة الحال فإن سعة الفكرة المحورية أو ضيقها وكذلك واقعيّتها أو عدم واقعيّتها سيؤثر تأثيرًا طرديا من الناحية الكمّيّة والكيفيّة على أفراد الجماعة والكيان الذي يتمحور حولها، فالفكرة الواقعية سوف تخلق لنا مجتمعًا واعيًا يتعامل على أساس نظام واقعي وبمعايير منطقيّة، ولا يسمح لنفسه أن يستغل ولا أن ينقاد إلا لمن يستحق ذلك النظام الواقعي وهذا هو المجتمع الآمن فكريًا.
وأمّا الفكرة الخرافية فإنّها لا تنتج لنا إلا مجتمعًا خرافيًا فوضويا يتفشى فيه الجهل والفساد ويسهل استغلاله من قبل المدجّلين والمشعوذين والظلمة والمستبدين والمفسدين وهذا هو المجتمع المخترق فكريا، ثمّ إنّ الفكرة المحورية كلما كانت قويةً وثابتةً وحيةً وراسخةً في عقول الناس كانت أكثر صمودًا ومقاومةً للتحدّيات، وكان ذلك أدوم وأبقى لوحدة الجماعة ولتحقق الأهداف المجتمعية ؛ وكلّما كانت هشةً هزيلةً، كانت في معرض التبدّد والاضمحلال والتلاشي المستتبع للتغيير المعادلات المجتمعية والكيان العام.
إذن النظام المجتمعي والكيان العام الذي ينضوي تحته مجموعة من الأفراد يكون مصيره مرهونا بالفكرة المحورية، وقد أشارت لذلك جملة من النصوص الدينية، منها قوله تعالى: (إنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ). فالفكرة المحورية التي تشير إليها الآية، والتي ينبغي أن تتمحور الأمة حولها وتتوحد، هي رؤية فلسفية دينيّةً تثبت أنّ الله ربُّ لهذا الوجود، وقوله تعالى: "فاعبدون" إشارة إلى ما يتفرع عن هذه الرؤية الفلسفية من جانب عملي سلوكي يعزّز هذه الرؤية، ويحقق أهدافها في انتشار هذه الفكرة وارتكازها في ذهنيّة المسلمين هي التي تجعل منهم أمّةً واحدةً منسجمة ومستقرةً، فوحدة أمتنا متوقفة على إيماننا بفكرة وحدة الربّ المستتبعة للعبادة التي هي عبارة عن التسليم بجملة من النظم والأحكام التي يجب على الأفراد إجراء سلوكياتهم طبقها.










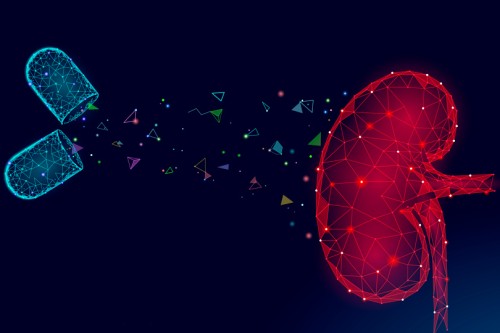


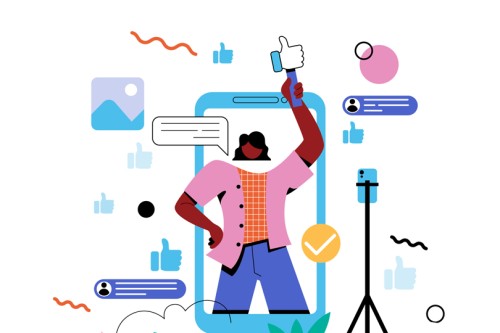


اضافةتعليق
التعليقات