كان النهر ممتدًّا عابرًا يتلوّى كحيّة أفعوانيّة استطاعت أن تُحصي جحافل البؤس والألم المحتشدة في بيوت المدينة، ما يزال الغوص في عمقه يغسل عن وجودي تراكمات الزمن الموحش ويُثير في كوامني شغف الحركةِ بانسيابيّة سمكة شبّوط محترفة، كثيرة هي اللحظاتُ التي باح فيها عن آلامه الدفينة في كلّ قطرة سَئِمَتْ تكرار التبخّر والفناء، كنتُ أهمسُ في أذنه:
- لكنّكَ ماضٍ أيّها العنيدُ لا تكترثُ لشيءٍ، فيقول:
-لا تغترّ بذلك يا فتى، إنّه امتداد الضياع!
سألتُه ذات مساء هل جرّبتَ لوعة الاشتياق يومًا؟ فثار بعنف وركلني بموجة كدتُ أغرقُ على أثرها.
دخلتُ إلى المنزل قرب المساء وقد تبخّرت آخر قطرات الماء العالقة بملابسي لتمدّني بالرشفات المناسبة لقمع عطش الحياة.
فتَحَتْ أمّي الباب الحديديّ القصير متذمّرة قد عقدت حاجبيها باعتراض بادٍ على محيّاها السومريّ المليح قائلةً:
- لَم يعدْ نهر الحسينيّة كالسابق، سَرَت فيه اللوثة ككلّ الأشياء الثمينة، ألا تشبع من حكايات هذا النهر الهرم وتتحوّل عنه إلى أحواض السباحة المغناج المنتشرة مؤخّرًا في كلّ مكان؟!
ثمّ حَمَلت قارورة الماء الكبيرة وأفرَغَت آخر قطراتِها في إناء عصير الزبيب، تناهى إلى السمع صوت بائع الماء، فاستأنفت باستعجال:
- اذهب واشترِ الماء.. لا يعرفُ هذا البائع الصبر قليلًا، يتعدّانا ويذهبُ كلّما مرّ من هنا.
جريتُ خلف البائع فملأتُها وكدتُ أدخُلُ المنزل حتّى وصل ناجي بوجه النكد الذي تهرول فيه الشياطين بسبب وبدون سبب، قَفَزَتْ موجة من الاستياء إلى حنجرتي عندما لاحني بكتفه الضخم وهو يتجاوزُني داخلًا البيت، نزع حذاءه فتصاعدت رائحة الأبخرة النتنة من جوربه المخروم في إبهامه الأيمن.
جلسنا على المائدة التي أخذ يلتهمُ ما فيها بنهم فيل استوائي ضخم حتى أتى على آخر لقمة من قطعة اللحم الفريدة في الصحن، سقَطَتْ قطرة من المرق على دشداشته فزادتها اتّساخًا، حاول مسحها بمنديل ولكن اتّسعت رقعتها أكثر، قال بصوت أجشّ محدّقًا فيّ ببلاهة معهودة:
- ستأتي من الغد إلى العمل لمساعدتي، ماذا جنى المتعلّمون من دراستهم؟! ثمّ إنّكَ لو عشتَ أحمق في هذا البلد فسيسهل عليكَ هضم الأمور ولن تشعر بالأسى، لقد كبرتَ يا ولد أنتَ في الثالثة عشرة من العمر! قال ذلك وهو يكرع ما في الكأس من بقايا العصير.
حدجتْ أمّي زوجها بعصبيّة وقالت: هل سيقوى هذا الصبيّ الهزيل على نقل الطابوق في المعمل، أجُننتَ؟!
لوّح الأخير بيديه مثلما لو كان ينشّ ذبابة عن وجهه!
عندما تعالت مناوشاتُهم، اتّخذتُ جانبًا قصيًّا من الغرفة تائهًا في كهف من الأفكار المظلمة. لا أعرف لماذا تذكّرتُ غفلة مداعبة أبي ذات مساء وهو يدعوني بالدكتور (علاء)؟ فقرّرتُ أن أصبحَ طبيبًا حينها، نظَرتُ إلى صورته المتّشحة بشريط أسود، معلّقة على جدار أصفرَ قديم شرّخته السنون وسقط عنه الملاط الذي كان يغطّيه في بعض الأماكن.
- ربّما ناجي على حقّ هذه المرّة، مهنة الطبابة صعبة تحتاج مراسًا هادئًا بعيدًا كلّ البعد عن مشاهد الحرب والقتل والتهجير في بقعة قصيّة جدًّا من هنا حيث لا ألم يتراكم في الوجوه، ثمّ إنّه لا يوجد فرق كبير بين الطبّ والبناء! هذا يبني جسمًا وذاك يبني بيتًا إذ لابدّ لهذا الجسم الذي يُشفى من سكن يسكن فيه.
كانت تُراودني الأفكار المالحة متتالية عندما لمَحتُ صورة أبي وهو يشزرني بنظرة عنيفة لم أعهدها؛ شلَّتْ مفاصل مخّي تمامًا وأوقفتني عن التفكير!
استيقظتُ صباح اليوم التالي مبكّرًا، حملتُ حقيبة المدرسة وتسلّلتُ خلسة قبل استيقاظ ناجي.
كان الفصل صاخبًا يعلوه صراخ الأولاد وهم يتناقشون حول المباراة القادمة بين فريقي (إيطاليا) و(إنكلترا) بينما انشغل آخرون بالمشي بين الرحلات كآخر محاولة لممارسة الحريّة قبل دخول المعلّم، أمّا رفيقي جمال فلا يني يضرب قفاي بين الفينة والأخرى، فرحتُ أجري خلفه طافيًا كلّ الردهات وفجأة وأنا أركضُ ارتطمتُ بقوّة بالمدير السائر بكلّ وقار وجلال في الفسحة التي تنتصف الصفوف، فسقطنا أرضًا!!
فرّ جمال، وفي رعب تامّ وثبتُ ووقفتُ على قدميَّ ثمّ ركضتُ مهرولًا لا ألوي على شيء حتّى وصلتُ الفصل واختفيتُ بين المقاعد كفأر شريد، لمحتُ المدير وقد مدّ رأسه باحثًا عنّي ثمّ ابتعد بعصبيّة.
دخل معلّم اللغة العربيّة متجهّمًا عبوسًا كعادته، يضع نظّارته التي لا ينفكّ ينظر من فوقها، شيء فيه يذكّرني بوالدي، وقارُه؟ حبّه للوطن؟ أم شامته الناتئة في ذقنه؟ كان الدرس عن شعراء العصر الأمويّ، شرح قليلًا عن تلك الحقبة وقبل أن يكمل قال: هل من سؤال؟
لم يجرؤ في العادة أحد أن يسأل الأستاذ قاسم، تحتاج هذه الخطوة دومًا تفكيرًا مضاعفًا، ولكنّي رفعتُ يدي بتوجّس فنظر مرّة أخرى من فوق النظّارة، أردتُ إلغاء الفكرة والتراجع ولكن كان قد فات الأوان فقال:
- تفضّل!
قلت بنبرة لم أرغب فيها أن يسمع الرعشة التي اعترت صوتي المتهدّج:
- ل...ل...لماذا يا أستاذ علينا حفظ الشعر ما دمنا نريد أن نصبح أطبّاء؟!
جفل كلّ مَن في الصفّ وخيّم في المكان هدوء شاحب، نظر إليّ بازدراء ثمّ استأنف:
- حتّى لا يتراكم عدد الأطبّاء الذين لا يستطيعون التمييز بين الخمسة والطمسة!
تعالت ضحكات الأولاد فجلستُ خجلًا بينما راح الأستاذ يُكمل شرحه:
- من أشهر الشعراء الذي قيل عنه لولا شعره لذهبت ثلث العربيّة (الفرزدق...)
فتحتُ الكتاب على الدرس، كانت صورة الكعبة مرسومة بإتقان في وسط الصفحة لامعة برّاقة، خاطبتُ نفسي:
- يا إلهي، منذ متى قرّرَتْ وزارة التربية إضافة الصور إلى المناهج بهذه الدقّة العالية؟!
كانت صورة ثلاثيّة الأبعاد قد برزت قليلًا على غير المعهود حتّى خلتُني لمحتُ حبلًا ممتدًّا في إحدى زواياها فقلتُ:
- كفَّ عن هذا إنّها صورة فحسب، ومددتُ يدي لألمسها وإذا بالحبل قد اشتدّ حول معصمي، ساحبًا إيّاي في هالة مهولة ما ورائيّة، جَعَلتني أحتشدُ فجأة أمام الكعبة بدون مقدّمات ممسكًا بتلابيبها ألبسُ ثيابَ الإحرام وأؤدّي مناسك الحجّ! تبلوَرَتْ بجلاء لا يُدحض وتَبَدّتْ لا يشوبُها من الريب شائبة، كانت منتصبة، مكلّلة بأستارها تناطح السماء في قمّة شموخها المعهود، تعلو من حولي أصواتُ التلبية مدوّية من كلّ جانب لتُضاعفَ عنفوان الحدث وجبروت الغرابة، فجأة اشتدّ التدافع وكثُر الهمزُ واللمزُ:
- إنّه عليّ بن الحسين!
- إنّه عليّ بن الحسين!
دُفعتُ من قِبل الحشود نحو الوراء، أضاعتْ امرأةٌ طفلتَها فراحتْ تولول نادبة وهي تظنّ أنّها دُهست بين الزحام، أثار صوتُها وجيبًا ملحوظًا في دقّات قلبي وأنا أتصوّر طفلة ميتة بالدهس من قِبل آلاف من الناس بأجسادهم الضخمة مجتمعين في مكان واحد، كانت قريبة منّي أردتُ مواساتها والقول بأنّنا لم نتأكّد من ذلك ولكنّني دُفعت مرّة أخرى بشدّة كدتُ أقع على أثرها، مسكتُ بقوّة حبل الهميان الذي أوشك على الانفلات حتّى انفرَجنا بعد لحظات إلى سماطين، الجميع مطأطئ إجلالًا وكبرياءً، ما عدا تلك المسكينة التي راحت تتسلّل بين الجموع لاهثة ولهى، كنتُ أراقبُها من بعيد، تَقدّمَ الإمام في هالة مكلّلًا بالنور، يبسط طمأنينة تثير الخوالج التي قرّرت حبس الأمنيات، وقد مُدَّت تحت رجليه آلاف من أجنحة الملائكة في حضور أثيريّ طافح الضياء والتلألؤ ممسكًا بيد طفلة صغيرة قد عقصت شعرها إلى الأعلى، فانفلتت خصلة ذهبيّة عصيّة على حزمتها في جانب وجهها، هرَعَتْ المرأة نحوها وتلقّفَتْها في حضنها بعد أن أوشَكَتْ على الانهيار، نظر إليها ابن النبيّ نظرة معاتبة وقال:
- انتبهي للصغيرة يا أمة الله، من حقّها عليكِ مداراتُها!
ثمّ نظر نحوي و رمش بعينيه بطريقة وديّة، يدقّق في تجاويف روحي وقممها، كانتا لاهبتين مثل شمس حارقة!
أجفلتُ وسَرَتْ رعدة باردة أسفل عمودي الفقريّ وانتصب شعر ذراعي!
في غمرة الحدث تعالى صوت من دكّة نُصِبَتْ في الأعلى جلس عليها أميرٌ أمويٌّ يتّكئ على المسند، سأل بتهكّم وقد اعترت خدّيه بقعة حمراء، مَن هذا؟!
خَرَجتْ كلماتُه تقطرُ بالمقت والغضب لترتطم بجدران الكعبة مرتدّةً نحو التسافل المتمادي، خيّم صمتٌ يحمل توقّعات فسيحة وبعد لحظات قام من بين الجموع رجل ذو مهابة في وجهه سيماء العارفين كسر جدار الصمت المهيمن على الساحة وانبرى قائلًا:
- أنا أعرفه!
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته
و البيت يعرفه.....
و تلى قصيدة منعشة وكأنّه يغترف من غديرعذب ويصبّه في كبد حرّى.
كنتُ سارحًا في هذه المسرحيّة الملكوتيّة وإذا بصفعة على قفاي تُعيدُني إلى الواقع، همس جمال من المقعد الخلفيّ:
- هل ستبقى هائمًا كلّ الدرس؟!
لاحظ الأستاذُ الجلبة فاستدعاني إلى السبّورة لقراءة القصيدة، فتمتم جمال:
-(انلاصت) وعليّ!
اختلجَ قلبي حتّى كاد أن يقفزمن بين ضلوعي، و أخذت يداي تنزّان عرقًا باردًا مسحتُه ببنطالي ، ولكن فجأة غمرتني قوّةٌ مجهولةٌ بهيمنة بلاغيّة عجيبة بدأتُ أقرأُ على أثرها باقي أبيات القصيدة بكلّ ما أوتيتُ من حماس مارًّا بكلّ اللحظات الشفيفة التي تهيمن على المواقف عند ذكر المقدّسات، بينما كنتُ أقرأ لمحتُ المدير المتسكّع في الردهة قد توقّفَ عند الباب وراح يستمع إليَّ!
لم تكد تمرّ دقيقة واحدة حتّى اختفت فجأة من ملامحه الباردة تلك الصورة المتجهّمة، اختفت بالفجأة التي تجلّت بها، وبانت على وجهه مسحة دافئة، خيّم سكون في الصفّ اخترقه بعد ثوانٍ صوت تصفيق المدير، تلاه تصفيق المعلّم ثمّ الطلّاب، تقدّم نحوي المدير مربّتًا على كتفي وهو يسأل الأستاذ مَن هذا؟ فأجابه الآخر مبتسمًا:
- هذا الدكتور علاء!








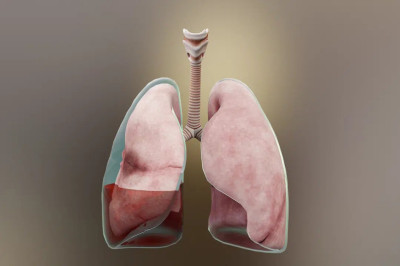





اضافةتعليق
التعليقات