بدأ المسلمون في القرن التاسع الميلادي في تطوير نظام صحي طبي يعتمد على التحليل العلمي حيث بدأ الناس يقتنعون بأهمية العلوم الصحية، واجتهد الأطباء الأوائل في إيجاد سبل العلاج.
وأفرز الإسلام في العصور الوسطى بعض أعظم الأطباء في التاريخ، الذين طوروا المستشفيات، ومارسوا الجراحة على نطاق واسع، حتى النساء مارست مهنة الطب، حتى أنه كانت هناك طبيبتان من عائلة ابن زهر خدمتا في بلاط الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب المنصور في القرن الثاني عشر الميلادي وقد ورد ذكر الطبيبات والقابلات والمرضعات في الكتابات الأدبية لتلك الفترة.
ويعد أبو بكر الرازي وابن سينا أعظم هؤلاء الأطباء، وظلت كتبهم تدرّس في المدارس الطبية الإسلامية لفترات طويلة، كما كان لهم وبالأخص ابن سينا أثرًا عظيمًا على الطب في أوروبا في العصور الوسطى.
خلال العصور سالفة الذكر، كان المسلمون يصنفون الطب أنه فرع من فروع الفلسفة الطبيعية، متأثرين بأفكار أرسطو وجالينوس، وقد عرفوا التخصص، فكان منهم أطباء العيون ويعرفون بالكحالين، إضافة إلى الجراحين والفصادين والحجامين وأطباء أمراض النساء، فالإسلام وضع خططاً حكيمة لاقتلاع جذور المرض من أطراف الدولة الإسلامية كلها ومن عامة المسلمين.
فإنا نجد في قائمة الأحاديث الشريفة المأثورة عن رسول الإسلام صلی الله عليه وآله وعن أهل بيته الأئمة الأطهار عليهم السلام المئات المئات.. بل الألوف والألوف منها مخصّصة لبيان الأمور الصحّية.
فعن مولانا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّ في القرآن آية تجمع الطب كله: (كُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ) ومن أجل ذلك قلّما يجد الإنسان ـ في ظلّ الحكم الإسلامي ـ مرضى كثيرين وأمراضاً متفشية وكانت الصحّة العامّة ترفرف بأجنحتها على الدولة الإسلامية العريضة، وكان ذلك مستمراً إلى قبل ستّين عاماً.
فالبلد الواحد ذو مائة ألف نسمة ـ مثلاً ـ كان يكفيه أطباء قليلون، وكنت ترى يومياً بعضهم بلا مراجعين، أو قليلي المراجعين يعدّون عدّاً بالأصابع.
ونحن حين لا ننكر ما للطب الحديث من التقدّم في بعض المجالات، نتساءل:
لماذا أصبح الطب اليوم ـ بما أوتي من حول وطول ـ عاجزاً عن معالجة المرضى، ومكتوف الأيدي أمام هذا العدد الهائل من الأمراض؟
ففي كل بلد يكون كبيراً، ترى المرضى يعدّون بالألوف..
والأطباء بالمئات..
والصيادلة ومخازن ومستودعات بيع الأدوية والعلاج بالمئات ولو قسنا هذه الكمية الكبيرة بعهد الإسلام وعدد المرضى فيه لكانت النسبة واحداً بالمائة، أو أقل بكثير، أليس ذلك دليلاً على رشد الإسلام في سياسته الصحّية، وفشل غير الإسلام في هذا المجال؟
فالأطباء يضاعف عددهم سنوياً بالألوف.
والمستشفيات في ازدياد.
والتجارب الصحّية في تقدم.
والمرضى ملأ الدنيا.
والأمراض طبقت البلاد.
هل هذه سياسة صحّية رشيدة؟
مقارنة
ويمكنك استطلاع هذه الحقيقة بالتحقيق عن المصحّات والمستشفيات ودور الصحّة، فإنك تجد نسبة المتدينين والملتزمين بتعاليم الإسلام الصحّية فيها أقل بكثير من غير المتدينين وغير الملتزمين بالتوجيهات الإسلامية في مجال الصحّة العامة.
وقد لا أكون مبالغاً إذا قلت: إنّ النسبة واحد في المائة.
وهذه المقارنة البسيطة تعطيك فكرة سريعة عن مكان الصحّة في الإسلام.
وليس في هذا العرض البسيط متسع من المجال لذكر الأسباب الصحية التي وضعها الإسلام لتعميم الصحّة في كل بيت، ومع كل إنسان، وإنما نرجئ ذلك إلى بحوث خاصة، فمن أراد فليلاحظ بعض ما كتب في ذلك، مثل:
(طب النبي صلی الله عليه و آله)
(طب الصادق عليه السلام)
(طب الأئمة عليهم السلام
(شرح توحيد المفضل)
وغيرها…
تقليل الدم: ولنضع هنا مثلاً يكون نموذجاً واحداً لما قلناه عن سياسة الصحة في الإسلام: فقد كان المسلمون غالباً حسب أوامر الشريعة الإسلامية المتكررة والمؤكّدة يعمدون إلى تقليل كمية الدم من كل فرد في كل عام على الأقل مرة واحدة خصوصاً في أيام الربيع حيث يهيج الدم، تبعاً لتهيج كل ما في الكون من إنسان، وحيوان، ونبات، وأجهزة، وطاقات وغيرها.
وذلك بعملية (الحجامة) أو عملية (الفصد) وقد ورد في الأحاديث الشريفة أن تقليل الدم أمان من موت الفجأة، وكذا فهو أمان من السكتة القلبية. والشلل المؤدّي إلى ذلك.
ومما ورد في ذلك حديث شريف للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام حيث قال: «الدم هو عبد وربما قتل العبد سيده».
ولكن الطبّ الحديث جاء ليمنع عن تقليل الدم منعاً باتاً وكان نتيجة ذلك ـ وغيره أيضاً ـ انتشار السكتة القلبية في طول البلاد وعرضها، ومن أقصاها إلى أقصاها.
فكانت البلاد الإسلامية تعيش ولا تعرف السكتة القلبية، ويعرف جيداً من عاش قبل نصف قرن أنّ السكتة القلبية كانت مثار عجب ودهشة إذا أصيب بها إنسان واحد وقدّ حدّثني شخص من المؤمنين: أنّه في شبابه وقعت حادثة وفاة بالسكتة القلبية في محلّة من بلده، وإذا بالناس يتراكضون إلى الميت وقد ملكهم العجب مما سمعوا ولم يكد بعضهم ليصدقه.
أما اليوم ـ وقد ربض الطب الحديث مكان الطب الإسلامي ـ فترى الموتى بالسكتة القلبية كثيراً.. وكثيراً، ولعلني لا أكون مبالغاً إذا قلت: إنّ نسبة ذلك قد تصل إلى 35%. أي، قرابة ثلث الناس يلقون حتفهم بالسكتة القلبية الناتجة عن تخثر الدم، نتيجة عدم تقليل الدم بالحجامة، أو الفصد، أو ما شابه ذلك.
كشف الخطأ
وقد انكشف للطب الحديث ـ أخيراً وبعد أن راح ضحية هذا الخطأ الملايين من البشر موتاً بالسكتة القلبية ـ خطأ هذا الرأي، وأنّ النافع للبدن والصحّي للإنسان هو تقليل الدم.
ومما نشأ عن ذلك توجيه الأطباء للناس النصيحة بتقليل الدم.
ففي إحدى إذاعات دول الغرب ذكر أحد شخصيّات الطّب الحديث في خلال بحث له أنّ:
تقليل الدم، أو التبرع بالدم أمر صحي ضروري لكل إنسان، وهذا بدوره يمنع تصلب الشرايين الذي يؤدّي غالباً إلى تخثّر الدم، الذي يمهد الطريق إلى انسداد صمام القلب، وتوقف القلب، وبالتالي (السكتة القلبية). وإنّ عملية (الحجامة) أو (المشرط) التي كان المسلمون يزاولونها هي التي تركت نسبة الموت الفجائي فيهم قليلة ضئيلة.
الحجامة: هي إخراج الدم الفاسد بواسطة الممصّ ـ آلة المصّ ـ من العروق الدقيقة، والشعيرات الدموية المبثوثة في اللحم، بما من شأنه تصفية الدّم، ممّا يساعد على تنشيط الدّورة الدمويّة، وتوجب الرشد. والفصد: هو شق الوريد بإخراج مقدارً من الدم كما هو نقياً كان أو غليظاً، وكما أنّ الحجامة تنشّط البدن فالفصد يُضعفه.
هذا بعض ما في الإسلام من السياسة الصحيحة لتعميم الصحّة على الجميع في كل مكان دول العالم توقفنا على المدهش كثيراً في هذا المجال. سواء في ذلك الدول الغربية، أو الشرقية، أو الدول النامية ـ كما يعبرون ـ.
وقد التقيت ـ أنا شخصياً ـ يذكر سماحة المرجع السيد صادق الشيرازي بطبيب خاص بعلاج (مرض السكري) في بلد صغير لا يعدو كل سكانه مليون نسمة، وكان الطبيب واحداً من عديدين يعالجون السكري، قال لي بالحرف الواحد: «إنني أعالج تسعة آلاف مريض مصاب بالسكري». هذا مع غض النظر عن ألوف الأمراض الأخرى، ومئات الأطباء الآخرين. وعلى هذه القصة الصغيرة فقس غيرها.
وليس المقصود من ذلك التنقيص من قدر الأطباء ومهمتهم الإنسانية، فإنّ فيهم المؤمنين والأخيار والملتزمين بموازين الإسلام والإنسانية، يعرفون مسؤوليتهم أمام الله، وإنما المقصود بيان ضعف السياسة الصحّية المعاصرة.





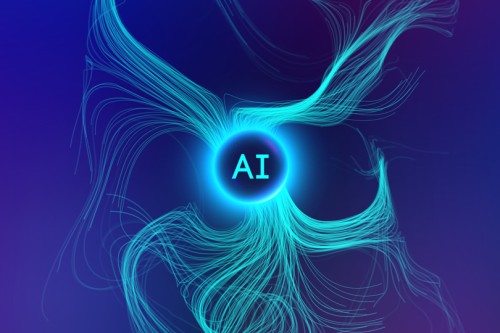








اضافةتعليق
التعليقات