لم أكن أحلم بقصرٍ منيف ولا بحياة مترفة، كان كل ما أريده مجرد أسرةٍ صغيرةٍ أستظلّ بها من برد الوحدة، بيتٍ يملؤه الدفء، وحنان أمّ، وصوت أبٍ يحمل الأمان لا الصراخ. لكنّ القدر كان يسير بي في اتجاهٍ آخر تمامًا، حتى نسيتُ شكل الدفء، ونسيتُ كيف يكون الأمان.
كانت طفولتي أشبه بظلّ عابرٍ تحت سقف لا يضمّ إلا الجدران. أبي وأمي كانا دائمَي الخلاف، أصواتهما تملأ المكان توترًا، وقلبي الصغير كان يرتجف في كل مرة أسمع فيها كلمة "طلاق". كنتُ أشعر دائمًا أنني السبب في كل ما يحدث بينهما، كما لو أن وجودي كان ذنبًا يُعاد تذكيره كل يوم.
وفي ذلك اليوم المشؤوم، خرجت أمي من البيت ولم تعد. ما زلت أذكر نظراتي المرتجفة وهي تلاحقها إلى أن غابت عن الطريق الطويل وسط الغابة الموحشة. كنتُ أتصور أن الغياب مؤقت، وأنها ستعود غدًا، لكن الأيام مضت، وصوت خطواتها لم يعد. عندها فقط أدركت معنى أن تكون الطفولة وحيدةً في عالمٍ لا يرحم.
بكيت كثيرًا، صرخت حتى بحّ صوتي، وكرهت كل من كان حولي، ليس لأنهم أذنبوا، بل لأنهم بقوا بينما أمي رحلت. وعندما التقيتُها أخيرًا، ركضت إليها كطفلةٍ غرقت في بحرٍ مظلم، ترجّيتها أن تأخذني معها، توسّلت إليها بدموعي، لكنّها رفضت. لا أعرف إن كانت تخاف عليّ، أم كانت تراني ورقة ضغطٍ في حربها مع أبي.
ثم جاء القرار المدويّ من والدي: الطلاق. لم أكن أفهم ما يعنيه، لكني كنت أشعر أن العالم كله قد انهار. ومنذ ذلك اليوم، صار كل لقاءٍ بوالدتي مناسبةً لاستعادة الألم من جديد. كلّما بدأت أتأقلم، جاءت رياح اللقاء لتعيد المواجع وتوقظ الجراح القديمة.
حتى جاء يومٌ حاسم، كنتُ فيه في الخامسة عشرة من عمري، حين قررتُ أن أختار بنفسي. لم أرد أن أكون زائرةً في حياة أحد، لا في بيت أمي ولا بيت أبي. فقلتُ له يومها: "لن أذهب إلى أمي بعد الآن." كانت تلك أول مرة أقول فيها "لا" بصوتٍ واضح. لم أكن أدرك أنني حينها كنت أخلع عني جزءًا من الطفولة، وأدخل عالم الكبار محمّلةً بخساراتٍ كثيرة.
بحثت عن العائلة في أماكن أخرى، في وجوه الناس، في صدور الأصدقاء، في نظرةٍ صادقةٍ أو حضنٍ دافئ، لكني لم أجد. وعندما تزوّج والدي من امرأة جديدة، حاولتُ أن أجد في قلبها ما افتقدته من أمي. كانت امرأة طيبة، حنونة بطريقةٍ مختلفة، تحمل من المشاعر ما لم تحمله أمي، ومع ذلك لم أشعر بالأمان. كان هناك دائمًا فراغٌ داخليّ لا يملؤه أحد.
كبرت، ووعيت أكثر، وقلت لنفسي: "ربما سأصنع عائلتي بنفسي. سأبني بيتًا فيه الحب الذي افتقدته، والدفء الذي حُرمت منه." كنت أؤمن أن الزواج سيكون خلاصًا من ماضيي، وأن زوجي سيكون الوطن الذي أفتقده.
لكنّ الصدمة كانت أكبر من الحلم. لم أجد في زواجي ما كنت أبحث عنه، بل وجدت نفسي أجرّ زوجي إلى البيت جَرًّا، لأصنع أجواء الأسرة التي لم يعرفها هو أيضًا. كنت أحاول أن أزرع الأمان بيدي، لكنّ الأرض كانت قاحلة. كلما اقتربت خطوةً، ابتعد أكثر، حتى تحوّل البيت إلى مكانٍ باردٍ لا يسكنه سوى الصمت.
وهكذا، وجدت نفسي من جديد وحيدةً في طرقاتٍ شائكة، أبحث بين الأشواك عن عائلة، عن دفءٍ أضاعه النزاع بين والدين، وضاع معه توازنُ طفلةٍ كبرت وهي تحمل جراحها.
اليوم، عندما أنظر إلى المرآة، أرى في وجهي ملامح امرأةٍ متعبةٍ من البحث، لكنها لا تزال تؤمن بشيءٍ واحد: أن العائلة ليست دائمًا دمًا، بل شعورٌ يُزرع بالصدق والاحتواء.
رسالتي ليست بكاءً على الماضي، بل صرخة من فتاةٍ كانت إحدى ضحايا التشتت الأسري. أكتبها لأقول إن الطلاق لا يُنهي الخلاف فقط، بل يُنشئ وجعًا جديدًا في قلوب الأبناء، وجعًا لا تداويه السنوات.
أكتبها لأنني أدركت متأخرًا أن الأمان لا يُبنى بالجدران، بل بالمحبة التي تغيب حين يغيب التفاهم، وأن الطفل الذي يُحرم من دفء الأسرة يظلّ طول عمره يبحث عن بيتٍ يسكنه القلب، لا العنوان.










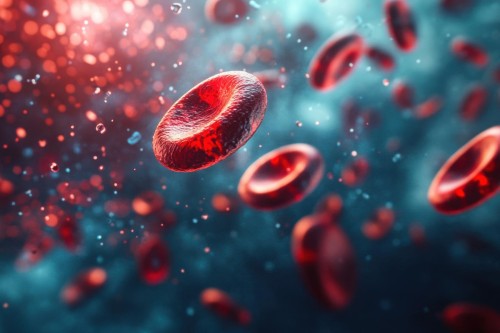





اضافةتعليق
التعليقات