كانت الحكاية تبدأ غالبًا بمحادثة بسيطة عبر الهاتف، رسالة قصيرة، أو متابعة جديدة على أحد مواقع التواصل. كلمات لطيفة، مجاملات خفيفة، ثم طلب بصورة أو مقطع، وبعدها تتحوّل الدقائق إلى فخٍّ من الخوف والتهديد. هكذا يقع بعض المراهقين والمراهقات في شباك الابتزاز الإلكتروني دون أن يشعروا. يبدأ الأمر بالثقة وينتهي بالدموع، بين ضغطٍ نفسي وصمتٍ يخنق الصوت في صدورهم، خوفًا من الفضيحة أو العقاب.
هذا النوع من الابتزاز أصبح من أخطر الظواهر التي تواجه شباب اليوم، لأنه يستهدف مشاعرهم قبل عقولهم، ويستغل فضولهم وضعف خبرتهم في التعامل مع العالم الرقمي. المبتزّ لا يحتاج إلى سلاحٍ أو مواجهة، يكفيه أن يختبئ خلف شاشة، فيتحكّم في ضحاياه بالكلمة والصورة والتهديد. أما الضحية، فيعيش صراعًا مريرًا بين الخوف والرغبة في النجاة.
لكن في خضم هذا الظلام، برز نور الأمان في مكانٍ غير متوقع، من جهةٍ لم تكتفِ بالقانون وحده، بل حملت رسالة الوعي والرحمة معًا. إنها الشرطة المجتمعية، التي أصبح حضورها اليوم في المدارس والجامعات والمراكز الشبابية مشهدًا مألوفًا وضروريًا. لم تعد جهة تلاحق الجريمة بعد وقوعها، بل تسعى إلى منعها قبل أن تبدأ، من خلال التثقيف، والحوار، وكسر حاجز الخوف بين المواطن ورجل الأمن.
في قاعات الدروس، يدخل ضباط وضابطات الشرطة المجتمعية بابتساماتٍ هادئة، لا يحملون أوراق تحقيق، بل قصصًا من الواقع. يجلسون بين الطلاب كأصدقاء، يتحدثون بلغتهم، يحكون عن مواقف حقيقية لشبابٍ وثقوا بأشخاصٍ مجهولين فدفعوا ثمن الثقة غاليًا. لكنهم أيضًا يتحدثون عن من اختاروا المواجهة، وعن الذين تجرأوا على التبليغ فأنقذوا أنفسهم وغيرهم. هذه اللقاءات تزرع في نفوس الطلبة فكرة بسيطة لكنها عظيمة: أن الصمت لا يحلّ شيئًا، وأن المساعدة موجودة دائمًا.
لقد تحوّل دور الشرطة المجتمعية إلى مظلة أمان تحمي المراهقين والمراهقات من الانزلاق في دوائر الخداع الإلكتروني. فهي لا تمثل فقط سلطة القانون، بل سلطة الوعي أيضًا. وجودها بين الطلبة يُعيد الثقة، ويُشعرهم بأن القانون ليس بعيدًا عنهم، بل يقف إلى جانبهم بكل رحمة وإنسانية. كثيرون ممن ظنوا أن مشكلتهم مستعصية، وجدوا في تلك اللقاءات فرصة للخلاص، حين علموا أن هناك من يسمعهم بسرّية تامة ويقف إلى جانبهم دون حكمٍ أو لوم.
الابتزاز الإلكتروني لا يُواجه بالخوف، بل بالمعرفة. فكل معلومة وصورة تُرسل، قد تبقى في ذاكرة الإنترنت إلى الأبد، وكل تهاونٍ بسيط قد يفتح بابًا يصعب إغلاقه. لهذا أصبح من الضروري أن تُرافق التربية الرقمية أبناءنا في كل مرحلة عمرية، وأن يتعلموا منذ الصغر أن الأمان لا يصنعه الهاتف، بل الوعي في استخدامه.
لقد أثبتت الشرطة المجتمعية في هذه المرحلة من تاريخها أنها ليست جهازًا تقليديًا، بل شريكًا في بناء جيلٍ واعٍ ومسؤول. انتشارها الفاعل، وزياراتها المستمرة إلى المدارس، جعلت منها صوتًا للتوعية قبل أن تكون يدًا للعقاب. فهي اليوم تُعلّم أكثر مما تُحذّر، وتُحاور أكثر مما تُحقق، وتُذكّر الجميع بأن الأمن ليس خوفًا من القانون، بل ثقةً به.
في نهاية المطاف، التكنولوجيا ليست عدوًا، بل مرآةٌ تعكس وعي مستخدمها. من يتعامل معها بعقلٍ ناضج يجعلها وسيلة للعلم والتطور، ومن يستهين بها قد يجد نفسه أسيرًا لشخصٍ لا يعرفه. وهنا، يبرز الدور الإنساني للشرطة المجتمعية التي تقول لشبابنا:
“نحن هنا لنحميكم، لا لنحاسبكم.”
إن الوعي هو السلاح الأقوى في مواجهة الابتزاز الإلكتروني، والشرطة المجتمعية هي الدرع الذي يسبق الخطر، تزرع الثقة وتمنح الأمان، لتبقى المراهقة مساحة نقية من الخوف، ولتبقى شاشاتنا وسيلة تواصلٍ لا وسيلة تهديد.










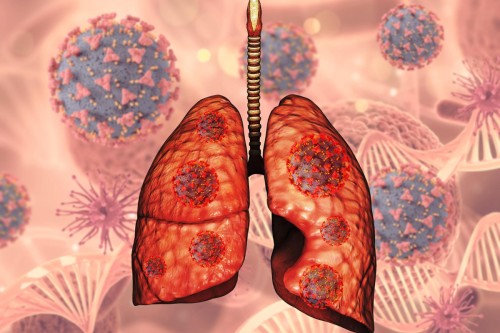


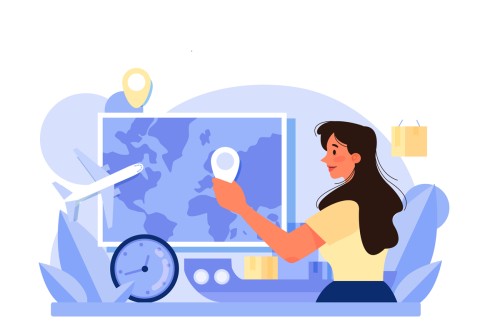


اضافةتعليق
التعليقات