إن لم تنتج السعادة عن المواد الكيميائية، فمن أين تأتي داخل المخ؟ هل توجد منطقة محددة داخل المخ تعمل على السعادة؟ مساحة ما تأخذ معلومات من أجزاء أخرى عما نمر به، وتقيمها، فتدرك أنها ينبغي أن تجعلنا سعداء، لذا تجعلنا نشعر بتلك الحالة العاطفية المنشودة؟ إن كانت المواد الكيميائية هي الوقود، هل من الممكن أن تكون هذه المنطقة هي المحرك؟ هذا مُحتمل بالطبع، لكن ينبغي لنا أن نكون حذرين قبل الوصول إلى أي استنتاجات، وهنا السبب.
بينما أكتب هذا في منتصف العام (2017) وهو وقت جيد لتكون عالم أعصاب، أصبح العلم المختص بالمخ وكيفية عمله شائعًا بكثرة، في ظل الإعلان عن مشاريع جيدة التمويل تتعلق بالمخ داخل الولايات المتحدة وأوروبا، ووجود عدد لا حصر له من الكتب والمقالات تبحث في كيفية عمل المخ، وقصص إخبارية منتظمة عن آخر اكتشاف أو تقدم علمي متعلق بالمخ، وهكذا، إنه لوقت مثير ومربح لعلم الأعصاب بالطبع.
لكن ثمة جانبًا سلبيا لهذه الشعبية السائدة. على سبيل المثال، إن كنت تود نشر شيء في جريدة ينبغي أن يكون ذلك مفهومًا بالنسبة إلى القراء الذين لن تكون الغالبية العظمى منهم علماء متمرسين. لذا يحتاج الأمر إلى تبسيط وتجريد من المصطلحات المتخصصة. ينبغي أيضًا أن يكون مقتضبا، وهذا أكثر صحة حاليًا من أي وقت مضى في ظل إعلام شديد التنافسية والسعي وراء الاهتمام والرغبة في تحقيق سبق صحفي. إن قرأت أي منشورات علمية من قبل، فأنت تعلم أن معظم العلماء لا يكتبون بهذه الطريقة، لذا فإن ترجمة تقارير تقنية مبهمة عن تجارب محكمة الإعداد إلى نسخة سهلة الفهم، يعني القيام بالكثير من التعديلات.
إن كنت على قدر كاف من الحظ، فسيقوم صحافي علوم مدرب بهذه العملية، أو محاور ذو خبرة؛ شخص يفهم متطلبات المنصات العامة، لكنه يفهم المعلومات جيدا بما فيه الكفاية ليعلم ما هو مهم وما يمكن حذفه من باب التوضيح لسوء الحظ في كثير من الأحيان، لا يكون الشخص كذلك. قد يكون صحافيًا أقل خبرة أو غير مؤهل بجريدة ما، أو حتى متدرب أو يكون القسم الصحفي بالجامعة أو المعهد القائم بالبحث، يرغب في القيام بالدعاية لأعمالهم ومجهوداتهم.
أيا كان من هو، سيقوم أحيانًا بالتغيير أو الحذف الذي يحرّف أو حتى يُسيء تفسير القصة الحقيقية. عندما تضع في الاعتبار العوامل الأخرى التي تشوه المعلومات الفعلية المبالغة لجذب الانتباه، أو التأكيد على قضية واحدة بعينها من قبل جريدة معينة ذات أيدولوجية محددة ترغب في الترويج لها، وما إلى ذلك لن تتفاجأ بأن العديد من القصص العلمية التي تراها في الأخبار بعيدة كل البعد عن التجارب الفعلية، قد تؤدي تلك التشوهات مع شيء كعلم الأعصاب، وهو موضوع يحظى بكثير من التغطية والاهتمام، لكن العلم الذي يقوم عليه لا يزال غير منظم وجديدًا ويُساء فهمه إلى أفكار واسعة الانتشار ومبسطة بشكل مبالغ فيه، عن كيفية عمل المخ.
واحدة من هذه الأفكار التي تستمر في الظهور، هي فكرة أن كل شيء يقوم به المخ له «منطقة» أو «مساحة» أو «مركز» مُحدد نرى قصصًا عن المناطق المسؤولة في المخ عن الميول التصويتية، أو الدين، أو الحماس لمنتجات شركة «أبل»، أو الأحلام الواعية، أو الاستخدام المفرط لفيسبوك رأيت كل ذلك في مطبوعات، فكرة أن المخ عبارة عن كتلة نمطية تتكون من مكونات متفرقة بشكل محدد وواضح، كل منها له وظيفة مخصصة (مثل خزانة من أيكيا لكنها أقل إرباكا) هي الأكثر انتشارًا لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا من ذلك.
يبلغ عمر النظرية التي تقول بأن أجزاء محددة من المخ هي المسؤولة عن وظائف محددة قرونا من الزمن، كما أن لها تاريخا مزعجًا للغاية. تأمل ممارسة علم الفراسة، نظرية أن شكل الجمجمة يمكن استخدامه لدراسة السمات الشخصية للفرد وهذا المنطق سطحي ومباشر للغاية.
يدعي علم الفراسة أن المخ مجموعة من مساحات التفكير المتخصصة، تعمل كلها معًا كل فكرة أو فعل أو صفة لها مكان معين في المخ، وهي مثل العضلات؛ كلما استعملت منطقة، كبرت وصارت أقوى فعلى سبيل المثال، إن كنت أذكى سيكون لديك منطقة أكبر تعالج الذكاء.
رغم ذلك، عندما كنا صغارًا كانت جماجمنا لا تزال مرنة، ثم ازدادت صلابة بالتدريج مع تقدمنا في السن، ووفقًا لعلماء الفراسة هذا يعني أن شكل أمخاخنا يؤثر على شكل جماجمنا، وأن مساحات عقلية أكبر أو أصغر ينتج عنها تحاديب أو انخفاضات في الجمجمة وهم يؤمنون أن بتقييمها يمكن تحديد نوع المخ ومن ثم قدرات وشخصية الفرد فشخص ذو جبهة أكثر انحدارًا سيكون أقل ذكاءً، ويفتقر شخص ما ذو تحاديب أقل وضوحًا في الجزء الخلفي من الجمجمة إلى القدرات الفنية، وأشياء من هذا القبيل. يبدو الأمر بسيطًا المشكلة الوحيدة الحقيقية في هذا المنهج هو أنه ابتكر في بدايات القرن التاسع عشر، في وقت كان فيه العثور على أدلة قوية وشاملة لدعم مزاعمك، أقرب لاستحسان لفكرة ما من كونه قائمًا على ممارسة ممنهجة علم الفراسة غير منطقي على الإطلاق.
قد تكون الجمجمة أكثر ليونة لدى الصغار لكنها لا تزال تتكون من عدة طبقات من عظم كثيف ومتين نسبيا، تطوّر لحماية المخ من المخاطر الخارجية. وهذا لا يأخذ حتى في الاعتبار السوائل والأغشية التي تحيط بالمخ أيضا.
إن فكرة اختلافات طفيفة في حجم بعض مناطق المخ الذي يتكون من مادة إسفنجية رمادية من الممكن أن تسبب تشوهات يمكن قياسها في جماجمنا المتينة، والتي يقابلها سمات شخصية معينة على نحو موثوق لكل فرد، هي فكرة مثيرة للسخرية من حسن الحظ أنه حتى في ذلك الوقت كان علم الفراسة علمًا بديلًا بوضوح، وفقد مصداقيته بالتدريج وأصبح غير رائج من الجيد أيضا أنه كان عادةً يُستعمل بطرق بغيضة لإثبات أن أصحاب البشرة البيضاء هم أفضل من أي عرق آخر، أو أن النساء أدنى على المستوى الذهني عادةً ما تكون لديهن جماجم أصغر، صاحب ذلك افتقار في القبول العلمي السائد، مما أعطى علم الفراسة سمعة بغيضة للغاية.
إحدى عواقب علم الفراسة الأقل وضوحًا لكنها لا تزال سلبية إنه جعل بعض علماء الأعصاب المعاصرين يقفون ضد نظرية نمطية المخ؛ فكرة أن المخ لديه أجزاء محددة للقيام بأشياء محددة وبعض العلماء يزعمون أن المخ أكثر تجانسا؛ تكوينه غير قابل للتفرقة إذا كل جزء من المخ مشارك في كل وظيفة، هل تفعل بعض الأجزاء بعض الأشياء؟ هذا يبدو مثل علم الفراسة، لذا أي نظرية أشارت إلى ذلك قد غامرت بمقابلتها بالتهكم.
هذا مؤسف، لأننا نعلم بالتأكيد أن المخ لديه مناطق محددة لأداء وظائف محددة، إلا أن هذه المناطق موجودة لوظائف أكثر جوهرية من السمات الشخصية، ومن المؤكد أنها لا تكتشف عن طريق تحاديب في الجمجمة.
على سبيل المثال، الحُصَين في الفص الصدغي، وهو معروف على نطاق واسع بأنه ضروري للتشفير ووضع الذكريات، والتلفيف المِغْزَلِيّ يُعتقد أنه مسؤول عن معرفة الوجوه، منطقة بروكا، وهي مساحة معقدة ومتنوعة في الفص الجبهي مسؤولة عن الكلام، والقشرة الحركية في الجزء الخلفي من الفص الجبهي التي تُشرف على السيطرة الواعية على الحركة. والقائمة تطول، كل العمليات الأساسية كالتذكَّر، والرؤية، والتكلم، والتحرك. لكن بالرجوع إلى النقطة المركزية، هل من الممكن وجود مساحة بالمخ تكون مسؤولة عن شيء مجرّد كالسعادة؟ أم هي مثل علم الفراسة في الماضي والتشويه الإعلامي السائد في الحاضر، وهو إفراط في التبسيط لتكوين المخ بلغ حدا غير منطقي؟
تشير بعض الأدلة إلى أن تخصيص مساحة معينة من المخ للسعادة ليس بهذه السخافة. يبدو أن عددًا من المساحات يتعامل مع عواطف محددة. على سبيل المثال، اللوزة الدماغية هي منطقة صغيرة بجوار الحصين ضرورية لإعطاء الذكريات سياقًا عاطفيًا في الأساس، إن كان لديك ذكرى عن شيء أفزعك فإن اللوزة الدماغية هي من أضافت الخوف إلى هذه الذكرى. لا تبدو حيوانات المختبر دون اللوزة الدماغية قادرة على تذكر أنها ينبغي أن تكون خائفة من أشياء معينة.
إن القشرة الجزيرية هي مثال آخر، وهي موجودة داخل المخ بعمق بين الفص الجبهي، والجداري، والصدغي إحدى الوظائف المنسوبة إلى القشرة الجزيرية هي معالجة الإحساس بالاشمئزاز؛ فهي تُظهر نشاطا كرد الفعل على الروائح الكريهة، أو رؤية البتر، أو شيء كريه بشكل عميق بالطريقة نفسها، ويُعتقد أنها تكون أكثر نشاطًا حين تلاحظ تعبير الاشمئزاز على وجه أحدهم، أو حتى حين تتخيل شيئًا يدعو للاشمئزاز. إذا، يوجد جزآن من المخ يقومان بمعالجة ما قد يعتبره الكثيرون شعورًا أو عاطفة، تماما كالسعادة هل توجد منطقة بعينها مسؤولة عن السعادة؟
أحد المرشحين تم ذكره سلفًا وهو مسار المكافأة الوسطي الطرفي الموجود بالمخ الأوسط منطقة أكثر عمقًا ورسوخًا داخل المخ عند الجذع وهو مسؤول عن تزويدنا بإحساس المكافأة الذي نمر به حين نفعل شيئًا ممتعًا. عندما يتعلق الأمر بالسعادة على عكس اللذة تشير بعض الدراسات إلى أن الجسم المُخَطَّط البطني يجب أن يكون نشطا من أجل سعادة دائمة وتشير دراسات أخرى إلى أن القشرة الجبهية الأمامية اليُسرى يزداد نشاطها عند الشعور بالسعادة، فمنذ البداية، بحث كبار العلماء عن ذلك الجزء من المخ الذي يصنع السعادة، وفي كل مرة كانوا يجدون إجابة مختلفة.
هذا ليس بالأمر الغريب فيما يبدو؛ فالمخ مكان معقد بشكل لا يُصدّق، وأساليب دراسته بطريقة مفصلة هكذا ما زالت من الجانب العلمي - حديثة نسبيا.
فكرة استخدام مناهج تحليلية صارمة وتكنولوجيا متقدمة لدراسة حالات عاطفية غير مادية هي بالأحرى لا تزال أحدث هذا يعني أن الطريقة الأفضل أو الصحيحة ولعزل السعادة لا تزال في مرحلة تنظيم الأفكار، لذا توقع وجود بعض التخبط أو التضارب في تلك المرحلة إنه ليس خطأ العلماء على أي حال حسنًا، ليس خطأهم في الأغلب، لأن هناك العديد من المشكلات التي تربك الحسابات أكثرها وضوحًا هو المنهج المتبع من قبل الباحثين لمحاولة جعل الشخص الخاضع لبحثهم سعيدًا، يستعمل بعض أسئلة وتوجيهات تستحث ذكريات سعيدة، ويستخدم آخرون صورًا محببة، وبعض آخر يستخدم رسائل ومهامًا تستثير حالة مزاجية سعيدة، وهكذا. الجميع سيحاول تخمين إلى أي مدى بالضبط سيجعل هذا المؤثر الشخص الخاضع للاختبار سعيدًا، وهو بلا شك يتفاوت بشكل ملحوظ من شخص إلى آخر وعلى رأس قائمة الاختلافات، تعتمد التجارب عادةً على تعبير الشخص الخاضع للتجربة عن مدى سعادته، هذا يجعل الأمر أكثر إرباكا.
إنها مشكلة تواجه تجارب علم النفس التي تأمل في تحليل ما يفعله البشر في سياقات محددة تحت ظروف المختبر. حقيقة أنك بداخل مختبر وتُجرى عليك تجربة ليس بالموقف الطبيعي بالنسبة إلى معظم الناس، لذا يميلون لأن يكونوا مرتبكين قليلا أو ربما خائفين من الموقف. هذا يعني أنهم على الأرجح سيفعلون ما يُطلب منهم من قبل أقرب شخص مسؤول، وهذا سيكون الباحث دائمًا، وسينتهي الأمر بالشخص الخاضع للتجربة بإخبار الباحثين بغير وعي منه ما يعتقد أنهم يودون سماعه بدلًا مما يود الباحث حقيقة أن يسمعه أدق وصف ممكن في تلك الحالة، ودائما ما توجد احتمالية أن الشخص الخاضع للتجربة سيحاول المساعدة، عن طريق المبالغة أو التعديل في وصفه لما يشعر به بالفعل، مثلا: تلك التجربة عن السعادة، إذا إن لم أقل إنني سعيد سأفسد الأمر برمته.
رغم النوايا الحسنة، يُنتج ذلك نتائج عكسية مع كل هذه الاعتبارات، من الواضح أن البحث عن السعادة داخل مخ شخص ما محفوف بالمخاطر. يمكننا القيام بالأمر رغم ذلك، إن حصلنا بطريقة ما خاضع للاختبار تكون بيئة المختبر مألوفة لديه تماما، أو لا يكون خائفًا بسبب الباحثين وأدواتهم غريبة الشكل، أو لديه علم كاف ليجعله دقيقا في تعبيره عن حقيقة حالته الداخلية، أو يمكنه القيام بتجربته الذاتية وتحليل بياناته بنفسه.
وها هو ذا الحل. لم أكن سأطلب من الأستاذ تشيمبرز إن كان يمكنني استخدام جهاز التصوير بتقنية الرنين المغناطيسي الخاص به فحسب بل طلبت منه أن أكون أنا الشخص الخاضع للكشف. يبدو الأمر منطقيا تمامًا؛ سأعلم إن كنت سعيدًا أم لا، وستكون احتمالية تأثير الموقف علي أقل بكثير، مما يجعل القراءات صالحة ومفيدة حقًا.
لذا، كل ما احتجت لفعله هو الانزلاق إلى جهاز مسح ضوئي، وتشغيله، وجعل نفسي في حالة سعيدة، ثم النظر إلى البيانات الصادرة بالطبع، بمجرد أن خطرت لي تلك الفكرة أصبت على الفور بقلق من كون الأمر غريبًا بدرجة واضحة ومضحكة. لحسن حظي، حتى نظرة خاطفة على الجسم الخاضع للبحث بخصوص السعادة، تظهر بكل تأكيد أن الأمر غالبًا سيكون غريبًا للغاية.




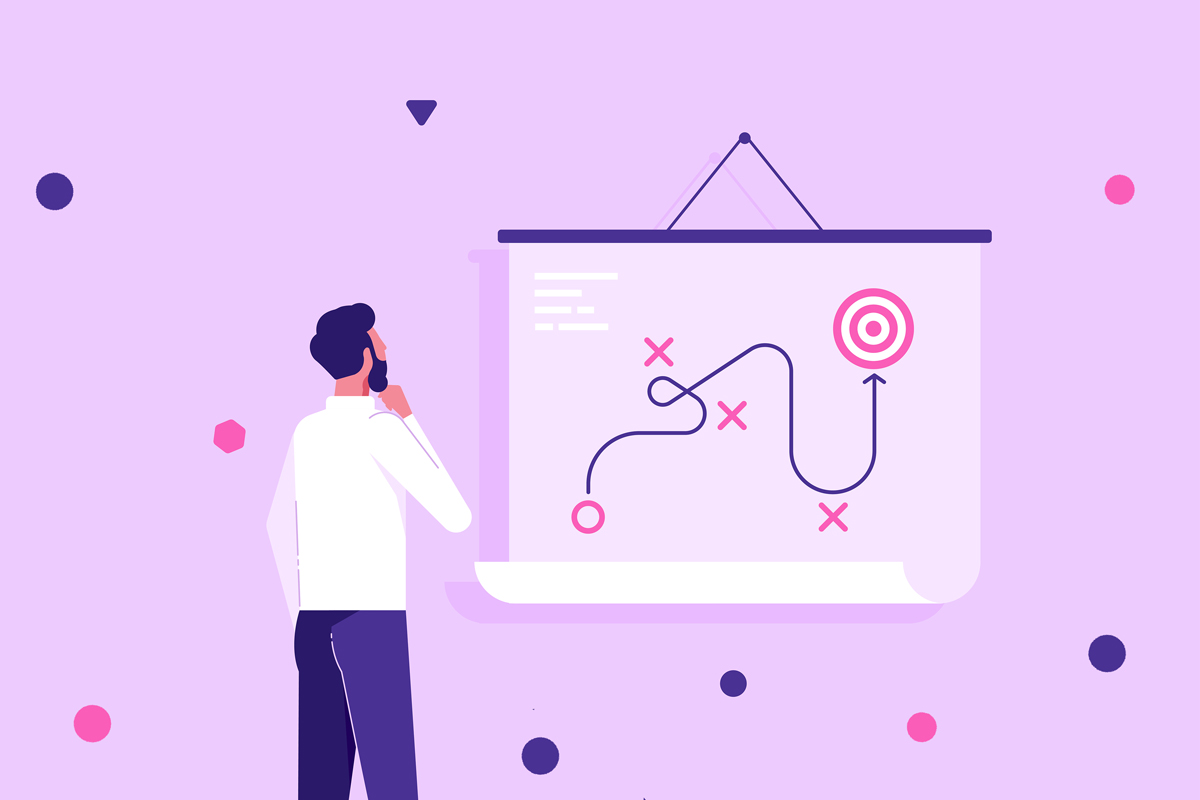











اضافةتعليق
التعليقات