التمثيل الجماعي هو الظواهر الفكرية المشتركة التي ينظّم من خلالها الناس حياتهم، ويشكّل مكونات جوهرية من أي ثقافة. وقد طُرح هذا المصطلح لأول مرة من قِبَل دوركهايم للإشارة إلى واحدة من الأنواع الرئيسة لـ «الحقائق الاجتماعية» التي يُعنى بها علم الاجتماع، وهي: المعتقدات، والأفكار، والقيم، والرموز، والتوقعات التي تشكّل طرق التفكير والشعور التي تتسم بالعمومية والديمومة ضمن مجتمعٍ ما أو مجموعة اجتماعية ما، والتي تتشاركها باعتبارها خصيصة جماعية لها.
يرى دوركهايم أن الناس، بمن فيهم علماء الاجتماع وغيرهم من العلماء، لا يمكنهم فهم عالمهم إلا من خلال استخدام المفاهيم التي تسمح لهم باستيعاب وتنظيم التجارب والخبرات الفوضوية التي تتلقاها حواسهم. فقبل أن يتسنى لهم الإقدام على فعلٍ ما، يتحتم عليهم تصور هذا الفعل بشكلٍ من الأشكال ومحاولة توقع تبعاته. والتصورات الجمعية هي المفاهيم المشتركة اجتماعياً التي يستطيع الناس من خلالها التفاعل مع العالم الطبيعي وغيرهم من الناس الذين يقابلونهم. وعليه، فالواقع إنما هو واقع تشكّله الظروف المجتمعية. وفي التفاعلية الرمزية (Symbolic Interactionism)، تم صوغ هذه الفكرة نفسها فيما يتعلّق بتوظيف الرموز والمعاني لبناء معنى الموقف. وقد تبُنِّيت هذه النقطة في أعمال جان بودريار (Jean Baudrillard)، الذي يفضل مصطلح "الصورة الزائفة" (Simulacra)، وذلك لتأكيد وجهة نظره في ضرورة اعتبار التصورات الجمعية ليست انعكاسات فكرية مباشرة عن واقع خارجي مستقل، بل يجب رؤيتها دائماً باعتبارها مشكلات للواقع.
ارتأى دوركهايم التصورات الجمعية باعتبارها تتألف من «ضمير جماعي» أو «وعي اجتماعي» يتواجد بشكل خارجي بالنسبة إلى أفراد المجتمع، حيث تسبقهم في الوجود وتدوم بعد وفاتهم. ويولد الأفراد في عالمٍ قائمٍ مسبقاً من التصورات الجمعية، ومن خلال اختلاطهم الاجتماعي، يتعلمون هذه التصورات الجمعية وينمّون لديهم إحساساً بالالتزامات المعنوية إزاءها. ويعني هذا الالتزام المعنوي أن هذه التصورات تتخذ شكلاً إلزامياً، ومن ثم فهي قادرة على تحجيم وتقييد أفعال الأفراد والعلاقات التي يبنونها مع الآخرين.
لا تعني تلك الفكرة عن الطبيعة الخارجية للضمير الجماعي والتصورات الجمعية أنها تتواجد بشكل منفصل عن أذهان الأفراد الذين يشكّلون أفراد المجموعة الاجتماعية؛ ذلك أنه لا يوجد «عقل جماعي» يعلو على عقول الأفراد. فالتصورات الجمعية تتواجد فقط في أذهان الأفراد، والصفة المشتركة لهذه التصورات الجمعية، ومن ثم عموميتها على مستوى أي مجتمع، هي ما يعطيها تلك الطبيعة الجمعية والخارجية. وعلى الرغم من ذلك، حاول دوركهايم التمييز بين التصورات الجمعية والتصورات الفردية المحضة التي تمثل إنتاجات مباشرة للذهن الفردي وأدواته الحسية. ووجد أنه من الصعب تدعيم هذا التمييز، ومع ذلك، رأى كافة المحتويات الرئيسة للأذهان باعتبارها محتويات اجتماعية في الأصل والطبيعة.
يُعد تناقل التصورات الجمعية من فردٍ إلى آخر الوسيلة التي يتم من خلالها دمج الأفراد اجتماعياً في التصورات المشتركة الموجودة ضمن مجتمعهم أو مجموعتهم الاجتماعية. ويعتمد تفاعل وتجمع الأفراد على تواصل بعضهم مع بعض، ومن ثم هناك تداول دائم للتصورات ضمن المجتمع. ومن خلال هذا التداول، تنتقل التصورات من فردٍ إلى آخر، ومن ثم تتناسخ بسهولة. وفي الامتثال لهذه التصورات ونقلها إلى الآخرين، نجد الأفراد دائماً يحرّفون أو يعدّلون أو يستحدثون فيها بشكلٍ مبتكر. ونتيجة ذلك، فإن بعض التحولات المعينة والتصورات في مجملها يحدث لها تحول بمرور الوقت.
تُبنى المؤسسات الاجتماعية، ومن ثم المجتمعات بأسرها، من هذه التصورات الجمعية. وباعتبارها تمثل مجموعات من التصورات المترابطة التي يتعلمها الأفراد، تُعد المؤسسات هي الوسيلة التي تتبلور من خلالها العلاقات الاجتماعية في أنماط متمايزة ومتكررة. وهي بهذه الصفة قد تصبح راسخة باعتبارها تقاليد، أو تصبح - وبشكل أكثر رسمية - ممارسات جائزة قانونياً.
وتتألف المجتمعات المتماسكة من أفراد تربطهم اجتماعياً تصوراتهم الجمعية المشتركة.
تملك هذه التصورات الجمعية ما أطلق عليه غيدنز اسم "الوجود الافتراضي" خارج عقول الأفراد، ويمكنها أن تصبح مرئية أو ملموسة إذا ما أُعطي لها شكل خارجي أو مادي؛ إذ قد توجد هذه التصورات، على سبيل المثال، في الخطابات، أو الكتب، أو الصحف، أو المستندات الرسمية، أو الشرائط، أو الأقراص المضغوطة. وهذه الأشكال التوثيقية هي المؤشرات المادية للتصورات الجمعية الفعلية التي تعبّر عنها أو ترمز لها، وهي فوق ذلك تمثل القنوات الرئيسة التي يمكن من خلالها تناقل التصورات الجمعية ضمن أي مجتمع، حيث تدعم فيها أشكال التفاعل الواقعي - القائم وجهاً لوجه - أشكال التواصل التحريرية وأنظمة التواصل الجماهيري، التي تجعل من الممكن تحقيق التفاعل من مسافات كبيرة.
كثير ممن كتبوا عن هذه الظاهرة، التي وصفها دوركهايم بـ «التمثيل الجماعي» (Collective Representation)، مهتمون بالوسائل التي تمتلك المجموعات الاجتماعية من خلالها القدرة على التأثير في سلوكيات أعضائها الفرادى. وكان الكُتّاب المعاصرون، أمثال غوستاف لوبون (Gustave Le Bon)، قد أكدوا أهمية السلوك الجماعي والتأثيرات المتولدة ضمن الحشود، بينما أكد غابرييل تارد (Gabriel Tarde) انتشار التصورات من خلال شبكات العلاقات المجتمعية. وقد تم بحث أسس هذه الضغوط الاجتماعية في أبحاث علم النفس الاجتماعي التي وضعها سيرجي موسكوفيشي (Serge Moscovici)، الذي يظهر أن التوجهات والآراء التي تنتظم في هياكل معرفية هي «تمثيلات مجتمعية» (وهو المصطلح الذي يفضّله). وهو هنا يضاهي التصورات المجتمعية ذات الجذور الممتدة لفترة ما قبل العصر الحديث بالتصورات الأكثر تنوعاً ومرونة التي نجدها في المجتمعات الحديثة. ويرى أن وسائل الإعلام تؤدي هنا دوراً محورياً في نشر وتحويل هذه التصورات. ويأتي هذا القول موازياً للمطلب المثير للجدل لبودريار بضرورة أن يُنظر إلى التصورات الجمعية في المجتمعات باعتبارها «أشكال محاكاة» (Simulations).
فلم يعد الناس يُقيّدهم تصور أن الأشياء الخارجية تقع خارج التصورات الذهنية؛ ففي تجليات الوعي اليومي، تحل تصورات الأشياء محل الأشياء التي تُصوّرها. وهذا ما يحدد لنا حالة «ما فوق الواقعية» التي كانت وسائل الإعلام السبب في نشوئها، والتي تحدد الآن الوجود المعاصر.

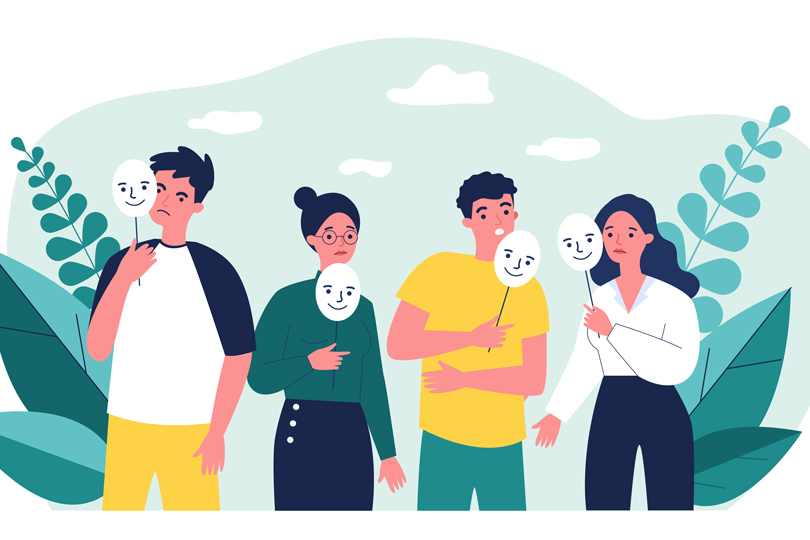


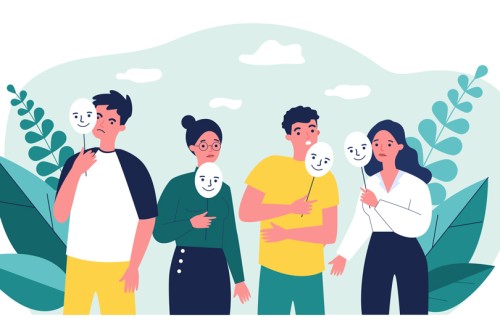




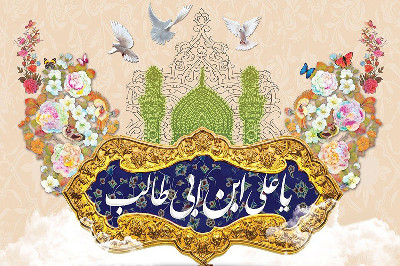




اضافةتعليق
التعليقات