بدءاً، لنستذكر أن الطبيعة البشرية مجبولة على الاختلاف والتنوع, فما البشر إلا شعوب وقبائل مختلفة العادات والمعتقدات تتعارف وتتآلف، وعليه فإن الأصل أن لا يشكل الاختلاف تهديداً ولا أن يثير مخاوف، والأصل هو عدم الشعور بالذعر بسبب الاختلاف في الرأي والأفكار.
فالله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين في كل شيء، في عقولنا وأفكارنا وأشكالنا حتى في بصمة الأصابع، فلا يوجد شخص في العالم بصمته مطابقة لبصمة الآخر,
والاختلاف وجد مع تواجد الخلق وهو حقيقة كونية لا يمكن نكرانها أو المجادلة فيها وهذا الاختلاف جعل التنوع كأنه لوحة فنية تمازجت فيها الألوان والرسومات وتناسقت فأخرجت لوحة بديعة فريدة.
والإنسان بطبيعة تكوينه خاضع لقانون الإختلاف فتختلف أفكاره وتختلف قناعاته ورغباته خلال رحلة حياته، وهنا تطرح التساؤلات (إذا كان الإنسان كوحدة صغيرة مكونة للمجتمع البشري يمتلك الكثير من الاختلاف والتناقضات في داخله، فلماذا لا يقبل الاختلاف مع الآخر؟) ولكي نتقبل هذه الفكرة ونفهمها لابد من تعريف ودراسة الآخر ومن هو الآخر؟.
الآخر هو كل من يكون خارج دائرة الـ (أنا) والـ (نحن), ممكن أن يكون الأخ، الأخت، الصديق، الجار، زميل العمل، الزوجة، شريكي في الوطن أو خارجه أي أن الآخر هو كل من يعيش معنا، ونتعامل معهم أيضًا.. فهذا الآخر ربما اختلفت بيئته عن بيئتك، وثقافته الاجتماعية عن ثقافتك، مما يستوجب نوعا من التعايش وقبول الآخر، وقبول الحوار والتعايش معه، طالما أن هذا التعايش لا يمس شؤون العقيدة أو الثوابت الدينية.
ومن المؤشرات التي تضع المجتمعات المتقدمة في الصدارة دائماً، هو تطبيق مبدأ التعايش رغم الاختلاف, وكلما كان المجتمع أكثر استعداداً للتعايش والانسجام والتقارب والتناغم، كلما كان المجتمع أكثر تطوراً وتقدماً واستقراراً وهذا ما أرسى دعائمه الإسلام، وغرسه وطبّقه النبيّ محمّد صلى اللّه عليه وآله وسلّم وبعده أهل بيته الكرام، فعاش غير المسلمين مع المسلمين في كنف الأمّة الإسلاميّة بأمن وأمان واستقرار، وقامتْ الحضارة الإسلاميّة وازدهرت فيها العلوم، وكانت مثالا للتعدّديّة الفكريّة والتّنوير، وذلك على مبدأ قوله تعالى (وجَعلْناكُمْ شعوبًا وقبائلَ لِتَعارَفوا). ومعنى تعارفوا، أي أن يحصل بينكم تبادل بالمنافع والأفكار والثّقافات، فهذه الآية تدلّ على أنّ التعدّديّة والاختلاف ثراء وغنى، وإنّ اختلاف المجتمعات والبشر هو إرادة اللّه، والآية واضحة بهذا الشأن في قوله تعالى (ولوْ شاءَ ربّكَ لجعلَ النّاسَ أمّةً واحدةً) وكأنّ حكمة الكون الربّانيّة، هي أنّ الاختلاف هو الذي سيغني الكرة الأرضيّة.
فالاختلاف بين أفراد المجتمع الواحد هو أمر طبيعي ومقبول، لكن من غير المقبول أن يتحول هذا الاختلاف إلى خلاف, بل يجب أن يكون هناك متسع لتقبل الآخرين واختلافهم, وقبول الآخر لا يعني بالضرورة اقتناعك برأيه، فللكل الحق في اتخاذ التصور الذي يراه، وإنما هو إقرار بوجود رأي آخر واحترامه (حتى لو كان مخالفًا لرأيك) والاستماع إليه ومناقشته بكل موضوعيةٍ وحياد وهدوء ورحابة صدر دون التحيّز لرأيك الشخصي وفرضه على الطرف الآخر, ودون الحاجة إلى الذّوبان في الآخر وإلغاء الذّات أو الهويّة أو الثّقافة أو الإيمان.
ولم تعد المشكلة فقط بتقبل الآراء عند اختلاف وجهات النظر، بل أصبح من يخالف يتعرض للهجوم والإقصاء، فضلا عن شن وابل من الاتهامات عليه، ويصل الأمر إلى تخوينه والتنمر عليه والتقليل من شأنه فضلا عن إطلاق أوصاف سيئة قد تطاله وتطال عائلته.
ومن الجدير بالذكر أن مواقع التواصل فتحت المجال لانتشار هذه الظاهرة، وأصبحت مساحة لشن الحروب على من يخالف رأي المجموعة أو يقرر أن يعبر عن رأيه ووجهة نظره كما يراها هو, فكل شخص يشعر أن لديه منبراً يستطيع أن ينظر من خلاله من دون أن يتقبل رأي الطرف الآخر، فضلا عن ثقافة “الأنا” لديه والغرور وعدم إعطاء الآخرين فرصة للتعبير عن آرائهم واحترامها, فيعتقد الشخص أن لا أحد غيره يحق له فرض الرأي، فيغتال شخصية الآخر، ويسعى للهيمنة عليه في حال ناقشه أو حاوره وقد يصبحان عدوين مطبقين مبدأ (إن لم تكن معي فأنت ضدي) رغم أن المطلوب هو فقط (أنت حر إن لم تتقبل رأيي, لكن لا تهاجمني!).
ومن أجل العمل على نشر هذه الثقافة لا بد من اتخاذ بعض الخطوات العملية في هذا المجال ألا وهي:
1- التأكيد على أن قبول الآخر ثقافة تكتسب منذ الصغر فمن المهم أن ننشر هذه الثقافة بين الأطفال أولاً صعوداً إلى الفئات العمرية الأخرى, وهنا يأتي دور الأهل والمدارس في زرع هذه الثقافة من خلال التربية المتوازنة ووضع مناهج تعليمية جديدة لإعداد جيل واعٍ, لكي ينمو الإنسان حاملاً في تكوينه الفكري والسلوكي، ثقافة الاختلاف وقبول الآخر فالأمر ليس ثقافة عامة بقدر ما هو ثقافة شخصية.
2- تذكر مقولة الإمام علي عليه السلام (الناس صنفان إما أخٌ لك في الدين أو نظير لك في الخلق) وهي مقولة تتجلى فيها النزعة الإنسانية الخلاقة وتجعل الناس ينظرون لأنفسهم من خلال رابطتين لا ثالث لهما وهما رابطة الاشتراك في الدين ورابطة الاشتراك في الخلق.
3- تعلم مهارة الاستماع إلى الطرف الآخر, هي ليست مهارة فحسب، بل هي وصفة أخلاقية يجب أن نتعلمها، كثير من الناس لا يحسنون الاستماع لبعضهم البعض، فلا يستطيعون فهم بعضهم البعض، الكل يريد الحديث لكي يفهم الطرف الآخر! لكن لا أحد يريد الاستماع!!
4- تعلم ثقافة الحوار والعمل على مبدأ (الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية), فثقافة الحوار هي التي تعصمنا من الاختلاف المذموم وتجعله اختلافاً محموداً، وتعلّمنا فنّ إدارة الاختلاف, بما يجعل من التمايزات بين البشر، مصدر ثراء وتنوّع وبهجة.
5- توجيه وسائل الإعلام المختلفة كي تؤكد على ثقافة قبول الآخر ونبذها لكل الثقافات التي تشجع على التعصب والتطرف.
خلاصة الموضوع إن الاختلاف سنة كونية، بل هو جزء من حال التعدد في الكون كله، فالكون لا يسود إلا بالتعدد، والاختلاف بين الآراء، لذا فإن احترام إنسانية الآخر واجب شرعاً، والعدل معه علامة من علامة التقوى. كما أن قبولنا بالآخر يحمل في طياته بعداً إيجابياً يتمثل في تبني الحقيقة كما نراها، دون أن ندعي امتلاك الحقيقة كلها, فثقافة اللون الواحد وثقافة إلغاء الآخر وتهميشه وسيادة المفاهيم الاقصائية سوف لن تؤدي إلا إلى المزيد من التفكك المجتمعي والعنف وسيادة العنف بدل اللاعنف وتزايد الحقد والكراهية والتعصب بين أبناء المجتمع الواحد وتذكر دائما أن أفكارك لك لكن أقوالك لغيرك، وأن تقبل الاختلاف والنقاش المثمر يغذي العقل وينمي الفكر، وعلى النقيض فعدم تقبل الاختلاف والجدال ما هو إلا تباعد وتنافر بين وجهات النظر.


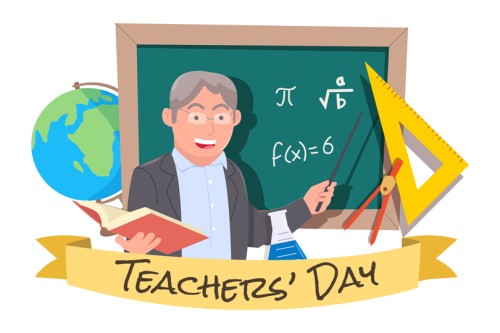

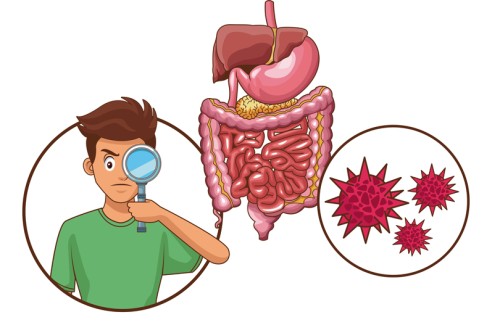






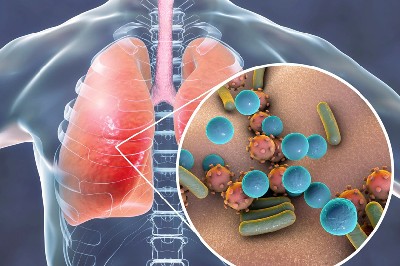


اضافةتعليق
التعليقات