خلال القرن الماضي نشطت حركة الاحتجاج في العالم العربي ولكن تلك الاحتجاجات كانت تحمل طابعاً قومياً بحتاً: ضد الاستعمار، ضد الصهيونية، ضد العمالة، ولكن الاحتجاجات التي اجتاحت مصر وتونس وليبيا واليمن... فرضت واقعاً جديداً تجلى في اختلاف طبيعة المطالب الشبابية مع تراجع فكري واضح إذا ما قورن مع جيل الاحتجاجات في القرن الماضي.
لا علاقة لما أقوله اليوم بتحليلات سياسية ولا بالثورات ومعانيها التحررية ذات المنطلقات النظيفة الوطنية الحريصة على ماء الأوطان ودماء الأبناء... لا... لا لن أفعل شيئاً ممن اعتاده الكتاب اليوم تحت وقع الانتكاسات العربية لأن الهجمة الجائحة على المنطقة العربية كلها وما لحق بها من عواصف ضربت عالم الشباب العربي تحديداً، هو ما يلفت الأنظار ويجعل التاريخ يقف مندهشاً لا يدري ماذا سيقول للأجيال القادمة من حكايا وأسرار، ولا يعرف بما سيغمس مداد تأريخ الأحداث المتتالية التي جنحت عن نقاء الخصال التي عرفها شرفاء الأمس وحضت عليها الشرائع والأديان والفلسفات وذلك في تلك الحقبة السوداء التي يمر بها عالمنا العربي من مشرقه إلى مغربه دونما استثناء وإن توضحت بشكل مفجع بمنطقة دون أخرى حتى الآن، فربما ستلحق تلك الموجة الهجينة بباقي غرف المنزل العربي، بل من المؤكد أنها هاجمت مسبقاً كل أركان وزاويا امتداداتنا العربية بصور أخرى طالت ثقافاتنا الدينية واللغوية والتاريخية والاجتماعية والفنية..
وكنا نرى فيها بشكل وآخر تطوراً ومسيرة حميدة إلى منصات العالم الغربي الذي سبقنا في الصعود إلى أبراج الحضارة المجيدة، ونحن من أرسينا له قبيل قرون من الزمان قواعد وأسس ذاك التطور الكبير الذي أخذ منه ما يريد ويرغب ثم تابع الدراسة والتحليل حتى صار على ما هو عليه اليوم، فعاد إلينا من جديد ليأخذ المزيد من مواردنا هذه المرة بغية تحقيق الجزء الأكبر والمهم من نهضته الشاملة ورفاهيته الكاملة، مع الحرص على ضرب حصار خانق على الجسد العربي الشامخ بمكوناته الكثيرة كي تتفتت وتتلاشى وإلى زوال تذهب دونما رجعة، ولا حتى تحقيق أدنى ارتقاء وهدفه الأول أرجحة الشباب تحت أي بند وباب للخلاص من الوجود العربي بشكل عام.
إن ما شهده العالم العربي من حراك شبابي بمظاهره المختلفة ضد: سلطة الدولة، سلطة الأب والمدرسة، الجامعات والمؤسسات، وما نشهده اليوم من حركات تتصف ببعض الأحيان بالعنف في التعبير عن الرأي، وهنا لا نقصد الجماعات التكفيرية الإرهابية التي من المعروف عنها مصدر تحركاتها، بل ما نقصد به هنا شباب الحوار والتطوير..
فهؤلاء الشباب الذين يحملون في احتجاجهم مشهداً يوحي بانهيار الكبار كمثال للتماهي، وإرادة لتحطيم قيم الواقع المعيش الذي أصبح ضرورة وجودية لهم لتحقيق ذاتهم والتعبير عن حاجاتهم ومتطلباتهم وحماية هذه الذات من خطر الاستسلام والتقوقع في القوالب التقليدية والنظم البالية، ما يدفع المفكرين إلى البحث عن الدوافع العميقة وراء الاحتجاج والرفض من الجيل الجديد ـ هذا الاحتجاج الذي لا ينحصر بالسياسة بل يتعداه ليطول المجتمع والدين ـ ما يولد عدة أسئلة منها: لماذا يتحدى شباب اليوم أهداف ''الراشدين'' أو ترفضها وترى أن التطلعات الاجتماعية والسياسية ليست أفكاراً قادرة على تحقيق احتياجاتهم العاطفية والفكرية؟
خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي قام الشباب في أوروبا وأميركا وبعض أنحاء العالم بحركات غلب على طابعها الرفض والمناداة بالمشاركة والخروج من التهميش، وعلى الرغم من الأوضاع المعيشية الممتازة لهؤلاء ووسائل الترفيه والحضارة التي كانت متوافرة لديهم فإنهم رفعوا شعارات تبدو أنها بعيدة عن الواقع، مثل التشاركية وتحسين الأوضاع وغير ذلك من المواضيع التي تبدو للوهلة الأولى بعيدة كل البعد عن واقعهم وقد ولدت هذه الاحتجاجات آنذاك تساؤلات كبيرة تتعلق بماهية طموحاتهم ودعت المفكرين حول العالم للتساؤل عن المستوى المُرضي لهم.
إن إسقاط ما فعله الشباب في أوروبا على واقع الشباب العربي يحمل في ثناياه الكثير من التجني، وعلى الرغم من التشابه في بعض الأوضاع، إلا أن الاختلاف هو الطابع المسيطر على هذه المقارنة التي تأتي في مجملها مجحفة بحق الشباب العربي، فعند الحديث عن الدوافع وراء الاحتجاج فإننا نجد أن الوضع المعيشي ربما يستثنى من واقع الشباب في أوروبا أو على الأقل حتى وقت قريب كان كذلك، في الوقت الذي يعاني فيه الشباب العربي من الاستحالة الاقتصادية فإن نظراءهم الأوروبيين ينعمون إلى حد كبير بسلطة إيجابية للدولة من ناحية الوضع المعيشي وحصر البطالة وغيرها، إذاً فمحركات الاحتجاج في وضع الشباب العربي أوسع وهي لا تنحصر بسبب واحد وإنما تتوزع على عدة أسباب.
الجهل المعرفي:
فمن هذه الأسباب ما هو تعليمي، فلا شك في أن مؤسسات التعليم قد مهدت بشكل كبير لتوليد حالة اليأس وعدم الكفاءة لدى طلابها، وذلك يأتي بسبب استنساخها للمناهج دون تكبد عناء مواءمتها مع الوضع العقلاني العربي والنتيجة تكون نوعاً من التهافت على تحصيل الشهادات العلمية بأسرع الطرق وأقلها جهداً دون تفعيل كفاءة التحصيل العلمي لدى الطلاب، ومما لا شك فيه أن المؤسسات التعليمية العربية باتت تؤسس لنوع من الجهل المعرفي واختصار المعرفة لتكون معرفة ''خدمية'' تفتقد العمق.
السلطة الأسرية:
ومن الأسباب أيضاً الأسرة، فبين قسوة الأب والإفراط في الحماية من الأم يتحول الشاب العربي إلى فكر هاجسي للتخلص من سلطة الأب، وربما إعادة خلق تجربة الأب في الوقت المناسب عبر فكر ''أوديبي'' بالمعنى السلطوي. ورغم أن الأسرة العربية ما زالت مخلصة لأبنائها من ناحية الحماية والمساعدة الاقتصادية التي يمكن أن تمتد إلى ما بعد سن الرشد، إلا أن هذا يلغي بشكل ما السعي للاستقلالية، أو على الأقل يؤجله حتى يظهر لاحقاً على شكل احتجاج ربما يصبح ظاهرة عنيفة لاحقاً.
دور الدين:
ومن الأسباب الإشكالية أيضاً الدين، ففي الأغلب تشترط المؤسسة الدينية الإخلاص التام للمعتقدات والتسليم بكل التعاليم ''وهنا لا نقصد النصوص القرآنية أو القدسية'' والأخذ بها تبعاً كما هي دونما ملاءمة للواقع، وربما يتجاوز الموضوع ذلك ليصبح تعاليم رجل دين ما لا يلغي في بعض الأحيان العلاقة الندية أو المساواة في مبدأ الدين ويحول العلاقة إلى علاقة تبعية مطلقة يشترط فيها الانصياع، ورغم أن هذه الإشكالية تطول الدين بحد ذاته، إلا أن لها إسقاطات اجتماعية تطول الشباب في صلب حياتهم، وربما لا تكون هذه العلاقة ناتجة عن الأداء الديني نفسه إلا أن السببين السابقين ''الأسرة والمؤسسة التعليمية'' قد وفرا الظروف الملائمة لهذه العلاقة الإشكالية مع الدين دون أن ننسى الوضع الاقتصادي وضعف المعرفة الفكرية، فجميع هذه الظروف قد فتحت الباب أمام التطرف الديني الذي كنا ولا نزال نرى نتائجه العنيفة من قتل وتكفير وبذل الاحترام لسلطة بعض من يدعي أنه رجل دين.
التكنولوجيا وسلبياتها:
كما أن التطور التكنولوجي ورغم كل نتائجه الإيجابية على الشباب العربي إلا أنه حمل في طيات فورته الكثير من السلبيات، فالواقع الاجتماعي المحافظ للمجتمعات العربية بدأ يتهاوى مع وجود أمثلة غربية يتلقفها الشاب العربي بالزمن الحقيقي كما أن وسائل التواصل الحديثة وضعت في مستوى واحد مجتمعين عربياً وغربياً هما على طرفي نقيض من حيث مسيرة التطور والتجارب والمفاهيم التي تتعلق بالحرية والرفاهية..
ووضعت الشاب العربي كطرف خاسر في هذه المعادلة المعقدة، فمفهوم الحرية في المنظور الغربي ينسحب على المؤسسة والعائلة والفرد، ولا يستثني في كثير من الأحيان أي جوانب اجتماعية أو سياسية أو دينية في الوقت الذي فرضت فيه وسائل التواصل على الشاب العربي نوعاً ''خاصاً جداً'' من الحرية السياسية التي يصعب سحبها بأي شكل من الأشكال على الواقع الاجتماعي لمجتمعاتنا الدينية أصلاً.
كل تلك العوامل كرست لدى الشباب العربي شعوراً من الإحباط والوقوع في أزمة تناحرية بين ''اثنين'' بمختلف تسمياتهما: جيلين... حضارتين... رؤيتين دينيتين، وبالمجمل فإن هذين الاثنين هما متناقضان حكماً بالشكل الذي لا يترك أمام الشباب العربي أي فرصة في الاعتدال أو الحيادية وإنما يلزمه بالانطواء تحت جناح أحدهما.
وأخيراً وليس آخرا، مشكلتنا نحن الكهول والشيوخ أننا نتجه بِسؤال الحلم في الاتجاه الآخر، بل يذهب بعضنا أحياناً إلى إسقاط أحلامنا المستنفذة المتقادمة الهالكة على جيل الشباب، بل أجيال لا علاقة لها بنشأتنا والظروف الحافة بها، والنتيجة أننا نعيش بوهم معرفة الآخر من أبنائنا وأحفادنا، مثلما يتملك هؤلاء وَهم معرفتنا لِنفاجأ بِحالات جديدة من اليأس الغاضب العاصف المُدَمّر أو المنكفئ على ذاته بأفعال انطواء مُهلكة أحياناً كثيرة للنفس، كالإدمان على الراحة والانتظار وتعاطي المخدّرات والإقدام على أشكال عِدّة من الانتحار البطيء أو السريع.
كان يعني الشباب بالنسبة لنا مُرادف المستقبل، لذا كُنا نحلم بما سننجزه في حياتنا تعلماً ونجاحاً وتفوقاً بالشهادة أو غيرها، وبالشغل وامتلاك بيت وسيارة، وبالزواج وإنجاب أبناء، وبالحلم أيضاً وفي الأثناء بغد مشرق للوطن لأنّنا تربّينا على النشيد الوطنيّ وصورة الزعيم وجُرح فلسطين ونجاحات الأمّة وهزائمها... كان حلمنا ذاتيّاً جمعيّاً إيديولوجياً يُحيل على وقائع ومجموع قِيم،
أمّا حلم شبابنا اليوم فهو مشتت لعَدَم وضوح الرغبة الحافزة عليه، غارق في اللحظة مِمّا ينزع عنه صفة التمدّد في اتجاهي الماضي والمستقبل، لا ينمو، لأنّه مسكون بزحمة الوقائع الحينيّة المباشرة، غارق في نزيف لحظات التشهّي العابر الذي لا يخلف عند انقضائه السريع إلاّ المزيد من الألم والقلق والشعور الحادّ بالغربة والاغتراب رغم ظاهر الانتماء إلى أوطان بعينها.
ليس أغرب بالنسبة لنا اليوم من أبنائنا الشبّان الذين تحوَّل البعض منهم إلى قنابل موقوتة قابلة للانفجار بما أضحى يُهدّد الأوطان، كُلّ الأوطان... أن نستعيد بنوّتهم كاملةً اليوم يقتضي أن نجدّد حلمنا بإمكان تحرير حلمهم من استخدام أعداء أوطاننا له كي يتأسّس حلم مشترك يتحرّر مِن سوء الفهم المتبادل وينطلق بِعزم حادث صوب أفق جديد.
إن صناعة مستقبلنا هو حق لنا وواجب علينا وليس الارتحال إلى مؤثرات غربية خطرة ومبيدة هو السبيل إلى الفلاح والتطور والانصلاح والانتهاء إلى حضارة عربية متينة ونظيفة في مكوناتها، تترعرع بين مفاصلها نسائم الخير لكل البشرية ويسمو السلام معها ليصل إلى آفاق الإنسانية جمعاء وعيون المعرفة الغزيرة تتدفق بكل سخاء لتروي الكرة الأرضية دونما إكراه أو إذلال بعيداً عن كل غدر وفتنة واقتتال تماما كما فعل الأجداد منذ صدر الإسلام وحتى سقوط غرناطة الأندلسية في بلاد الإسبان..


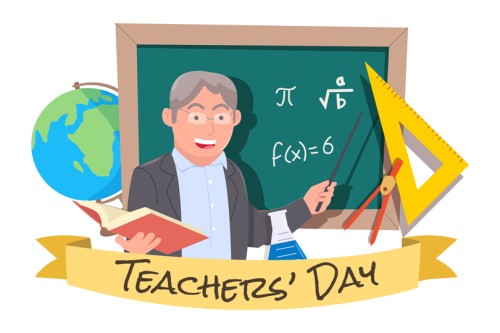

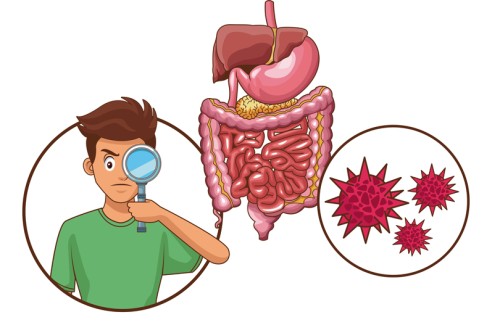







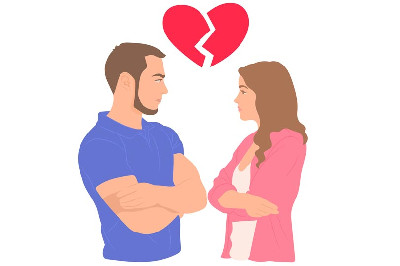

اضافةتعليق
التعليقات