كما إن تحقيق أي شيء يبدأ بخطوة، كذلك البحث عن نيل المقامات المعنوية قد يبدأ بسماع موعظة أو رؤية عبد ظهر عليه شيء منها فيعيدنا إلى ذلك النور الذي تميل إليه كل فطرة، وقد يكون بتدبر أو الالتفات إلى معنى في آيةٍ من آيات الذكر الحكيم، وهذه الآيات في سورة الانفطار: {إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ(١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤) يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ (١٥)}، لعلها مصداق لذلك في لفت انتباه كل تالي لكتاب الله إلى مقام عظيم ألا وهو مقام الأبرار.
إذ إنها إشارة إلى إن كون الفجار يوم الدين يُصلَونَ في الجحيم، أما الأبرار فلم تحصر كونهم في النعيم بأنه سيكون في ذلك اليوم فقط، وكأن في ذلك إشارة إلى أنهم في الدنيا أيضًا يعيشون في نعيم، لذا ألا يستحق الأمر أن نتعرف كيف يُحصل هذا المقام؟ وكيف يمكننا أن نعلم إننا منهم أم لا، بل وممن يتذوق نعيم الدار الآخرة قبل الإنتقال إليها؟
ولكي نصل لشيء من الإجابة عن هذه الأسئلة سيتم تسليط الضوء على بعضٍ مما وصلنا من كلمات النبي المصطفى (صلى الله عليه وآله)..
أبواب ثلاثة ندخل منها لمقام البر
قال(صلى الله عليه وآله): [ثلاث من أبواب البر: سخاء النفس، وطيب الكلام، والصبر على الأذى](١). "فكلمة [برّ] بمعنی: المحسن، و (البرّ) بكسر الراء- كلّ عمل صالح ... و الآية تريد العقائد السليمة، والنيات والأعمال الصالحة"(٢).
هنا (صلى الله عليه وآله) قال إن هذه من أبواب البر وليس كلها، أي منها يمكن أن نتعلم صنعة نفوسنا البارة، إذ صور لنا الحديث البر كالبيت يُبنى في قلب المؤمن فيه أبواب ثلاثة لابد أن تكون مفتوحة، وليست جدار لا يمكن فتحها أو الانتفاع من طرقها!
أولها أن تكون النفس سخية ذات أصل طيب يغلب عليها الحُسن لا القبح، وهكذا نفس لا يصدر منها إلا طيب الأفعال ابتداءً من منطقها وقولها، والباب الثالث هنا الذي هو [الصبر على الأذى] وكأنه الفيصل، إذ أن فيه - كما يبدو- اشارتين أن الذي يدعي الطيب وفعل الإحسان لله تعالى عندما لا يصبر على أن يقابل بغير الإحسان هو يخسر الفوز بهذا المقام، لأن الإحسان ليس حقيقي في سلوكه.
والإشارة الأخرى أن أهل البر يدركون في قرارة أنفسهم أن إحسانهم وطيب منطقهم ليس لنيل شيء من المقابل، فهم يتوقعون الاذى ويصبرون عليه لأنهم يريدون وجه الله بإحسانهم لا غير، وبذلك ينالون الفوز بمقام الأبرار.
علامات عشر لمن نال مقام البر
وعنه (صلى الله عليه وآله): أما علامة البار فعشرة: [يحب في الله، ويبغض في الله، ويصاحب في الله، ويفارق في الله، ويغضب في الله، ويرضى في الله، ويعمل لله، ويطلب إليه، ويخشع لله خائفا مخوفا طاهرا مخلصا مستحييا مراقبا، ويحسن في الله](٣)، جعل الجامع في هذه العلامات هو الإخلاص لله تعالى، أن يكون القصد إلهي محض وهو المحور في كل مشاعرنا وأفكارنا وعلاقاتنا وسلوكياتنا.
فقد ابتدأ (صلى الله عليه وآله) بمشاعر الحب والبغض، ثم ثنى بالمصالحة والمفارقة، ثم مشاعر الغضب والرضا، وهذا يشير إلى إن لها مركزية في حياة الإنسان والتحكم بها موجب للتحكم بباقي المشاعر وتحديداً من نصاحب او نفارق، وما نعمل وما نطلب.
ثم ذكر علامة أخرى وهي الخشوع لله لا لغيره، ثم فَصَلَ في ذكر مواصفات هذا الخشوع بأن يكون الخاشع خائفًا من مولاه، ذو هيبة يخاف منه من لا يخاف الله تعالى، وذو طهر وإخلاص واستحياء- وليس فقط ذو حياء - ومراقبًا لنفسه وحضوره بين يدي مولاه، وعلى مستوى العمل فهو يُحسن للآخرين قربة إلى الله تعالى.
بين أعلى درجات مقام البر وأتمها
في حديث آخر يبين (صلى الله عليه وآله) إن للبر درجات أعلاها هو بذل النفس في سبيل الله تعالى وذلك بقوله (صلى الله عليه وآله): [فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله، فليس فوقه بر](٣)، وصدق رسول الرحمة إذ ليس هنا بر فوق ذلك، فأقصى ما يمكن للعبد أن ينفقه هو نفسه.
ولكن في قول آخر له قال (صلى الله عليه وآله) فيه: [تمام البر أن تعمل في السر عمل العلانية](٣). هنا يبين لنا تمام نيل البر في أي درجة سواء كانت اعلاها أو ادناها ألا وهو الإخلاص التام في التعبد لله تعالى بتوجه القلب وعمل البدن في السر والعلانية.
وختامًا يمكننا من هذه الكلمات النبوية أن نستلهم معنى يفتح أمامنا آفاق استشعار نعيم الجنان ونحن هنا لا زلنا في عالم الافتتان، أنه معنى تحقيق القرب منه سبحانه بطاعته والعمل بما يوجب رضاه وعدم تجاوز حدوده، فهو أصل النعيم وحقيقته، وهو جوهر سعادة الإنسان في دنياه وآخرته، فما لذة الأبرار في الآخرة إلا بنوال رضاه وقربه جل وعلا، فإن حصله العبد في الدنيا تذوق ذات الطعم واستشعر حلاوته في قلبه وهو في دنياه هذه.
———————








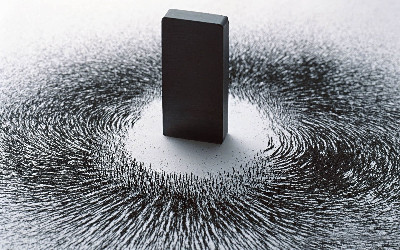



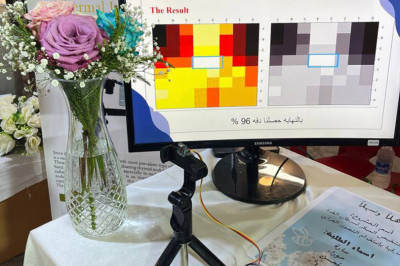

اضافةتعليق
التعليقات