في عام 1015 تقريبا، كتب الفريك، رئيس دير إينشام، مؤكدا أن من يصنع الثروة هم الفقراء دون سواهم تقريبا، الذين ينهضون قبل الفجر، ويحرثون الحقول ويحصدون الغلال، والطبيعة الحيوية لعملهم تمنحهم الحق في أن يكرمهم جميع من يعلونهم منزلة على درجات السلم الاجتماعي.
لم يكن رئيس الدير وحده مع تقدير العمال العاديين: فعلى مدى قرون كان الاقتصاد الأرثوذكسي التقليدي يؤكد على أن الطبقات العاملة صانعة الموارد المالية للمجتمع - تلك الموارد التي يبددها الأثرياء بعد ذلك على إسرافهم في الملذات والترف استمرت هذه النظرية حول أصحاب الفضل في خلق الثروة الوطنية سارية من دون اعتراضات تقريبا حتى ربيع عام1723، عندما قام طبيب من لندن اسمه برنارد ماندفیل بنشر كتيب اقتصادي في صيغة النظم الشعري، بعنوان حكاية النحل، والذي بدل نهائيا طريقة النظر إلى الأثرياء والفقراء.
على عكس التفكير الاقتصادي الذي ساد قرونا، افترض ماندفيل أن الأغنياء في حقيقة الأمر هم من يقدمون المساهمة الأكبر للمجتمع، وذلك لأن نفقاتهم توفر عملًا لكل شخص أدنى منهم، وبالتالي يساعدون الأضعف على الاستمرار في الحياة. لولا الأغنياء لشجي الفقراء سريعا في قبورهم. لم يرغب ماندفيل أن يوحي بالمرة أن الأغنياء أطيب من الفقراء (فالحقيقة أنه أشار بكل سرور إلى أي مدى يمكن للأغنياء أن يتصفوا بالغرور والقسوة وتقلب المزاج ضجرا).
رغباتهم لا تقف عند حد، ويتلهفون على تهليل الآخرين ومديحهم، ويفشلون في فهم أن جذور السعادة لا تمتد ثابتة في أرض الامتلاك المادي، ورغم ذلك كله فإن سعيهم وراء الثروة وحصولهم عليها لهو أعظم نفعا للمجتمع بما لا يقاس من كدح العمال الصبور وغير المجزي ماديا.
من أجل الحكم على قيمة الإنسان، ليس علينا أن ننظر إلى روحه بل إلى تأثيره على الآخرين. بالاستناد إلى هذا المعيار الجديد، فإن من يكدسون الثروات (في التجارة أو الصناعة أو الزراعة) وينفقون بإسراف (على وسائل الترف السخيفة أو بناء متاجر كبرى غير ضرورية أو المنازل الريفية الفاخرة ذات الحدائق) يقدمون دونما شك نفعا أكبر مما يقدمه الفقراء. كما يشير العنوان الفرعي لقطعة ماندفيل الأدبية، فإن القضية كانت «شرور خاصة، ومنافع عامة». وقد شرح ذلك: «إنه رجل الحاشية الذي لا يضع حدا أمام رفاهيته، والغانية متقلبة المزاج التي تبتكر موضة جديدة كل أسبوع.. والمتهتك المسرف والوريث المبذر... هم من يقدمون أفضل العون للفقراء. إنه ذلك الشخص الذي يسبب أشد الضيق والعنت لآلاف من جيرانه، ويبتكر أشق الصناعات، سواء كان على صواب أم على خطأ، فهو أعظم صديق لمجتمعه.
في غضون نصف عام سوف يهلك جوعا كل من تجار الأقمشة ومنجدي الأثاث والخياطين إذا ما اجتثثنا حُب التفاخر والترف من البلاد معا».
رغم أن فرضية ماندفيل قد صدمت جمهورها الأول (تماما كما قصد لها أن تفعل)، فسوف تواصل قدرتها على إقناع كبار الاقتصاديين والمفكرين السياسيين للقرن التاسع عشر وما بعده، جميعهم إلا قليلا. في مقاله عن الرفاهية (1752)، كرر هيوم حجة ماندفيل منحازا إلى مسلك الأثرياء وإنفاقهم لشراء سلع زائدة على الحاجة، مؤكدا أن تلك المبادرات هي ما أنتج الثروة، وليس العمل اليدوي للفقراء: «في دولة.. ينعدم فيها الطلب على الرفاهيات الزائدة عن الحاجة، يغرق الناس في الجمود والبلادة، ويفقدون كل بهجة للحياة، ويصيرون عديمي الجدوى للشعب، الذي لا يمكنه دعم وحفظ أساطيله وجيوشه».
بعد سبع سنوات، سوف يتبنى آدم سميث رأي هيوم ابن بلده اسكوتلندا، ويمضي به مسافة أبعد في كتابه نظرية العواطف الأخلاقية، وربما يكون دفاعه هو الأشد خداعا على الإطلاق حول مسألة جدوى الأغنياء. بدأ سميث بالإقرار بأن الأموال الهائلة لا تجلب السعادة على الدوام: «يترك الثراء على الدوام الإنسان عرضة للقلق والخوف، بالقدر نفسه الذي كان عليه قبل الثراء وأحيانا بقدر أكبر».
ويمضي في سخريته اللاذعة ينبذ أولئك الحمقى بما يكفي لتكريس حياتهم بكاملها لملاحقة «الزينة والزخرف التافه». على الرغم من ذلك، فقد أشار أنه يشعر بامتنان عميق نحو أولئك من ذوي الوفرة والسعة، ذلك لأن التحضر على العموم، ورخاء جميع المجتمعات، قد اعتمد على رغبة وقدرة بعض الناس على مراكمة رأس مال لا حاجة بهم إليه والتفاخر بثروتهم على الآخرين. وفي الحقيقة، لقد كان هذا «هو ما حفز البشر في أول الأمر على زراعة الأرض، وبناء المنازل، وتأسيس المدن والمجتمعات الكبرى ذات الثروات المشتركة، وابتكار كل وجوه العلوم والفنون، وسائر ما كرم الحياة البشرية وزينتها؛ وهو ما بدل وجه العالم تبديلا تاما، إذ جعل من الأدغال الفجة للطبيعة سهولًا مقبولة وخصيبة، ومن المحيط القاحل غير المطروق معيناً جديدا لأسباب العيش».
في النظريات الاقتصادية القديمة، أدين الأثرياء لأنهم يستهلكون حصة أضخم مما يجب من الثروة القومية التي نظر إليها باعتبارها بركة محدودة الحجم. كتب سميث أنه برغم ما قد يبدو في هذه النظرة من جاذبية، فإن النظر إلى الشخص ذي «الممتلكات الضخمة» باعتباره «آفة على المجتمع، ووحش، وسمكة كبيرة تلتهم جميع الأسماك الأصغر منها» لا يعني إلا نسيان أنه لا توجد حدود مقدرة سلفا لبركة الثروة، التي بالإمكان على الدوام توسيعها عبر جهود وطموحات التجار ومؤسسي الشركات.
فالسمكة الكبيرة وأخواتها أبعد ما تكون عن التهام السمك الأصغر، بل هي في الممارسة الفعلية تساعدهم بإنفاق نقودها وتؤمن لهم الوظائف. قد يكون الأثرياء مختالين وأفظاظا، لكن رذائلهم تتحول إلى فضائل عبر عمليات السوق، أو كما زعم سميث في فقرة صارت على الأرجح الأشهر في أدبيات الاقتصاد الرأسمالي على الإطلاق: «على الرغم من أنانيتهم وجشعهم الطبيعيين، ورغم أنهم يسعون فقط إلى راحتهم ورفاهيتهم، ورغم أن الهدف الأوحد الذي يرتؤونه من وراء جهود آلاف الأشخاص الذين يوظفونهم هو إشباع رغباتهم النهمة الباطلة، فإن الأثرياء يتقاسمون مع الفقراء مهمة إنتاج كل إصلاحاتهم إنهم مقادون بيد خفية لتقديم الحصة ذاتها تقريبا من ضرورات الحياة، وهي الحصة التي كانوا سيقدمونها لو أن الأرض قسمت بمقادير متساوية بين جميع سكانها، وعلى هذا، فإنهم من دون أن يقصدوا ذلك من ودون أن يعرفوه، يعملون لصالح المجتمع، ويوفرون الوسائل لحياة وتكاثر أبنائه». وحقيقة الأمر أنه في مجتمعات تمنح فرص كافية للتجارة وتطوير الصناعة، بحيث «تنتج كمية هائلة من كل شيء»، كما كتب سميث، يوجد ما يكفي في الوقت نفسه لإشباع وجوه الإسراف المجحفة والخاملة للنخبة ولتلبية احتياجات الصناع والفلاحين بوفرة».
"وفي النهاية تبقى هذه النظرية في دائرة محددة بحسب نوع المجتمع وطبيعة تفكير الأفراد والسياسة فيها، إذ إن أي نظرية تقدم من قبل العلماء من الممكن أن تحمل الصحة أو الخطأ وقابلة للدحض والتطوير والتغيير من قبل عالم آخر" .












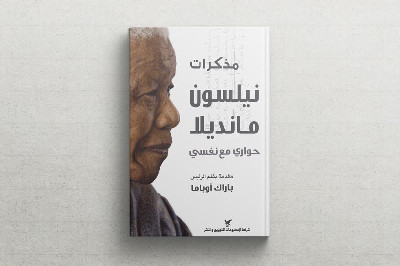

اضافةتعليق
التعليقات