إن المجتمع ليس مجرد عدد من الأفراد، وينبغي أن نحدد هنا أن وحدة هذا المجتمع ليست الفرد، ولكنها الفرد المشروط (المكيف)، فإن الطبيعة تأتي بالفرد في حالة بدائية، ثم يتولى المجتمع تشكيله، ليكيفه طبقاً لأهدافه الخاصة، وهو المعنى الذي يقصد إليه رسول الله ﷺ في قوله:((كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)).
فذلك هو التكييف الذي يجعل الفرد أهلاً لأن يتخذ مكانه، ولأن يقوم بدوره في المجتمع، أي إننا ينبغي إجمالاً أن تحدد العلاقة التي يُحتمل أن تكون بين مجموعة من الأفعال المنعكسة المنظمة لسلوك الفرد، وبين شبكة العلاقات التي تتيح لمجتمع ما أن يُؤدِّي نشاطه المشترك، فكما أن الفرد والمجتمع في الظروف العادية يعملان في الاتجاه نفسه، فإن هناك تبادلاً بين الانعكاس الفردي والعلاقة الاجتماعية، وبفضل هذا التبادل ينبغي أن نتوقع تدخل الواقع الديني في هذا الجانب الجديد من المسألة فالفرد يكتسب مجموعة انعكاساته، كما يكتسب المجتمع شبكة علاقاته، والعلاقة وثيقة بين جانبي المسألة: فهي علاقةً كونيّة تاريخية، إذ أن المجتمع يخلق الانعكاس الفردي، والانعكاس الفردي يقود تطوره.
إن إدماج الفرد في شبكة اجتماعية عملية تنحية، وهو في الوقت ذاته عملية انتقاء، وتتم هذه العملية المزدوجة في الظروف المادية، أي في حالة المجتمع المنظم بوساطة المدرسة وذلك ما يُسمى التربية.
أما إذا كان المجتمع في طريق التكوين فإن العملية تبدأ تلقائياً في الظروف النفسية الزمنية التي تتفق مع ما أطلقنا عليه من قبل:(الظرف الاستثنائي)، الذي يتوافق مع ظهور المجتمع والحضارة ... فالاطراد النفسي في كلتا الحالتين واحد: إذ يجد الفرد نفسه متخلياً عن عدد من الانعكاسات المنافية للنزعة الاجتماعية، ليكسب مكانها أخرى أكثر توافقاً مع الحياة الإجتماعية.
وذلك هو تكييف الفرد فهو عملية تنحية تجعل الفرد لا يعبأ ببعض المثيرات ذات الطابع البدائي كتلك الحمية التي كانت تعتري عرب الجاهلية وتدفعهم إلى الأخذ بالثأر، وهو عملية انتقاء أو إحساس، تجعل الفرد قابلاً لمثيرات ذات طابع أكثر سمواً، طابع أخلاقي أو جمالي مثلاً.
وتعد هذه العملية من الوجهة النفسية المحضة عملية بناء للذات أو ال (الأنا) أو بعبارة أخرى عملية تحديد العناصر الشخصية.
إن الظرف الاستثنائي الذي يُسجّل نقطة الانطلاق في تاريخ مجتمع معين منها، يتفق في الحقيقة مع ظهور فكرة دينية، في فجر حضارة معينة ويتمثل تطور هذه الحضارة المعينة في دورة ذات مراحل ثلاث:
فنقطة الصفر من الدورة تُسجل الحالة السابقة على الحضارة، كما تسجل بدء ظهور الظرف الاستثنائي اللازم لإحداث التركيب العضوي التاريخي بين العناصر الثلاثة الإنسان والتراب والوقت، وهو التركيب الذي ينفق مع ميلاد مجتمع معين، كما يتفق بصورة ما فالقيم الاجتماعية في هذه النقطة مع بداية عمله التاريخي. لم تصبح بعد واقعاً قائماً، وإنما هي مجرد احتمالات، والمجتمع ذاته ليس حينئذ سوى (احتمال) في ضمير الغيب، و (بذرة) من الإمكانيات في غضون التاريخ. وفي هذه الحالة يحتمل وجوده أن يكون أو ألا يكون، إذ أن (عالم أشخاصه) و (عالم أشيائه) لم يُوجَدا بعد، ولكن عالم أفكاره يحتوي على الأقل بذرة إمكانياته، كما تحتوي النطفة كل العناصر العضوية والنفسية المسهمة في تركيب الكائن المقبل. فليس وجوده حينئذ سوى فكرة متجسدة، أحياناً في رجل مثل (إبراهيم) الذي قال فيه القرآن الكريم حقاً:( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ [النحل : 120] .
فسواء كنا بصدد المجتمع الإسلامي أو المجتمع المسيحي، أم كنا بصدد المجتمعات التي تحجرت اليوم أو اختفت تماماً من الوجود، نستطيع أن تقرر أن الفكرة التي غُرست بذرتها في حقل التاريخ هي فكرة دينية، ومعنى هذا أن الظرف الاستثنائي الذي يلد مجتمعاً يتفق في الواقع مع الفكرة الدينية التي تحمل مقاديره، كما تحمل النطفة جميع عناصر الكائن الذي سيخرج فيما بعد إلى الوجود، ومعنى هذا أيضاً أن شبكة العلاقات بكل ما تحتويه من خيوط وأطراف، والتي سيتسنى للمجتمع بفضلها أن يُؤدي عمله في حيّز القوّة، داخل البذرة التي تشتمل جميع التاريخي هي ذاتها تعدّ أقدارها .
إذن فالعلاقة الروحية بين الله وبين الإنسان، هي التي تلد العلاقة الاجتماعية، وهذه بدورها تربط ما بين الإنسان وأخيه الإنسان، أنها تلدها فى صورة القيمة الأخلاقية، فعلى هذا يمكننا أن ننظر إلى العلاقة الاجتماعية والعلاقة الدينية معاً من الوجهة التاريخية على أنهما حدث، ومن الوجهة الكونية على أنهما عنوان على حركة تطور اجتماعي واحد.
فنحن نرى من الوجهة التاريخية أن الحدثين يتوافقان، ونلاحظ من الوجهة الكونية بناءً على ما أسلفنا من اعتبارات أن الحدثين يرتبطان ارتباط الأثر بالسبب في حركة التطوّر الاجتماعي، فالعلاقة الاجتماعية التي تربط الفرد بالمجتمع هي في الواقع ظلّ العلاقة الروحية في المجال الزمني.
فالمجتمع أيا كان نموذجه التاريخي أو التشكيلي ليس مجرد جمع لعناصر، أو أشخاص، تدعوهم غريزة الجماعة إلى أن يتكتلوا في إطار اجتماعي معين، هذه الغريزة وسيلةً لإنشاء المجتمع، وليست سبباً في إنشائه، إذ يضم المجتمع ما هو أكثر من مجرد مجموعة من الأفراد الذين يُؤلّفون صورته يضم عدداً من الثوابت التي يُدين لها بدوامه ، وبتحديد شخصيته في صورة مستقلة تقريباً عن أفراده.
ويمكن أن نفصل الأمر بطريقتين:
أ-فقد يحدث في بعض الظروف التاريخية أن يفقد مجتمع ما شخصيته ويُمحى من التاريخ، ومع ذلك فإن عدد أفراده قد لا يتغير في هذه الحالة، بل يحتفظ كل فرد بغريزة العيش في جماعة، وهي الغريزة التي تُحدّد معالم الفكر المجتمعي، الإنسان بوصفه كائناً اجتماعياً، وإنما أصبح الأفراد مجرد أنقاض لمجتمع. بائد، أنقاض مهيأة لأن تدخل في بناء جسد اجتماعي جديد.
ب-فإذا حدث أن اختفى الأفراد الذين يكونون مجتمعاً ما في نهاية جيل معين، فإن المجتمع يبقى، ويحتفظ بشخصية لا يمسها شيء، كما يحتفظ بدوره في التاريخ، بل إنّه يفرض على القادمين الجدد أنفسهم حتى ولو كانوا أجانب عبقريته وتقاليده وعاداته.
فالمجتمع يحمل إذن في داخله الصفات الذاتية التي تضمن استمراره، وتحفظ شخصيته ودوره عبر التاريخ، وهذا العنصر الثابت هو المضمون الجوهري للكيان الاجتماعي، إذ هو الذي يُحدد عمر المجتمع، واستقراره عبر الزمن، ويتيح له أن يُواجه ظروف تاريخه جميعاً، وهو الذي يتجسد في نهاية الأمر في شبكة العلاقات الاجتماعية، التي تربط أفراد المجتمع فيما بينهم، وتوجه ألوان نشاطهم المختلفة في اتجاه وظيفة عامة، هي رسالة المجتمع الخاصة به.
فتكون هذه الشبكة، ولو في مرحلة ابتدائية، هو الذي يعبر عن حدث(ميلاد مجتمع) في التاريخ.




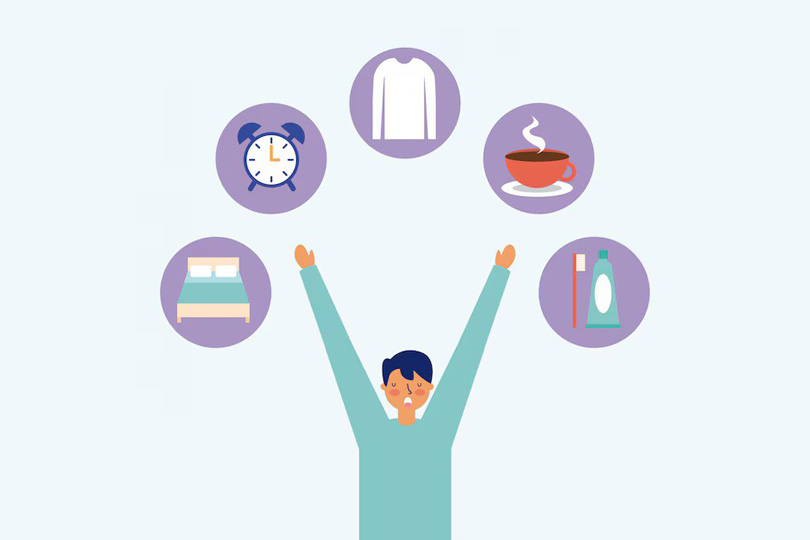











اضافةتعليق
التعليقات