"كلما أمعنت النظر في أَمر هذه الأُمة، تلاحظ تراجعها تاريخيا وثقافياً، ونشاهد جمودها واتجاهه نحو المنحدر بينما تجد هناك حركة متفجرة يجري بها العالَم المتقدِم نحو الأَمام بسرعة هائلة، الأَمر الذي يؤدِي إلى زيادة الفجوة الحضاريَة بين الطرفَين، وهكذا تعود هذه الدورة القاتلة إلى تكرار نفسها، حتى بعض المنجزات التي حققتها هذه الأٌمة، وخاصة الاستقلال، تحولَت، فيما بعد، إلى استبداد من جانب السلطات الحاكمة، وإلى تبعية داخلية، زعمائها وحكامِها، بل معظمِ حكمائها وشيوخها المتعلِمة، جعلوا من البقية أميون ثقافة وتعليماً فقد قالوا (نصفُ السكَّان العرب، تقريبًا، أُمِّيُّون)".
من الأزمات المستحدثة التأخّر العام الذي شمل المسلمين ثقافيا وصناعياً، وذلك بسبب القوانين الوضعية فإنها أسقطت الحريات والمؤسسات والانتخابات، ومنعت الثقافة بمختلف الأساليب والسبل، وتحت المسميات ولذا ليس لنا اليوم أمثال أولئك العلماء والأدباء والفقهاء الكبار الذين مضوا في طول التاريخ الإسلامي كالطوسي والرضى والمرتضى والمحقق والعلامة والبيروني وابن سينا ونصير الدين الطوسي وصاحب الجواهر وصاحب الحدائق وصاحب المكاسب (رضوان الله عليهم أجمعين)، ولا أمثال خيام وسعدي وحافظ وأبي نؤاس والحميري والمتنبي..
ولا أمثال المخترعين الكبار كجابر بن حيان ولا مثل المخترعين في العصر الحديث.. كمن اخترع الطائرة والسيارة والأقمار الصناعية والكهرباء والتلفون والتلغراف والتلفزيون وألف اختراع.
ولذا قال أحد أدباء مصر: نحن ضيوف الحضارة وكما أن الضيف لا يرتبط بالبيت في قليل أو كثير لا نرتبط نحن بالحضارة الحديثة في قليل أو كثير.
فقد كان المسلمون طيلة القرون الماضية في أيّ بعد من أبعاد الحياة إنما ينشأون في عالم حر لا في عالم مكبوت، وقد كانوا بفضل أخذهم بهدي الإسلام في القرون السالفة أحراراً بكل ما للكلمة من معنى، فنموا ذلك النموّ الهائل وتطوروا حتى صح ان يقال لهم: (آباء العلم).
بينما نرى الآن حتى في بعض بلادنا التي تدعي الديمقراطية، لا توجد هناك حرية كاملة.. فإن كانت فهي حرية نسبية ومثل هذه الحرية لا تكفي بإنماء أمثال أولئك العلماء والأدباء ومن إليهم من الشخصيات المرموقة في أيّ بعد من أبعاد الحياة.
" كثيرًا ما تردد فى الخطاب النهضوي العربي مفاهيم مثل: «التأخر» و«الغفوة» و«التبعية» باعتبارها تحريرات تصف حال الشرق، بل أحواله منذ القرن السادس عشر، فى مقابل شعارات «العقلانية» و«الحرية» و«التقدم» زمن بداية الثورة الصناعية. والحديث عن مفهوم «التأخر» يحدد واقعًا مقابل واقع، واقع الشرق مقابل واقع الغرب؛ يدُخل الشرق فى زمن التأخر، ويدُخل الغرب فى زمن الصعود.
وشكلت هذه الثنائية (التأخر - التقدم) (الشرق - الغرب) إشكالية النهضة فى صورتها الأولى. ويمكن أن نتبين ملامح «التأخر» التاريخي فى سيادة نمط إنتاجي شبه إقطاعي، ثم في علاقات اجتماعية راكدة ومعقدة التركيب؛ يضاف إلى ذلك استبداد سياسي وجمود ثقافي، وهذه السمات تتضح - بصورة قوية - عندما نقارنها بأحوال التقدم التاريخي فى الغرب.
فصدق علينا مثل قول النبي (يا بني عبد المطلب لا يأتيني الناس بأعمالهم وأنتم بأنسابكم) والمراد: أن الغير يأخذ بقسم من القرآن المسبَّب للتقدم والتعالي، وأنتم تتركون ذلك فتتأخرون.
وقد قرأت في مجلة رسمية لإحدى البلاد الإسلامية أن كل فرد من أهل تلك البلاد يطالع في كل يوم ثلاث ثوان، يعني ان كل عشرين شخصاً يطالع دقيقة واحدة، بينما قرأت في مكان آخر أن اليابانيين يطالعون في اليوم بين أربع ساعات وخمس ساعات، أي كل خمسة آلاف من أهل ذلك البلد يعادل فرداً واحداً من اليابانيين.
كما سمعت من بعض الإذاعات: إن يهودياً دخل عاصمة قبل عشرين سنة وكان أمله أن يطبع وينشر ملياراً من الكتب خلال خمسين سنة وذلك تأييداً لليهودية العالمية، وأنه من حسن الحظ ـ حسب تعبيره ـ تمكن من ذلك خلال عشرين سنة!.
أما نحن؟!
كما أنه في أيام (ماو) طبع من الكتاب الأحمر بأربعمائة لغة، واكثر من ثمانمائة مليون!، بينما القرآن الحكيم على عظمته، مثلاً لم يطبع إلى الآن حسب اطلاعي حتى بأربعمائة لغة، بينما لم يمر على الشيوعية الصينية نصف قرن، وقد مرّ على الإسلام أكثر من أربعة عشر قرناً.
إلى غير ذلك من الأرقام المشهورة بالنسبة إلى مختلف الأديان والمبادئ.
مما تقدَم ذِكره من بعضِ المؤشِرات الواضحة للعيان من عددٍ من الدلائِل، أَنَّ الغربَ كان يشكل عائقًا كبيرًا في سبيلِ تقدم هذهِ الأُمة، أَي إنَ مسؤولية انقراض هذهِ الأُمة تقع، في رأي الكثيرين، على أَنَّ الغرب كان، وما يزال، ضالعاً في الوقوفِ ضِدَّ أَيِ مشروعٍ يتعلَّق بوحدةِ هذه الأُمة، والتاريخ يشهد على ذلك.
كما أَنَّه يحاول أَن يقف دونَ تقدم العربِ العلمي والتقني، وفي هذا الِمضمارِ تقع عليْنا حصراً، التأخر في التقدم والتقدم المتأخر.


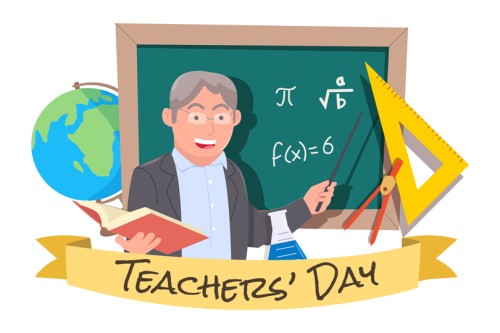

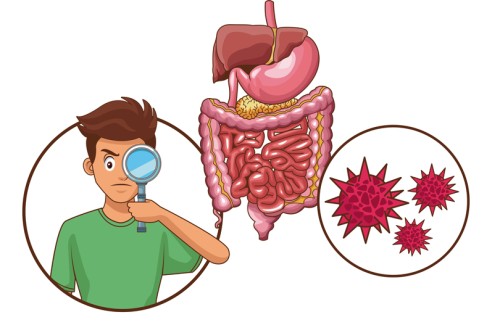








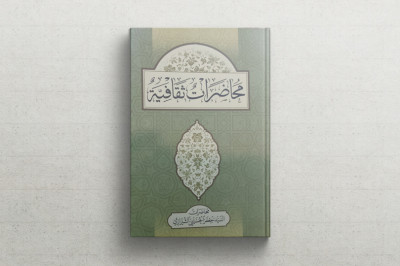
اضافةتعليق
التعليقات