يهتم علماء الجنس البشري أشد الاهتمام بكشف قيم كل جماعة اجتماعية ثقافية، وكذلك كشف القواعد الثقافية للسلوك التي تظهر هذه القيم. ويهتم عالم الإنسان، كعالم النفس الاجتماعي، بكيفية تعامل المتحدث الفرد مع تركيبة مجتمعه، ولكن ليس في ضوء حاجاته النفسية بقدر ما هو اهتمام بكيفية استخدام هذا الشخص لخياراته اللغوية لإظهار قيمه الثقافية.
وبما أن باستطاعة الفرد القيام باختيارات مختلفة من بين القيم التي تسمح له ثقافته بها في أوقات مختلفة، فإن علماء الإنسان يهتمون بالتحليل الدقيق لتفاعلات معينة. إن علماء الإنسان يهتمون اهتمامًا كبيرًا، يفوق إلى حد بعيد اهتمام علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعيين، بمزج الشفرة والتنويع الضمني فضلًا عن اهتمامهم بتبديلات الشفرة بشكلها الواسع. ويمثل كل نوع من هذه التنويعات بالنسبة لعالم الإنسان تغيرًا في التعبير عن القيم الثقافية، وهذا هو العنف وجذوره.
- المأزق الموجودي
العنف هو الصورة الطاغية وسط المشهد العالمي بعد الحريق الأميركي وما تلاه من تداعيات. إنه الحدث الذي ما زلنا نعيش تحت وطأته ونتلقى مفاعيله، خاصة في العالم العربي، حيث يحمل أو حمل العرب مسؤولية ما جرى، لأن حفنة منهم لم تحسن سوى هذا الصنيع الإرهابي، بعد قرن ونصف من الدعوة إلى النهوض والتقدم والتحديث. بالطبع ليس العرب، ولا المسلمون اختصاصيين في إنتاج العنف. ولكن من الخداع أن نقول بأن العنف هو ضد قيمنا وتقاليدنا. نحن لسنا أحسن من غيرنا ولا أقل منهم. إننا مثل بقية الناس. فقيمنا وعقائدنا وثقافتنا تدعو إلى التعارف والتسامح كما تصنع العنف والإرهاب الذي يتغذى منه .
والعنف هو الداء الأعظم الذي عجزت البشرية عن معالجته والحد من انتشاره، بالرغم من خطابات التسامح الديني وعصور التنوير الفلسفي ونظريات التقدم الحضاري. والشاهد هو القرن العشرون الذي عد قرن التقدم ومقياس التحضر.
صحيح أن البشرية قد حققت في هذا القرن من الإنجازات العلمية والاختراعات التقنية أضعافاً مضاعفة لما حققته طوال تاريخها. ولكن للديكور التقدمي وجهه الآخر ذلك أن القرن العشرين يستجمع كل ما سبقه من قرون من حيث سيئاته وشروره أو من حيث مآسيه وأهواله. إنه باعتراف الكثيرين القرن الأكثر عنفاً ودموية. وها هو القرن الواحد والعشرون يفتتح بما هو أسوأ...
هذا هو المال البشري بعد ثلاثة قرون من الآمال والوعود بالتقدم والتحرر بالرخاء والسلام. ولا مبالغة. فالأمثلة شواهد .
1 - والمثل الأول تقدمه لنا النازية والستالينية أو الصهيونية ومنظمات التكفير الإسلامية، وهي حركات شكلت مشاريع للقتل المنهجي والمنظم بعقل بارد ومنطق أصولي عنصري، ديني أو قومي أو طبقي أو جامع للأصوليات الثلاث والمقارنة على هذا الصعيد بيننا وبين أسلافنا البدائيين والبدويين أو بيننا وبين أبناء عمومتنا من الحيوانات ليست لمصلحتنا. فنحن أكثر وحشية وشراسة، بقدر ما نستخدم الفاتك من الأسلحة والأدوات والمعلومات. أما البدائي أو البدوي فإنه مقتصد في ممارسة العنف. إذ هو يقتل من أجل الحصول على الخيرات أو الموارد. ولكنه لا يلجأ إلى القتل الرمزي، أي لا يقتل نظيراً له لاختلاف في الرأي والمعتقد. كذلك الحيوان فهو مقتصد في عنفه، لأنه يقتل بلا ذاكرة. أما نحن فنزين القتل أو نمجده. والحيوان يقتل غالباً من أجل أن يأكل أو لكي يدافع عن موطنه. أما نحن فإن ذاكرتنا المشحونة بالهواجس والمشاعر لا ترويها بحار من الدماء. ولذا نقتل وندمر فقط من أجل القتل والدمار على ما هو تعريف الإرهاب .
2 - ولو توقفنا عند المنطقة العربية، نجد أنها تحولت إلى بؤرة لممارسة العنف ولخوض الحروب المتلاحقة، منذ قيام دولة إسرائيل بدعم من الدول الغربية في فلسطين وعلى حساب شعبها. وفي أي حال إن الأمن يسجل تراجعه عامة في المجتمعات العربية والإسلامية، كما تشهد على ذلك الحروب الأهلية والنزاعات الوحشية، من هنا تبدو هذه المجتمعات ملغمة من الداخل كما هي مستهدفة من الخارج. والوقائع صارخة من الجحيم الأفغاني إلى المسلخ الجزائري .
3 - لو تأمل أحدنا، على صعيد آخر وعلى سبيل المقارنة، أحوال الأمن بين الأمس واليوم في أي مدينة عربية أو عالمية، لوجد أن الأمس هو أفضل وأن اليوم هو الأسوأ كما تشهد على ذلك الإجراءات التي تتخذ لحفظ أمن الرؤساء والزعماء، قبل عقود كان بإمكان رئيس الدولة أو الوزارة في مدينة كبيروت أن يتجول من دون حراسة. أما اليوم فإنه يحتاج إلى كتيبة لحفظ أمنه. وفي الماضي كانت مؤتمرات القمة العربية تعقد بالحد الأدنى من الإجراءات والاحتياطات. أما اليوم فإن المؤتمر الذي يعقد في إحدى العواصم يشل الحياة فيها لأنه يحتاج إلى نشر لواء عسكري بكامله من فرط الخشية والحذر والتوجس. ولعل هذا ما يحصل في مختلف المدن والعواصم التي تشهد مؤتمرات إقليمية أو عالمية. مما يعني أن العقول باتت مفخخة وأن المجتمعات المعاصرة هي بؤر لتخزين العنف أو لتصدير الإرهاب .
4 - الخطابات هي المثل الأبلغ في هذا الخصوص، كما تدل على ذلك عناوين المؤلفات والدراسات والمناظرات التي يحاول أصحابها قراءة المشهد العالمي. فما يقفز إلى الذهن من هذه العناوين لدى الكتاب غربيين وعرباً وسواهم هو المفردات الآتية: الآفاق المسدودة، الأفخاخ والمآزق، الجهل والعجز الشقاء والفساد الشر المحض الفزع والرعب، التيه والدوامة الصدمة والخيبة البربرية والعدمية الكارثة والهزيمة، فضلاً عن مقولات باتت شهيرة كنهاية التاريخ والإنسان الأخير .
- هشاشة التفاسير
كيف نفهم كل هذا العنف الذي يفاجئنا ويحشرنا في الزاوية الخانقة بقدر ما يفضح عجزنا وهشاشتنا؟
هل نحن إزاء حدث محض كما وصفه جان بودريار؟ الأحرى أن نتجاوز مقولة (العقل المحض) أو (الفعل المحض) التي هي من أوهام العقل ومبالغاته إزاء الأحداث. فالحدث يكون محضاً عندما يبقى بمنأى عن الفهم، أي بقدر ما تُحجب كثافته وتختلط أبعاده أو تلتبس معانيه ولا العالم ومأزقه تستقرأ احتمالاته. أما عندما يخضع للدرس والتحليل، تأويلاً لمعانيه أو تفكيكاً لبنيته، فإنه يصبح تجربة بشرية تحمل أثقال الماضي وتراكماته أو تنبئ بعقاب التاريخ وانتقامه، بقدر ما تشرع الحاضر على مستقبل مجهول، مترع بالآمال أو مشحون بالقلق والمخاوف.
هل نفسر هذا العنف المضاعف باعتباره مظهراً لصدام الحضارات أو احتجاجاً على التفاوت بين الشمال الغني والجنوب الفقير أو ردة فعل ضد الهيمنة المتعاظمة أو تعبيراً عن أزمة التحديث في المجتمعات الإسلامية أو ردة فعل العقول ضد اجتياح التقنيات والأدوات العالم الإنسان.
قد يكون لكل واحد من هذه العوامل مصداقيته. فالفقر والاستبداد والبؤس والاستلاب كلها ظروف يمكن أن تقود إلى التفكير بالعنف أو إلى ممارسته كما يفعل الذي يشعر بأنه مهدد في أمنه الغذائي أو الثقافي أو الوطني أو السياسي. إنه يخرج على الناس لكي يجهر بعقيدته أو يشهر سيفه أو يضحي بنفسه. هذا ما يفعله الإرهابي الذي يحمل الناس كلهم، من غير تمييز بين مذنب وبريء، مسؤولية بؤسه وشقائه أو فشله وإخفاقه، متخذاً منهم أدوات أو دروعاً لتحقيق مشاريعه أو للدفاع عن قضاياه .
ومع ذلك لكل واحد من العوامل المذكورة إشكاليته. فالفقر لا يكفي لتفسير ما حدث في نيويورك، ذلك أن الذين صنعوا الحدث أو تبنوه ليسوا فقراء بل هم من أسر غنية ولكنهم أصحاب مشاريع ثقافية من أجل إرجاع المسلمين عن جاهليتهم أو من أجل انقاذ البشرية جمعاء على ما يدعون. كذلك لا يكفي أن نفسر العنف بوصفه مقاومة الطغيان كما فسر الأمر جان بودریار، بقوله: من منا لا يتمنى تدمير القوة عندما تبلغ هيمنتها القصوى؟! فليس هذا ما فكر فيه ابن لادن إذا ثبت أنه الفاعل، وإنما بودریار هو الذي قرأ الحدث بعقلية إرهابية.
ذلك أن هاجس ابن لادن كان بو دريار هو الذي قرأ الحدث بعقلية إرهابية. ذلك أن هاجس ابن لادن كان تطبيق حاكمية الله، والأحرى القول تطبيق ما فعله المسلمون الأوائل في زمنهم بحرفيته وحذافيره وبحد السيف هنا والآن. وهكذا فإن الرجل حلم وصحبه بمشروع استبدادي عنصري أو فاشي على ما تترجم المشاريع الأصولية على المسلمين أنفسهم. لم يكن إذًا يريد تحريرنا من الطغيان، بل نقلنا من طغيان إلى طغيان آخر. ولا عجب فالضدان يتواطئان على الدوام. فالضعيف يمارس العنف لكي يتحرر من عجزه، تماماً كما أن القوي يمارس الإرهاب والابتزاز للاحتفاظ بقوته أو لكي يزداد قوة وتلك هي المعضلة .
من جهة ثالثة لا يكفي التفسير التقني على ما يتوهم المذعورون من العولمة وشبكاتها وأدواتها. فالتقنية قد تعمل على تزايد العنف، ولكنها لا تخلقه. إذ البشرية ما كفت يوماً عن ممارسة العنف، على اختلاف عصورها التقنية وأنظمتها السياسية وعلى اختلاف أصولها العرقية ومنظوماتها الاعتقادية .
ولذا ليس العنف مجرد تعبير عن صراع الثقافات. كما توحي مقولة هنتنغتون لأن هذا الصراع ليس جديداً. والأهم أنه يقع داخل كل مجموعة ثقافية أو جماعة دينية وحروب الانشقاق في الداخل ليست أقل فظاعة أو شراسة من الحروب ضد الخارج أو من حروب الضم والاستتباع. فالأولى أن نعتبر العنف تعبيراً عن شراسة الإنسان وعدوانيته، أو عن بنية المجتمع وثقافته، ما دام لا مجتمع يخلو من ممارسة العنف.
وأخيراً من الخداع أن نفسر ما جرى بوصفه تعبيراً عن أزمة المجتمعات الإسلامية في مواجهة متطلبات التحديث والديموقراطية. ذلك أن المجتمعات الحديثة قد مارست عنفاً مضاعفاً ومنظماً. يشهد على ذلك ما جرى في القرن العشرين من المجازر المبرمجة والمعقلنة، على ما هي الحال عند ترقيم الضحايا تمهيداً لتعذيبها أو تصفيتها .
يبقى التفسير الخلقي القائل بأن أعمال العنف والإرهاب إنما تعبر عن انهيار القيم العليا بقدر ما تنتهك إنسانية الإنسان التي يتباكى عليها فلاسفة الأخلاق ورجالات الدين. ولكن مثل هذا التفسير لا يفسر شيئاً، بل يزيد المشكلة المزمنة تفاقماً والواقع المعقد حجباً .
ذلك أن السؤال الكبير الذي يحتاج إلى الإجابة هو: كيف نفهم أن القوي والضعيف كلاهما يمارس العنف؟ ولماذا يتماهى الظالم مع المظلوم والضحية مع الجلاد كما تفاجئنا التجارب؟ أو كيف نفهم أن ما نحشده لمجابهة العنف والإرهاب من شرائع وعقائد أو من قيم وفلسفات يبدو أقرب إلى الدفاعات الهشة والمعالجات الفاشلة التي تخترق بأعمال الإرهاب بقدر ما تعمل على توليدها؟! وبسؤال مختصر: كيف نفهم هذا التواطؤ بين الخير والشر كما يشهد تاريخ العلاقة بينهما؟
- العنف الثقافي
لنعترف بالواقع إذا شئنا معالجته وتدبره فالبشرية لا تحسن سوى انتهاك ما تدعو إليه، بدليل أن أشكال العنف وآلياته تزداد انتشاراً وتطوراً مع التطور الحضاري. مما يعني أن وحش العنف يسكننا جميعاً، وأننا نمتلك مخيلة إرهابية بأشباحها وكوابيسها، لا بالمعنى السياسي وحسب، بل أيضاً وخاصة بالمعنى الوجودي الذي يجسد شراسة الإنسان وعداوة البشر بعضهم لبعض .
الأجدى أن نفكر بطريقة أخرى، ما دام تفكيرنا السائد بمسبقاته ونظامه أو بنماذجه ومؤسساته يقودنا دوماً إلى ما لا نعيه ولا نريده، أي إلى ما نحاربه. فإذا كان العنف يفاجئنا دوماً من حيث لا نحتسب ولا نعقل بشكله الفاحش أو الفائق، فلنفتش عن جذوره حيث لا نفعل حتى الآن. فلعل ما نستبعده من مجال الضوء والدرس هو علة ما نشكو منه، أو بصيغة معكوسة: لعل مصدر العنف هو ما نعلي من شأنه أو ما نتمسك به وندافع عنه من المبادئ والقيم أو المطلقات والمتعاليات أو المرجعيات والمقدسات القديمة والحديثة الدينية والفلسفية الخلقية والطوباوية ....
بهذا المعنى يكمن العنف في بنية الثقافة نفسها، لا بمعناها الإناسي الضيق من حيث هي تعبير عن خصوصية معينة، قومية أو دينية، بل بمعناها الإنساني الشامل بوصفها العناوين الجامعة لبني البشر..










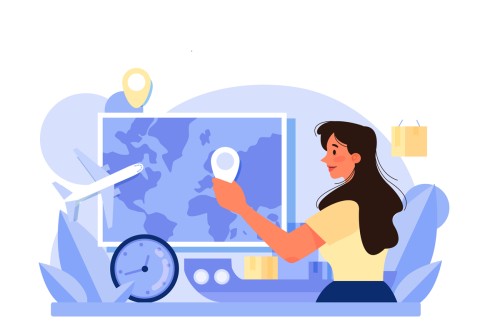





اضافةتعليق
التعليقات