تتمشى في الأسواق التقليدية الشعبية القديمة فتجتاحُ أنفك أنواع الروائح المختلفة، من البهارات وروائح الأقمشة المنبعثة محال الخياطة، ورائحة الجلود من محلات الحقائب، روائح الهيل والشاي وأكشاك بيع الكعك بالسمسم وأفران الخبز والمعجنات.
تعبرُ من بين جبال البهارات المتراكمة على جوانب الدكاكين، القرنفل والكمون والفلفل الأسود تداعبُ أنفك وتنعشُ كل خلاياك. تختارُ مقهىً تجلسُ فيه فيأتيك فنجان القهوة ورائحة البن المحمّص تتصاعد منه لتسكن رئتيك فتوقظ حواسك كلها. على الجانب الآخر أباريق الشاي المهيّل التي تتخمر ببطء على الفحم المجمّر، الذي يمتلك بدوره رائحةً تشبه رائحة الماضي، وروائح التبغ القادمة من الطاولة المجاورة. تلمحُ صديقاً قديماً فتضُمُهُ وتشمُ فيه أريج صداقةٍ دامت لعشرين عام.
بالرغم من كونها غير مرئية، إلا أنها تنتشرُ حولنا في كل مكان، حاضرة في جميع تجاربنا وأمزجتنا وذكرياتنا وتفاعلنا مع الحياة والأحداث من حولنا، لا يكاد يخلو منها أي موقف يومي نمر به، مع الأشخاص، والمناسبات، والمدن، إذ لا تتشكل حياتنا من المشاهد والأصوات فحسب، بل من الروائح، التي نعثُر عليها أو نتعثر بها. رائحة البخور، الرز الذي ينضج على النار، قشور البرتقال، أول الفجر، الخبز المنزليّ وهو يخرج من التنور، رداء الصلاة، الكتب القديمة، النقود الورقية، محطات البنزين، جلد مقاعد السيارات الجديدة، الهواء المحمّل برطوبة المطر قبل الهطول، والبطيخ الأحمر بمجرد أن تقطعه نصفين.
الرائحة هي السبب الخفي لعودتك إلى مكانٍ ما بعد وقت طويل، والسبب الواضح في رغبتك بالمغادرة فوراً من مكانٍ آخر حتى وإن توفرت فيه كل أسباب البقاء، فكيف تعمل أنوفنا إذاً؟!
يحتوي الغشاء الأنفي على ما يُقارب 6 إلى 10 ملايين خلية حسية، فأنفُك الصغير الذي قد تستهين بقدراته، يمكنه تمييز أكثر من ترليون رائحة، بل إنه قادر على تمييز الروائح عن بعضها حتى لو كان الاختلاف بينها طفيفاً. لقد خُلقنا بأنوف حساسة للروائح، كإحدى سُبل النجاة على مر العصور، فهي وسيلة للاستدلال على مصادر النار، روائح الأطعمة الصالحة للأكل، وحتى روائح الناس الذين نألفهم، ولكن مع تطور سُبل الاستدلال، نمت قدرتنا على التمييز بهذه الحاسة الفريدة، من ضيق النجاة إلى سعة الرفاهية، فأطلقنا العنان لأنوفنا لتكتشف روائح الكون، وحفظناها في قوارير زجاجية فاخرة، لنُعلن مع أول زجاجة عطر صنعها الفراعنة، بأننا قد حبسنا سر تعويذة الرائحة المنتشرة في الهواء في قارورة، لتتغير الطريقة التي نتفاعل بها مع الروائح إلى الأبد.
تربطنا بالشم علاقة شائكة منذُ فجر التاريخ، فلقد هبط به أفلاطون إلى أدنى درجات سلم الحواس. فالشم على حد وصف بعض الفلاسفة ليس إلا حاسة مثيرة للشهوة والرغبة، تحملُ طابعاً حيوانياً لا يليق بالنبلاء من البشر، فلم ير في الجسد بكل روائحه، إلا قبراً مؤقتاً للروح.
أما سُقراط فكان أقل حديّة في التعامل مع الرائحة، إذ خلُص إلى أن الرائحة تعكس الانتماء الاجتماعي والوضع الطبقي للفرد. ولكن مع انبلاج عصر التنوير تغيرت النظرة إلى الرائحة، من الطابع الغريزي إلى الطابع العلمي الذي يضعها تحت المجهر ويدرسها بعين الباحث الذي يتحسس الأدلة ويُحللها.
الروائح هي جواز سفرك الشمّي للتنقل إلى أعذب اللحظات أو أصعب الذكريات، ببساطة لأن البصلة الشميّة (وهي المنطقة المسؤولة عن تحليل الروائح) تقع بجوار مركز الذاكرة، وهو جزء بالدماغ مسؤول عن صناعة الذكريات طويلة المدى، وعلى العكس من الحواس الأخرى مثل السمع والبصر، فإن المعلومات المتعلقة بالروائح تنفذ إلى المناطق المسؤولة عن المشاعر والذكريات في الدماغ مباشرةً، مما يُفسّر ارتباط الروائح بمشاعر التوق واللهفة والحنين. ففي لحظة عابرة قد تسافر بك رائحة الكيك المنبعثة من الفرن إلى جَمعة الأهل في أماسي الشتاء، وقد تأخذك رائحة المستشفى أو عيادات الأسنان لفترة علاج سابقة، أنفنا سجل حيّ لكل الذكريات التي تعيش في بواطن لا وعينا بحُلوها ومُرّها، بما نتوق لتذكّره وبما نُجاهد لأن ننساه.
الشم هو الحاسة الوحيدة التي لا يمكنك الهروب منها مهما حاولت، فكل هطول للمطر، كل نفحة عطر، هو قدرٌ لا يُخطئ الطريق إلى أنفاسك، فكما يقول سوزكيند في رواية العطر: "قد يستطيع الناس أن يُغمِضوا عيونهم في وجه العَظمة، في وجه الرُعب، في وجه الجمال، وأن يُغلقوا آذانهم أمام الألحان أو الكلمات الخلابة، لكنهم لا يستطيعون النفاذ من الرائحة، فالرائحة هي شقيقةُ الشهيق".






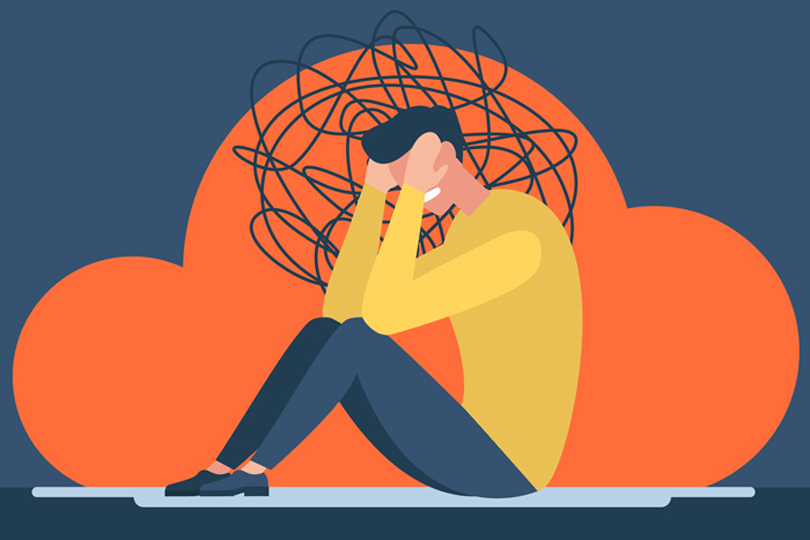
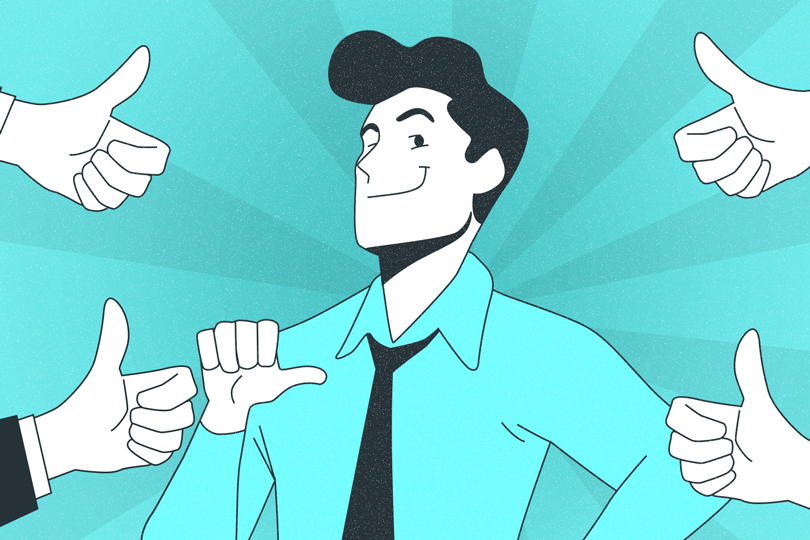








اضافةتعليق
التعليقات