ثمة محاولات عديدة لتصنيف مختلف المواقف التي يحدث فيها الارتباك. وفي إحدى تلك المحاولات (Gross & Stone, 1964)، طُلب من كل فرد من عينة بلغت 880 مبحوثًا من طلبة الجامعة أن يذكر مواقف الارتباك التي تعرض لها. وتبيّن أن استجابات الطلبة تشير إلى وجود ثلاثة أنماط من مواقف الارتباك:
1. عدم ملاءمة الهوية الذاتية (Inappropriate identity):
وذلك عندما لا تكون الذات المُقدّمة للآخرين موضع ترحيب وقبول وتأييد منهم. ومثال ذلك الفرد الذي يرتدي شكلاً معينًا من الملابس أو زيًا غير لائق بمناسبة ما، أو عندما يفشل الفرد في تقديم صورة عن ذاته تتطلبها المناسبة أو يتوقعها منه الآخرون، كأن يخطئ الأستاذ في كتابة كلمة ما أمام تلاميذه.
2. افتقاد التماسك ورباطة الجأش (Loss of poise):
وذلك عندما يفقد الشخص السيطرة على مجريات الأحداث من حوله، وتفلت منه الأمور، ولا يعرف كيف يتصرف. والأمثلة على ذلك كثيرة، مثل زلات اللسان، وسكب السوائل على الأثاث، أو تمزق الملابس بشكل يفضي إلى تعرية جزء من الجسم، أو الابتسام في مواقف غير مناسبة، والانخراط في نوبة ضحك متواصلة.
3. سوء الفهم وخطأ الاستنتاج (Disagreement over the definition of the situation):
وذلك عندما يدرك الفرد موقفًا ما إدراكًا خاطئًا، وبالتالي يخلص إلى استنتاج غير دقيق بشأن ما يجب عليه فعله في هذا الموقف. ومثال ذلك أن يعتقد أحد الأطباء الجدد أن كبير الأطباء الذي يمرّ في المستشفى هو أحد المرضى، فيتعامل معه على هذا الأساس.
وقد ظهرت محاولات أخرى لتصنيف مواقف الارتباك، اعتمدت على مطالبة الأفراد بذكر آخر موقف ارتباك تعرضوا له (Buss, 1980; Edelmann, 1987; Miller, 1992). ومن المشكلات المرتبطة بهذا الأسلوب أن الأفراد يميلون إلى تذكّر أكثر المواقف وضوحًا ودرامية، وهو ما قد لا يعكس مواقف التفاعل الاجتماعي اليومية التي يكون فيها الارتباك أكثر شيوعًا ولكن أقل حدة.
كما أن الأفراد يحاولون مواجهة ارتباكهم ومعالجة الموقف باستخدام استراتيجيات غير لفظية، خصوصًا تعبيرات الوجه، والتي قد لا يذكرونها عند استرجاعهم للموقف. وللتغلب على هذه المشكلات، طلب ستونهاوس وميللر (1994) من عينة من الأفراد أن يدونوا يومياتهم على مدى عدة أسابيع، وأن يصفوا مواقف الارتباك التي تعرضوا لها. وأشارت النتائج إلى أن 94٪ من أفراد العينة تعرضوا أسبوعيًا لموقف أو أكثر أدى إلى ارتباكهم.
وبالإضافة إلى الفئات الثلاث التي توصل إليها غروس وستون، ظهرت فئات أخرى من مواقف الارتباك، منها:
مواقف انتهاك الخصوصية (Breaches of privacy):
مثل إفشاء معلومات شخصية، أو الاضطرار لسلوك خاص أمام الآخرين، أو شراء سلعة ذات طابع شخصي جدًا.
والمثال النموذجي على ذلك ما حدث في أحد مشاهد الأفلام الإنجليزية، حين أراد أحد الأفراد شراء مجلة "للكبار"، فأخفاها بين جريدتين محترمتين. لكن مساعد البائع نادى بأعلى صوته باسم المجلة للسؤال عن سعرها، مما أثار انتباه كل الموجودين في المكتبة.
مواقف التكريم والإطراء:
مثل صعود شخص إلى المنصة لتسلُّم جائزة، مما يجعله محط أنظار الجميع، أو عند تلقي الإطراء المفرط. أحد الطلبة يصف شعوره عند استلامه جائزة الطالب المثالي: "شعرت بأنني لست هادئًا أو مرتاحًا كعادتي... كنت متأكدًا أن وجهي شديد الاحمرار، وأن جسدي ساخن جدًا... لقد كنت مرتبكًا جدًا جدًا."
الارتباك بالعِبرة (Vicarious embarrassment)
ويعني أن يرتبك شخص بسبب ارتباك شخص آخر، أو توقعه ارتباكه. وقد درسه ميللر (1987) بوصفه شكلًا من المشاركة الوجدانية (Empathic embarrassment)، والتي تختلف عن التعاطف (Sympathy). ففي الأولى، يشعر الفرد بالعاطفة نفسها التي يشعر بها الطرف الآخر، بينما في الثانية يشعر بعاطفة مكملة لها، كأن يشعر بالشفقة تجاه شخص حزين دون أن يشعر هو نفسه بالحزن.
وقد يفترض الفرد نفسه في موضع الشخص الآخر، ويشعر بمأزقه كما لو أنه هو من يمر بالموقف. وافترض ميللر أن شدة الارتباك بالعِبرة تزداد مع معرفة الفرد بالشخص المرتبك. وفي تجربة أجراها، تبين أن من شاهدوا نموذجًا يؤدي نشاطات مربكة (كالغناء أو تمثيل دور طفل في نوبة غضب)، شعروا بارتباك أكبر من الذين شاهدوا نموذجًا يؤدي مواقف عادية. ومع ذلك، لم يكن للمعرفة السابقة بالنموذج تأثير كبير على تقدير المشاهدين لمدى ارتباكهم.
كما أظهرت الدراسات أن الإناث أكثر عرضة للارتباك بالعبرة من الذكور، ربما بسبب قدرتهن الأكبر على إدراك مشاعر الآخرين (Miller, 1995). وخلصت دراسات أخرى (Marcus & Miller, 1999) إلى أن خصائص المشاهد تؤدي الدور الأكبر في شعوره بالارتباك عند مشاهدته لشخص مرتبك، حيث تبين أن 39٪ من التباين في الارتباك بالعبرة يرجع إلى خصائص المشاهد، مقابل 8٪ فقط ترجع إلى خصائص المتحدث أو النموذج.
وقد تكون الألفة والتشابه في التجربة من العوامل المؤثرة في هذا النوع من الارتباك، كما في موقف الطالب الذي يشعر بالتوتر عند تقديم نفسه أمام زملائه، ثم يزداد شعوره بالارتباك عند مشاهدة زميل له يقوم بالمهمة نفسها.
وفي الحياة اليومية، يرتبط المشاهد بالشخص المرتبك بدرجات متفاوتة، سواء من خلال معرفة شخصية، أو انتمائهما إلى مجموعة واحدة. فمثلًا، ترتبك الأم عندما يسكب طفلها سائلًا في بيت المضيف، وكأنها هي من فعل ذلك.
اقترح هايدر (Heider, 1958) مفهوم "الوحدة المعرفية" (Cognitive unit) ليفسر امتداد ذات الفرد لتندمج مع الآخرين الذين يشعر تجاههم بالانتماء. ويتأثر تشكيل هذه الوحدة بالسياق الزماني والمكاني. فمثلًا، قد تشعر بالارتباك إذا قام مشجعو فريقك بسلوك غير لائق في الاستاد، لأنهم جزء من "وحدتك المعرفية"، بينما قد لا تشعر بالأمر ذاته إذا كنت تشاهد المباراة من منزلك.
وقد تمتد هذه الوحدة إلى الماضي، فنرتبط بأسلافنا، ونشعر بالحرج أو الخزي تجاه أفعالهم، مثل ما فعلوه تجاه العبيد أو في الحروب.
أشكال أخرى للارتباك بالعِبرة
وقد ينتشر الارتباك ويصبح كعدوى، إذا كان الشخص المرتبك في مكانة تؤدي إلى اضطراب اجتماعي واسع، مما يجبر الآخرين على اتخاذ إجراءات سريعة، فيقعون هم أيضًا في الارتباك.
لكن، من المهم أن نوضح أن تصنيف المواقف المسببة للارتباك لا يُعدو كونه خطوة أولى لفهم طبيعة هذا الانفعال. فكل موقف اجتماعي يكتسب معناه من الإطار العام، والعادات، والمعايير الثقافية. ويظهر هذا بوضوح في مواقف تتعلق بالملبس، حيث يختلف ما يُعدّ ملائمًا من مجتمع إلى آخر، بل ومن شخص لآخر داخل المجتمع نفسه.
ومن ثم، فإن مجرد تصنيف المواقف لا يُطلعنا على "العمليات" التي تسبب الارتباك. ما يحقق ذلك هو النظريات التي تفسر هذه العمليات، وتمكّننا من فهم أسباب ومترتبات هذا الانفعال. وسنعرض لاحقًا إمكان الاستعانة بإحدى النظريات العامة في القلق الاجتماعي لتفسير أسباب الارتباك، ثم نستعرض نظريتين أضيق نطاقًا: الأولى تستند إلى المنحنى المسرحي، والثانية تركز على تهديد تقدير الذات.




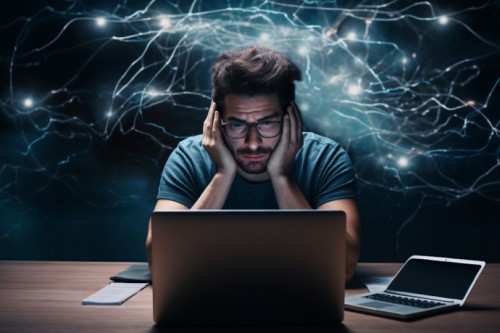









اضافةتعليق
التعليقات