أسس الغرب بنيانه على ما ينتهي إلى افتقار القطاع الأكبر من المجتمع، فقد وضع قوانين كابتة، لا تسمح للإنسان في ممارسة حقه في حيازة المباحات من: الأرض، والماء، والمعادن، والبحار، والغابات، وما أشبه.
فقوانين منعته من السفر إلا بجواز، بسبب الحدود الجغرافية . وقوانين سمحت للغلاء أن ينتشر في البلاد بسبب الرأسمالية و الربا و السلاح وكثرة الموظفين. و قوانين عطلت ملايين العمال عن أعمالهم بسبب البطالة، و قلة فرص العمل. و قوانين أترفت الحيوانات، و جوعت مئات الملايين من الناس .
إضافة إلى انك لا ترى اليوم دورا فاعلا بالنسبة إلى (بيت المال) الذي يحمل وظيفة التكافل الاجتماعي، و إتاحة فرص العمل للآخرين، و مساعدة المحتاجين والمرضى، و العزاب، و المصابين بالكوارث- بالشكل المطلوب ـ
و لكي ينجو العالم بنفسه من هذه القوانين الجائرة فلابد له من الرجوع إلى العقل، و إلى الفطرة، و إلى الإيمان بالله و اليوم الآخر، كما لابد له أيضا من الرجوع إلى الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، التي تشير إلى ذلك.
ومنها (و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة) و (ما آمن بي من بات شبعانا و جاره جائع) .
ويبقى أن يحفز عقلاء الغرب قادته، للنجاة من تلك القوانين المادية الجائرة، و إضفاء روح الإنسانية عليها، لينجو من مشاكلهم الخطيرة.
من الأمور الهامة التي يجب أن تدفع الغرب نحو التغيير و إعادة النظر في مناهجه و قوانينه (المرض) الخطير، السائد اليوم في الغرب.
فنتيجة للإباحية و إشاعة المحرمات انتشرت الأمراض التناسلية كالزهري و السفلس و الإيدز، و هذا الأخير لا علاج له رغم التطور الهائل في ميادين الطب الحديث، و هذا العجز جعل علماء الغرب يفكرون في الرجوع إلى الطب القديم، الذي كان يستخدم الأعشاب لعلاج المرضى- و لكنه لم يتوصل بعد في الرجوع إلى الطب اليوناني الذي أستخدم و جرب قبل عشرات القرون- على أن لا يترك الطب الحديث بل يضاف القديم إليه و يدمج معه، فيأخذ بفوائد كليهما.
إن مناهج الصحة العامة في الغرب مختلة الموازين وذلك لفقدان الوقاية الصحية- مما جعل العلاج مستعصيا أيضا ، وذلك لأنه حتى ولو توفر العلاج فإن ثمن العلاج غير متيسر للجميع.
وما ذلك كله إلا ولائد المناهج المنحرفة التي بلغت بالإنسان الغربي إلى هذا المستوى من الأمراض إلى آخر ما في القائمة من المحرمات، التي تضر بجسم الإنسان أشد ضرر فإنه كما أزال الغرب أسباب تلوث البيئة- إلى حد ما فعليه أن يسعى لإزالة أسباب تلوث المجتمع بمثل الإباحية و الشذوذ الجنسي، و تطهيره من المنكرات والمحرمات المتنافية مع العقل و الفطرة، و الرجوع إلى المتلائم مع الفطرة الإنسانية و المتوافق مع العقل السليم. و يبدوا أن بعض عقلاء الغرب اخذوا ينادون بذلك و جاءت آرائهم و انتقاداتهم عبر وسائل الإعلام العالمية، وكثرت خطاباتهم المطالبة بالتغيير و التفكير الجذري في الندوات والمؤتمرات والجلسات العامة.
ومن الواضح أن مرحلة الإحساس بالخطر هي المرحلة الأولى للتغيير، فتلك الانتقادات والاعتراضات من شأنها أن تبشر بنتيجة طيبة و قريبة بإذن الله تعالى.
ولا شك أن الأمراض بالمفهوم العام مسألة طبيعية ولا يمكن للإنسان أن يحصن نفسه من جميع الأمراض، لكن الكلام في هذه الكثرة الزائدة من الأمراض و الأوبئة التي تهدد البشرية بالتشوه والقتل الجماعي .
وهذا التباين المعيشي سلب الاستقرار، بما لا مثيل له في سوابق التأريخ.
التضخم السكاني
لا أحد يستطيع أن ينكر أن ثمة أزمة سكن، تعاني منها المدن الغربية الكبرى، و أن هذه الأزمة حصيلة عوامل كثيرة أهمها زيادة عدد السكان و زيادة القوانين الصارمة التي لا تسمح للمواطنين بالبناء و السكن و اختيار المكان و الوطن.
ولا سبيل إلى تخطي هذه الأزمة المفتعلة إلا بمواجهة أسبابها، و بأقصى قدر ممكن من الشجاعة والتخطيط، فاللازم تخفيض عدد السكان في المدن الصناعية الكبرى عبر الأمور التالية:
الأول: تأسيس و توزيع المعاهد و المعامل والمطارات و المستشفيات في المدن المنتشرة على طول البلاد و عرضها، فإنها توجب توازن السكان، و تقليل كثافتهم في المدن الصناعية الكبرى، وكذا الدوائر والمؤسسات الحكومية.
الثاني: إزالة الحواجز الجغرافية بين الدول و كذلك الحواجز النفسية بين الشعوب.. و فتح الحدود على روادها حتى يتمكن كل إنسان أن يهاجر إلى الدول القليلة السكان و يعيش فيها، مع توفير الحكومة لبعض مستلزمات العيش في المهجر، و منح التجار منهم و ذوي الأعمال من مختلف الجنسيات حريتهم في العمل.
الثالث: دعم القرويين و حمايتهم بما يرغبهم و ذويهم في البقاء على أعمالهم الإنتاجية، ويمنعهم من الرحيل إلى المدن، وهذا يتطلب رفع المستوى المعيشي والثقافي للقرويين و خاصة في مجال عملهم، كما ويستدعي توفير مستلزمات الصحة و الأمن و الوسائل الحديثة: كالكهرباء والماء والبريد والهاتف وطرق المواصلات، ونحوها لهم بالقدر الممكن، نعم من الصعب أن تصل القرى والأرياف- عادة- في تطورها إلى المدن، حيث الأخيرة تمتاز بموقعها الجغرافي والسياسي، إلا أن القرى و الأرياف تمتاز عادة بالهواء الطلق، و قلة الصعوبات، و انعدام ضجيج المدن و مشاكل المرور وهذه المؤهلات و غيرها ترفع من رصيد القرى وتقربها من المدن، فيما لو وفرت الدولة فيها مستوى معيشيا وثقافيا جيدا.
ولا يخفى أن هذه الأمور الثلاثة كما أشرنا إليها بحاجة إلى تخطيط دقيق من ذوي الاختصاصات العالية، للتعاون على إنهاء المشكلة بالقدر المتيسر مرحليا، لئلا تحدث هزة عنيفة في المجتمع، و لا تتولد مشكلة أخرى تعكر صفوه، حتى تعود الحياة إلى شكلها الطبيعي.
يرى بعض المراقبين الغربيين: أن المرأة أصبحت رخيصة في مجتمعاتهم أكثر مما تتصوره الأذهان، و لا بد من إعادة الكرامة إليها قبل أن تنهار الأواصر الاجتماعية والأسرية بشكل كامل.
فإن المرأة في المجتمع الغربي فقدت كرامتها.. للأسباب التالية:
1- فتح المواخير.
2- إهانتها في بعض القضايا الجنسية.
3- ازدياد حالة الشذوذ الجنسي و ابتعاد الذكور عنها.
4- الاستفادة منها في ترويج البضائع و استخدامها كوسيلة دعائية لجلب الزبائن.
5- تشغيلها في الفنادق و المطاعم و الطائرات ونحوها، لتسلية الضيوف، وكذلك مشاركتها في بعض النشاطات التافهة كالسينما و التلفزيون و الاجتماعات الإباحية و ما أشبه للهدف نفسه.
6- زيادة العوانس بسبب ضياع فرص الزواج أو تأخيره.
يظهر مما سبق: أن البشرية المعذبة لا تنتهي محنتها و لا تصل إلى ساحل الأمان إلا بثلاثة أمور:
الإيمان بالله السميع العليم و الاعتقاد بأنه جل وعلا بصير قدير يجزي بالإحسان إحسانا مضاعفا، وبالسيئة سيئة مثلها، فقد قال تعالى: ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)، و قال سبحانه: ( وجزاء سيئة سيئة مثلها).
فإذا آمن الإنسان بالله يكون في حذر دائم من مغبة السقوط في المعصية حتى في خلواته، فلا يسيء إلى نفسه، و لا إلى الآخرين، و لا إلى الطبيعة .
فقد قال علي عليه السلام: ( أنكم مسؤولون حتى عن البقاع و البهائم).
صحة القوانين و سلامة المنهج، حيث إن الإنسان إذا لم يعرف الطريق الصحيح و المنهج السليم لا يكون بمقدوره أن يسلكه مهما كان حذرا و مراقبا، و نحن نعتقد- كما هو الواقع أيضا و قد أثبتته التجارب- إن الإسلام جاء بأفضل القوانين التي تصلح الدنيا و تضمن الآخرة وتلبي نداء الفطرة وتستجيب للعقل.
فرض الرقابة الاجتماعية على طريقة تنفيذ القوانين و على الحكام و المسؤولين في شتى الشؤون، وذلك بأساليبها الحديثة، و التي تتمثل بعضها في الاستشارية الشعبية، و المؤسسات الدستورية، و التعددية الحزبية، حيث الأحزاب الحرة المتنافسة على إدارة الحكم للبناء و التقدم، إذ من دونها لا تستقيم الشؤون السياسية - عادة- للشعوب، و لا يستتب الأمن لهم.
و قد ذكرنا في بعض الكتب: أن في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت- و لو بالصيغة البدائية- أحزاب سياسية حرة، فئة المهاجرين و فئة الأنصار، و هما بالنتيجة: حزبان سياسيان شاركا في الحكم و أدارا دفته، و قد ورد لفظ (الحزب) بنصه في كتاب السبق والرماية من الفقه، ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استبد بعض المهاجرين بالحكم فوقعت الكارثة، و صودرت الحقوق المسلمة، وحدث ما حدث.
إن المخرج الوحيد لجميع مشاكلنا هو: الإيمان بالله إيمانا قلبيا يطفح على سلوك الإنسان وعمله و أعضائه وجوارحه، لا إيمانا ظاهريا لا يتجاوز لقلقة اللسان، و إلى جانبه قانون صحيح هو (الإسلام)، و إلا فما نفع القانون الصحيح- مع فرض وجوده- إذا لم يطبق!
و أي قانون هذا الذي يسود العالم حيث ترك نصف العالم فقيرا و لا أحد يحرك ساكنا لإزالة ذلك الفقر المدقع، مع أن العالم يملك وسائل التغيير و يملك الثروة بما يكفي الكرة الأرضية مرات و مرات.
و أي قانون هذا الذي يسمح بإنتاج أشد الأسلحة فتكا، ثم يؤيده الجميع و يباركون له في إنتاجه؟!
ومن ذلك كله يظهر: إن الحضارة الغربية مهددة بالانهيار، إذا لم تعد إلى فطرتها الإنسانية في التعامل مع الحياة، و قد أدرك الغربيون تلك الحقيقة، بل أنهم لمسوها في السقوط الذريع الذي أصاب الاتحاد السوفياتي السابق.


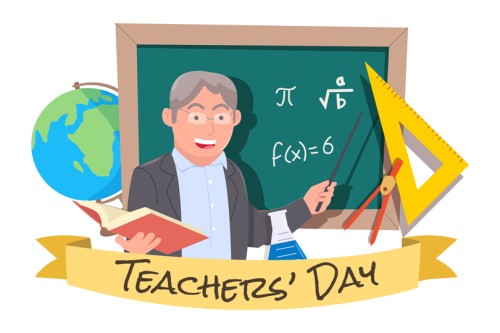

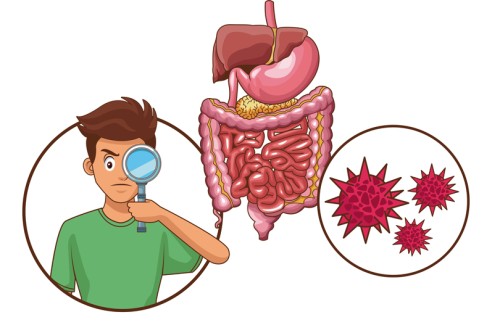



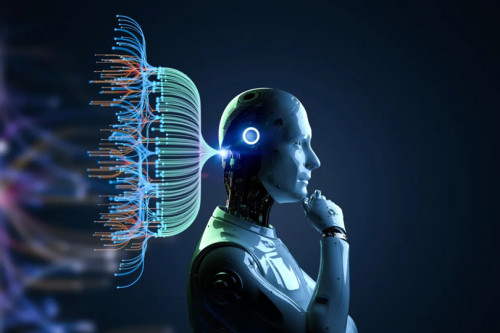





اضافةتعليق
التعليقات