يمكن معرفة مقياس قوة أي شخصية قيادية أو قدوة في عالمنا اليوم من خلال معرفة مقدار تَمكنها من الناحية العلمية، التي تَجعلها ليستْ (شخصية) مواكبة للتطور العلمي فقط وإنما صانعة ومَوجدة ومُطورة ومُجددة للأشياء من حولها، ووفقاً لذلك تكون ذات تأثير بل وسلطة على بقيةِ الأفراد والمجتمعات، وتكون بمعنى من المعاني مُهيمنة على مقدراتِ الأرضِ، ومالكة لخيراتِ الدنيا.
إلا إن كون هذه الشخصية من أهل العلم المادي فقط، وليست من أهل العلم والعبادة، تبقيها ضمن إطار القوة الظاهرية التي ليس لها جذور راسخة تضمن لها الاستدامة والبقاء، لكن متى ما كانت الشخصية صاحبة العلم مرتبطة بثقافةِ السماء، وعلى نهجِ الحق المتعال هنا تتحقق فيها القوة الحقيقية سواء في فرض هيبتها، أو في تعاملها مع الدنيا، والخلق أجمع، وكذلك في بقائها كنموذج طيب يُتأسى به.
والسيدة زينب (عليها السلام) هي جسدت لنا معنى القوة الحقيقية، كما ورد في كتب التاريخ والسيرة إنها لُقبت "بمَليكة الدُنيا". نعم، المُلكية الحقيقية للدنيا وما فيها هي لله تعالى سبحانه، وما هذا اللقب إلا مِصداق للمُلكية الكسبية التي يُعطيها تعالى لخواصِ خلقه والسيدة صلوات الله عليها منهم، كما في قوله تعالى: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ} (آل عمران: 26).
وذلك لاستحقاق كان فيها كما شَهد لها إمامنا السجاد (عليه السلام) بوصفها: [وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة](١)، وكذلك كونها "عابدة آل علي"(٢)، وبذلك جمعت الجانبين (العلم الإلهي والتَعبد)؛ فالسيدة زينب (عليها السلام) عِلمُها كان إلهيا كاملا شاملا، وخضوعها وتوجهها خالص لمعبودها عز وجل، وهذا ما انعكس على شخصيتها التي اتسمتْ بالقوة والمُكنة.
لذا يمكن أن نفهم مقومات كون السيدة (مَليكة الدنيا) من هذين الأمرين:
أولاً: الاحاطة العلمية
إذ إن السير باطمئنان، وثبات مع كل المِحن والمصائب التي عاشتها السيدة طيلة حياتها، كانت ترجمان لهذه الإحاطة العلمية ووضوح الرؤية لحقيقة الدنيا، إذ لم نقرأ أو نسمع في سيرتها (عليها السلام) بأنها ضَعُفتْ أو انكسرتْ بل على العكس؛ أصبحت رمزا مقدسا يَقتدي به الرجال والنساء على حدٍ سواء، هي فرضت وجودها وهيبتها في كل مكان وزمان، فما قالته عند مخاطبتها لطاغية زمانها: [أَظَنَنْتَ يَا يَزِيدُ حِينَ أَخَذْتَ عَلَيْنَا أَقْطَارَ الْأَرْضِ، وَضَيَّقْتَ عَلَيْنَا آفَاقَ السَّمَاءِ، فَأَصْبَحْنَا لَكَ فِي إِسَارٍ، نُسَاقُ إِلَيْكَ سَوْقاً فِي قِطَارٍ، وَأَنْتَ عَلَيْنَا ذُو اقْتِدَارٍ، أَنَّ بِنَا مِنَ اللَّهِ هَوَاناً وَعَلَيْكَ مِنْهُ كَرَامَةً وَامْتِنَاناً؟؟ وَأَنَّ ذَلِكَ لِعِظَمِ خَطَرِكَ وَجَلَالَةِ قَدْرِكَ؟.. فَمَهْلًا مَهْلًا لَا تَطِشْ جَهْلًا! أَ نَسِيتَ قَوْلَ اللَّهِ: {وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ}(آل عمران: ١٧٨)] خير دليل وبرهان.
ثانياً: العبودية الخالصة لوجه الله تعالى
نستطيع أن نُلخص حقيقة الاختبار الدنيوي بأن الدنيا - بطبيعتها - كل عطاءاتها وزينتها وزخارفها هي موضوعة لكي تكشف للإنسان مدى قوته أو ضعفه أمامها، فإن كان ضعيفا أمامها تَملكَته، وجَعلته مُتعلقا بها، والعكس صحيح، أي إن أمور الدنيا ستكون كلها تحت مُلكيته، فيَجعلها -كما هي- مَعبراً لبلوغِ المُراد منه، فلا يتوقف في مَسيرهِ مُنشغلاً بما يراه على جوانبِ الطريق من جمالياتها ومُتعها، فينسى لما هو هنا، ويعمل وكأنه باقياً فيها ولن يفنى!.
كما نلحظ في ختام قوله تعالى: {...وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً}(البقرة:165) إذ فيها إشارة لغاية الآية ولبها -كما يعبرون- فمن يكون حُب الله تعالى هو الشاغل الأوحد لقلبِه يكون قوياً، فلا يَضعُف أمام الدنيا ومغرياتها ومحبوباتها.
والتي من مصاديقها في قوله تعالى: {قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}(التوبة :24).
فكل ما ذكرته الآية من مصاديق إذا تعلق القلب بها ستكون مصدر ضعف لا قوة، بينما تَقديم حُب الله تعالى يوصل إلى الاهتداء ورؤية هذه المصاديق على إنها وسيلة لبلوغ الكمال، وزوادة لمواصلة المسير نحو رضوان الجليل المتعال.
وهكذا نرى كيف إن السيدة زينب (عليها السلام) جعلتْ حُب الله تعالى والجهاد في سبيله مُقدماً على كل محبوبات الدنيا، وما تميل إليه النفس، ولأنها تحت مُلكيتها وسيطرتها، خَلفتها وراء ظهرها، هي تركت جلوس السيدة المُنعمة في دار زوجها، وأولادها يُحيطون بها وهي آمنة، لتُكمل مَسيرها، بما فيه رضى معبودها، ملتحقة بركبِ إمام زمانها نحو الكرب والبلاء؛ لتؤدي تكليفها ودورها، بل وتُعطي من أولادها قرابين الولاء.
هنا نفهم كيف إنها (عليها السلام) مَليكة الدنيا بمعنى إنها أصبحت ذات نظرة أوسع؛ فلم تحجبها الدنيا عن رؤية هدفها [العَلوي] الذي ورثته من أبيها أمين الله، ومقامها [العِلوي] الذي بعبوديتها الخالصة ارتقت إليه.
---------










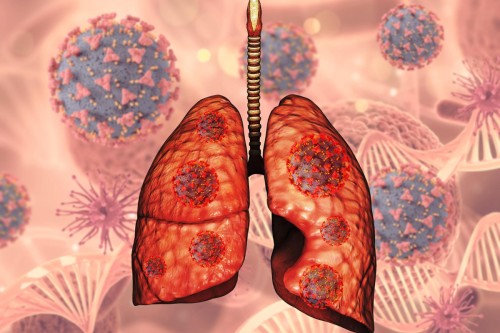


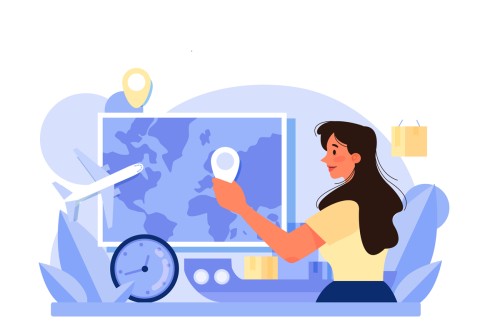


اضافةتعليق
التعليقات