كلما ساء أمر في حياتنا نطلب بطبيعتنا - تفسيرًا له، فإذا لم نجد تفسيرًا لما جعل خططنا تبوء بالإخفاق أو تفسيرًا لما جعلنا نواجه مقاومة مفاجئة لأفكارنا، فسيصيبنا ذلك بضيق كبير، ويزيد في آلامنا لكننا عندما نبحث عن السبب [لتفسير ما واجهناه من عقبات] تميل عقولنا للانشغال بأنماط تفسيرية واحدة: لقد أعاقني بعضهم، وربما أعاقني لأنه يكرهني؛ أو أعاقتني قوى تعاديني، مثل الحكومة أو التقاليد الاجتماعية؛ أو جاءتني نصيحة رديئة؛ أو: هناك معلومات أخفيت عني، وفي النهاية - إذا تفاقمت الأمور سوءًا [تراك تقول] كان ذاك حظًّا عائرًا، وكانت الظروف غير مواتية.
فهذه التفسيرات تؤكد عجزنا بصورة عامة إنها تقول لك: «ما الذي كان بوسعي فعله غير
ذلك؟! كيف كان لي أن أتنبأ بالأفعال البغيضة التي يضمرها فلان ضدي؟». وهناك أيضا شيء من الإبهام؛ فنحن عادة لا نستطيع تحديد التصرفات الخبيثة للآخرين؛ بل نحن نشتبه بها وحسب، أو نتخيلها، وهذه التفسيرات ميّالة إلى تكثيف عواطفنا من (الغضب، إلى الإحباط، إلى الاكتئاب)، وبذلك ننغمس فيها، ونشعر بالأسى على أنفسنا، والأمر الأكثر أهمية أن استجابتنا الأولى تكون بالبحث عن السبب خارجنا؛ فترانا نقول: أجل، قد نكون مسؤولين عن شيء مما حدث لنا، إلا أن اللوم الأكبر يقع على الناس والقوى التي تناصبنا العداء، فهي من وقف في طريقنا لإعاقتنا، وهذه الاستجابة مغروسة بعمق في الكائن البشري، فلربما كان الناس في العصور القديمة يلقون باللائمة على الأرباب، أو أرواح الشر، واخترنا نحن في يومنا هذا أن ندعو أولئك بأسماء أخرى.
لكن الحقيقة مختلفة كل الاختلاف عن ذلك، فلا شك أن هناك أفرادًا وقوى كبرى لها تأثير فينا على الدوام، وهناك كثير مما لا يمكننا التحكم به في عالمنا، لكن ما يجعلنا بصورة عامة نضل طريقنا في المقام الأول - أي ما يقودنا إلى اتخاذ قرارات طائشة والقيام بحسابات خاطئة هو (اللاعقلانية) عميقة الجذور فينا؛ إلى الحد الذي أصبحت فيه عقولنا محكومة بالعاطفة، ولا يمكننا رؤية ذلك، إنه أمر يشبه اللطخة العمياء في العين، ولنأخذ مثالاً لهذه اللطخة العمياء، ولننظر في أزمة سنة 2008؛ التي يمكن أن نجد فيها مجمل أشكال اللاعقلانية البشرية.
ففي أعقاب الأزمة، كانت الذرائع الآتية هي الأكثر شيوعًا في وسائل الإعلام لتفسير ما حدث:
• اختلالات في الميزان التجاري وعوامل أخرى أدت إلى انخفاض الفوائد على القروض في أوائل سنوات العقد الأول من القرن الحالي، وأدى ذلك إلى فرط الاقتراض.
• كان من المستحيل فرض قيمة دقيقة من الضرائب على السندات المالية بالغة التعقيد التي كان يجري تداولها، وبذلك لم يكن هناك أحد يستطيع بحق قياس الأرباح والخسائر.
• كانت هناك عصابة فاسدة من دهاة العارفين ببواطن الأمور، يحفزون التلاعب بالنظام ليجنوا الأرباح الوفيرة.
• الدائنون الجشعون زادوا الرهون العقارية عالية الأخطار على أصحاب المنازل.
• كانت هناك تشريعات حكومية تفـوق الحد اللازم.
• كانت النماذج [الموديلات] المحوسبة والأنظمة التجارية في اهتياج شديد.
فهذه التفسيرات تكشف لنا إنكارًا واضحًا للواقع الأساسي؛ ففي الطريق إلى أزمة سنة 2008، كان ملايين الناس يتخذون قرارات يومية بالدخول في الاستثمار أو الإحجام عنه، وفي كل مرحلة من هذه التداولات كان بوسع المشترين والبائعين التراجع عن صور الاستثمار عالية الأخطار، إلا أنهم قرروا عدم التراجع، وكان هناك كثير من الناس يحذرون من حدوث فقاعة اقتصادية؛ فقبل الأزمة بسنوات قليلة، كان انهيار صندوق التحوط العملاق: لونغتیرم کابیتال مانجمانت Long-Term Capital Management [صندوق الإدارة المديدة لرؤوس الأموال]، قد أظهر بدقة إمكانية حدوث انهيار أضخم منه، وكيفية حدوثه، ولو كان للناس ذاكرة أطول عمرًا، لأمكنهم التفكر فيما حدث في فقاعة سنة 1987؛ ولو أنهم قرأوا التاريخ لتفكروا في فقاعة سوق الأسهم سنة 1929، والأزمة التي حصلت آنذاك، ويمكن لأي صاحب منزل في الغالب أن يفهم أخطار الرهون العقارية بلا دفعة أولى مع شروط الدين التي تنص على الزيادة السريعة في معدلات الفائدة.
وكان ما تجاهلته كل الدراسات هو اللاعقلانية الجوهرية، التي قادت هذه الملايين من المشترين والبائعين للتأرجح صعودا وهبوطا، لقد أغوتهم سهولة جمع المال، وهذا ما جعل المستثمرين حتى أفضلهم تعليمًا - أناسًا عاطفيين، وكانت دراسات الخبراء تتجه إلى أفكار معززة، تقول: بأن الناس مهيؤون مسبقًا للتصديق، تصديق أشياء من قبيل القول السائر «هذا زمن مختلف»، و«أسعار المنازل لا تتهاوى أبدًا»- فاجتاحت موجة من التفاؤل الجامح جموع الناس.
ثم جاء الهلع والانهيار، والمواجهة البشعة مع الواقع؛ فبدلاً من التصدي لاهتياج المضاربات التي سحقت الجميع، وجعلت الأريب من الناس يبدو كالأبله؛ توجهت الأصابع باللائمة إلى القوى الخارجية، إلى أي شيء ينحرف عن المصدر الحقيقي لهذا الجنون، وهذا ليس أمرًا يخص أزمة سنة 2008 وحدها؛ فهذه الأنماط نفسها من التفسيرات جرى اختلاقها بعد أزمتي سنة 1987 وسنة 1929، ومع الهوس بالسكك الحديدية في أربعينيات القرن التاسع عشر في إنكلترا، وفي فقاعة شركة بحر الجنوب في عشرينيات القرن الثامن عشر في إنكلترا أيضا، ويتحدث الناس عن إصلاح النظام؛ وتوضع قوانين للحد من المضاربات، ولا شيء من ذلك يفلح في تجنب الأزمات.
وتحدث الفقاعة الاقتصادية بسبب الجذب العاطفي الشديد الذي تحدثه المضاربات في الناس، فيطغى ذلك على أي قوّى منطقية يمكن أن يحتويها عقل الفرد منهم، إنها تثير ميولنا الطبيعية نحو الجشع وجمع المال بسهولة والنتائج السريعة؛ فمن الصعب على أحدنا أن يرى أناسًا آخرين يجمعون المال ولا يكون منهم؛ فما من قوة رقابية في كوكبنا يمكنها التحكم بالطبيعة الإنسانية، وبما أننا لا نواجه المصدر الحقيقي للمشكلة، فإن الانهيارات والفقاعات الاقتصادية ستظل تتوالى علينا، وستظل تأتينا ما دام هناك أناس ساقطون، وأناس لا يقرؤون التاريخ. وتتكرر حدوث هذه الأزمات، مع تكرر حدوث المشكلات والأخطاء نفسها في حياتنا الخاصة؛ فتتشكل من ذلك الأنماط السلبية، ومن الصعب أن نتعلم من تجاربنا ونحن لا ننظر في داخلنا باحثين عن الأسباب الحقيقية.
الاستنتاج: الخطوة الأولى لتكون إنسانًا عقلانیا ھي في أن تفھم ما فیك من لا عقلانیة متأصلة، وھناك عاملان لا بد لھما من أن یجعلا من ذلك أمًرا مستساغا في الأنا: فلا أحد مستثنًى من تأثیر إغواء العواطف في العقل، ولا حتى أكثرنا حكمة؛ واللاعقلانیة -ھي إلى حٍّد ما- وظیفة في بنیة عقولنا، منسوجة داخل طبیعتنا الحقیقیة، بالأسلوب الذي نتلقى به عواطفنا، وكونُنا لاعقلانیین ھو أمر خارج تقریبًا عن سیطرتنا، ولنفھم ذلك علینا أن ننظر في تطور العواطف نفسھا [من منطلق نظریة تطور الكائنات الحیة].


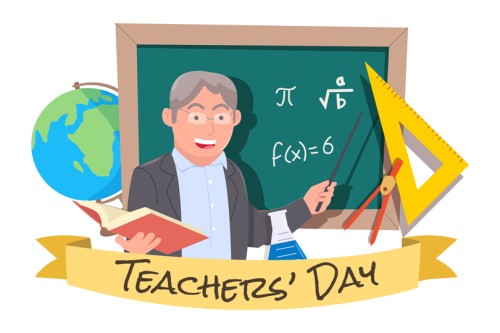

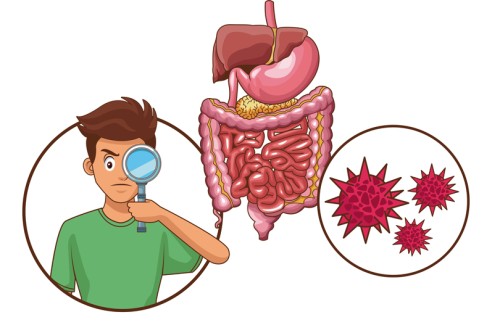



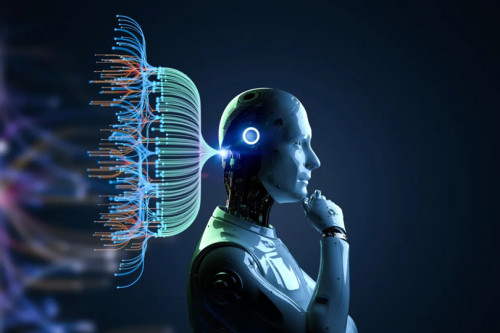





اضافةتعليق
التعليقات