عندما كنت طفلاً كان يتوجب عليّ أن أخاف أبي، لا أدري لماذا يتوجب عليّ الخوف منه ولكن كان يجب أن أنتهي من اللعبة الّتي انسجمتُ معها منذ قليل وأذهب حيث والدتي عندما أسمع صوتَ المفتاح يستقرّ داخل قِفل باب الشقة، لم أكن أدري حينها لماذا يجب أن أخاف أبي؟، ولماذا أبي لا يُحاول أن يذيب هذا الخوف الّذي يحجبني عن الظهور أمامه بطبيعتي؟.
دائماً كان والدي على صواب، وأنا ربما على خطأ أو ربما لا ينبغي عليّ أن أعرض رأيي من الأساس، "هل تفهم أنتَ كوالدك، إنّه كبير ويعلم الصواب من الخطأ، إنّه يعلم كل شيء!"، هكذا كانت تقول والدتي عندما أحاول أن أخبرها في غياب أبي أنني أودّ أن أذهب لمكان معين والطقس هناك جميل اليوم، كانت والدتي تتواطئ مع أبي كما يتواطئ الشعب مع الحكومة، فالخبرة القياديّة مقصورة علي أبي الّذي كان دائماً يعلم شيئاً خفياً يبرر به كل قراراته، شيئاً لم أعلمه إلى الآن، ربّما من واقع خبرته أو خوفه عليّ، وربما شيء له علاقة بالأمن الداخلي والخارجي للأسرة!.
بدأتُ في تجاوز الأيام والشهور وحتى السنوات شيئاً فشيئاً ودائرة الخلاف بيني وبين أبي تتسع وتكبر وكأنها تكبر بالسنوات كما أكبر، كان يتوجب عليّ أن أسلّم برأيه ولا أُناقشه فيه، فهو صاحب الخبرة المطلقة الّتي ورثها عن جدّة، أو تمرغ لأجلها في صناديق الحياة حتى نضجت خبرته وأصبحت جاهزة للطعام.
في الحقيقة لم يكنْ حديثُ أبي الموجّه إليّ في طفولتي أو حتى في سنوات مراهقتي يعكس رأيه الخاص الّذي يُخبرني به ويشاركني إياه من منطلق خبرته الكبيرة، بل كان أمراً قاطعاً لا يتحمّل النِّقاش، وليس هناك من سبيل غير السبيل الّذي سلكه في اتخاذ قراره، وكأنّنا في معسكر ضيّق يتكون من زوجين وأولادهما، فالأسرة إن لم تدعم هذا القرار ربّما تتفكك ويكون حالها كحال الأسرة المجاورة المتفككة منذ سنوات.
في واقع الحياة العربية -وخاصة المصرية- الأسرة هي معسكر صغير يُدرَّب فيها الإبن على إعطاء الطاعة المطلقة لأوامر والده دون نقاش ولو كانت خاطئة، ثم تُبلوِر الأم فكرة أنّ الوالد لا يُخطئ أبداً في عقل إبنها الصغير الّذي لا يزال عجيناً ليناً يمكن تشكيله كما يحلو لها، فيلتجأ للتسليم لعقل الوالد، وربما يلتجأ للتمرد والإنسياق نحو أفكار معادية لأفكار والده، فتنشأ أفكار الإبن كردة فعل لأفكار الأباء.
هذه الطريقة الّتي تتخذها الأُسر منهجاً في تربية أبنائهم تُنشئ جيلاً غير قادر على الإستيعاب، جيلاً لا يمكنه أخذ الآراء وتحليلها بطريقة عقلية تستند للخبرات القديمة والتجارب الحقيقية وتستطيع الخروج من تلك الآراء بالنتائج الّتي تُحدد رأيهم، فإذا بدأت بعرض رأيك فتجد الشاب أمامك إمّا ينساق خلفه بلا عقلٍ ولا دراية، وإما يقف ضده لمجرد أنّ رأيك لا يحلو له.
في واقع الحياة ما زَالت هناك فجوة عميقة ما بين الجيل الذي تربّى على صناعة أصنام السلطة، ونشأت لبنته على أنّ أرباب السلطة هم منْ يعلمون كلّ شيء وفي كلّ وقت، ولولاهم لتمّ غزونا من قِبَل الأعداء، الّذين يلغون كلّ جهد للشباب الّذين ملئوا القبور فلا يذكرون في انتصارات الدولة سوى أصنام القادة، وبينَ جيل من الشباب تمرّد على كلّ ألوان السلطة، حتّى أنّه متمرّدٌ على نفسه في حياته الخاصة، جيلٌ لا يعرف الأصنام سوى عجوة ليأكلها، ولا يعرف الحكام سوى مسئولين يخدمونهم، جيلٌ لا يمكن جمح قدراته الّتي إن هاجت لا تهدأ إلا على الرُكام، وإن هدأتْ تستثقِل الهدنة بينَ صراع الأجيال.
مِن سوء التربية الأسرية أصبح الجيل القديم غير قادرّ على فهم الجيل الجديد الّذي هو أيضاً غير قادر على فهم نفسه فيلجأ غالباً للتمرد، عندما يصعب على أبي أن يفهمني ينعتني بالتهور والغباء واضمحلال العقل دون أن يُحاول التعلم لكي يفهمني، لذلك وقعت ملحمة من تضارب الأفكار بين القيادات العليا والصغرى، وبين العقول الّتي بلغت من الكبر عتيّاً والعقول التي لا تستطيع أن تضبط تفكيرها.
في النهاية فالخطأ مشترك ما بين الّذي لا يُواكب التطور السيكولوجي في الشباب من جيل التسعينات، ويريد أن يرسم الخطط لسنوات ربما لا تنتظره، وبين شباب بعضهم متمرّد والآخر غير صبور والثالث نظرته ضيقة، سواء هذا أو ذاك فالخطأ سيعود لصاحب الخبرات العظيمة الّتي برر بها جميع مواقفه الخاطئة، وفي النهاية لم يستطع من خلالها تربية ابنه على كيفية إبداء رأيه ولم يعطه المساحة لذلك.








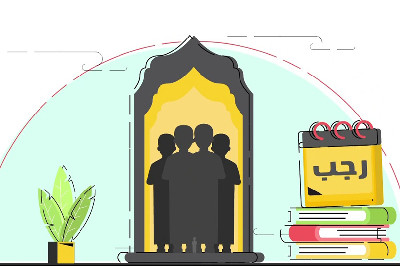





اضافةتعليق
التعليقات