يعتبر التعاطف والتعاضد بين أعضاء الجماعة من الأوليات الدفاعية الفعالة ضد الأخطار الخارجية وأخطار الطبيعة، يستعيض الإنسان المقهور عن عجزه الفردي بالاحتماء بالجماعة وبقدر تفاقم الخطر الخارجي، وبقدر تعاظم الإحساس بالتهديد للذات والمصير، يميل الإنسان إلى الذوبان في الجماعة.
ذلك أحد قوانين الطبيعة، كلما ازداد الشعور بالقوة عند الكائن الحي، نراه يميل إلى الفردية والاستقلال. وعلى العكس نجد الكائنات المهددة بيولوجياً تميل إلى التجمع بمقدار التهديد الذي تتعرض له من آفات الطبيعة، أو من الكائنات العدوة. تعوض كثرة العدد عن ضعف الفرد. الأمثلة على هذه الظاهرة في العالم الحيواني أكثر من أن تحصى، وأوضح من أن تحتاج إلى برهان.
على المستوى الإنساني نجد نماذج مختلفة لهذه الظاهرة، أشهرها الجماعات المغلقة والأسر الكبيرة التملكية، ولابد قبل هذا من التذكير بأننا نعالج ونحلل ظواهر اجتماعية أساساً، لها وظيفة نفسية دون أن تكون وليدة الحاجة إلى تلبية هذه الوظيفة، فالعلاقات الدمجية على مستوى الجماعة (الجماعات المغلقة)، والأسر العريضة التملكية، وكذلك التفاعل والتواصل الفمي، هي جميعاً نتاج البنية الاجتماعية، بما تتصف به من خصائص تاريخية تطورية، ونظم إنتاج وتوزيع وخدمات وعلاقات.
إنه لا يخطر ببالنا مطلقاً أن نرد الظواهر والأنظمة والمؤسسات الاجتماعية في نشأتها وديناميتها، إلى مجرد تعبيرات نفسية، فهذه لا تشكل سوى جوانب منها، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تستوعبها. وهي تخضع في الأساس إلى منهجية التفسير الاجتماعي. ولكنها ليست مطلقاً اجتماعية محضة، لأنه ليس هناك، في رأينا، ظاهرة اجتماعية محضة، كما لا يوجد بالمقابل ظاهرة نفسية صافية. الإمبريالية الاجتماعية، كمثيلتها النفسية، في منهجية البحث الإنساني، قد ولى عهدها، وأفل نجمها. وما ننظر فيه هنا إذا ليس تفسير هذه الظواهر، وهو اجتماعي أساساً، بل الوظائف النفسية لها.
وهي هامة بدورها نظراً لما تلبيه من حاجات تنبع من الشرط الوجودي للإنسان الذي تحدده بنية المجتمع. هذه البنية بما لها من مؤسسات ونظم وما تتصف به من شبكة علاقات، تولد حاجات نفسية معينة من ناحية، وتؤمن لها بعض شبل الإشباع بما تتضمنه من حلول، من ناحية ثانية.
الذوبان في الجماعة:
الجماعات المغلقة من الظواهر التي حللها جيداً علم النفس الاجتماعي. إنها وليدة الإحساس بالتهديد الخارجي، أكان مصدره بشرياً أم طبيعياً. ينقسم العالم في هذه الحالة إلى عالمين متناقضين تماماً: الخارج والداخل. أما الخارج فهو العدو ومصدر الخطر والشر، العلاقة معه عدائية اضطهادية، والموقف منه إما انسحابي تجنبي أو تهجمي تدميري، أما الداخل فهو الخير كله، وهو مصدر الأمن والشعور بالانتماء، مصدر الهوية الذاتية، وهو بالتالي المرجع والملاذ.
ويحدث في هذه الحالة نوع من الانشطار العاطفي، بشكل يجعل المواقف قطعية. كل الشر والخطر والسوء، كل العقبات والموانع الذاتية والموضوعية، كل العدوانية الذاتية المقموعة والمتراكمة، تسقط على الخارج، مما يؤدي إلى تبخيسه تماماً. وهكذا يتحول الخارج إلى مجرد أسطورة مخيفة يجب الحذر منها. وليس من موقف تجاهها إلا العنف والتدمير. وأما العواطف الإيجابية فتتوجه إلى الداخل، إلى النموذج الذي يجب أن يحتذى.
كل واحد منهم يتحول إلى مرآة تعكس للآخرين ذواتهم الإيجابية. ويحدث هنا إفراط في إعطاء القيمة للجماعة الداخلية على حساب الإفراط في تبخيس الجماعات الخارجية. وتشتد الأواصر ضمن الجماعة المغلقة بقدر حاجتها لتجنب قلق الانفصال. إنها تشتد بقدر الحاجة لإنكار الصراعات والتناقضات الداخلية، وما يرافقها بالضرورة من مشاعر عدوانية.
ويذهب الدفاع ضد هذه التناقضات حد الذوبان الكلي في الجماعة، لدرجة يفقد معها الفرد استقلاليته وهويته الذاتية، ولا يعود له من هوية سوى الهوية الجماعية. وتغلق الحدود النفسية بين الجماعة وغيرها من الجماعات.
يقتصر التفاعل والتواصل على الحد الأدنى الضروري، أو يتوقف عند حدود الاضطهاد المتبادل. وبالطبع، بمقدار انغلاق الجماعة، ترتفع درجة النرجسية ضمنها وبين أفرادها، نظراً لأن كلاً منهم يكون مرآة ذات الآخر. وبارتفاع النرجسية تتضخم قيمة الجماعة، حتى تصبح القيمة المطلقة أو الوحيدة، وتتضخم معها وبالدرجة نفسها قيمة الفرد.
ويأخذ الأمر على هذا المستوى نوعاً من الشعور بالامتلاء والاعتزاز بالانتماء، وحالة من الإحساس بالمتعة. وترتفع درجة الذوبان في الجماعة عادة على المستوى الفردي، بما يتناسب مع مستوى الإحساس بالضعف والعجز وانعدام القيمة.
أكثر الأفراد ذوباناً في الجماعة وتعصباً لها، هم في معظم الأحوال، أشدهم عجزاً عن الاستقلال والوصول إلى مكانة فردية، وإلى قيمة ذاتية تنبع من شخصيتهم. العلاقة الدمجية، أو الذوبانية داخل الجماعة المغلقة تتصف بالاتكال الشديد على رموز القوة في هذه الجماعة، وعلى عناصر السلطة المادية والنفسية فيها. هذه العناصر تضخم بدورها بشكل لا واقعي بمقدار الحاجة إلى الإحساس بالأمن والمحبة.
كما أن هذه العلاقة نكوصية أساسياً، بمعنى أن الفرد من هؤلاء يبحث، بشكل لا واع عن العودة إلى العلاقات الدمجية بالأم، مصدر الحب والدفء والحنان والغذاء، ومصدر السلوى، وعامل إبعاد المنغصات الحياتية. الجماعة المغلقة، ذات الدلالة الإيجابية ومرجع تعريف الذات وتوكيدها، هي الأم بعينها، الأم المعطاء التي يجب أن تستقطب كل الولاء. ومن هنا التعصب المفرط لتقاليد الجماعة ومعاييرها، وردود الفعل العنيفة ضد كل من يحاول خرقها من الداخل، أو الاعتداء عليها من الخارج، كما أوضحنا في الفقرات السابقة.
هذه الظاهرة تشيع كثيراً في المجتمعات المتخلفة، حيث نجد أينما حللنا جماعات متفاوتة في كبرها مغلقة على ذاتها، تشد أفرادها إليها بقوة لا تقاوم، وتقوم بينها وبين الجماعات المجاورة علاقات صراع وعداء وحذر واضطهاد.
كل التناقضات الداخلية توجه إلى الجماعات الأخرى التي تستباح عادة إذا سنحت الفرصة في أملاكها وأموالها وأرواحها. ومن الواضح أن هذه العلاقات العدائية الاضطهادية بين الجماعات تشتد وتقوى بقدر تعرضها جميعاً لقوى متسلطة تبسط سلطانها على الجميع، ولا قبل لأي منها بمقاومتها.
كما أن التعاضد والتعاطف أعضاء الجماعة الواحدة يزداد بمقدار رضوخها لمتسلط خارجي لا قبل لها به. وهنا أيضاً تبرز ظاهرة الانشطار العاطفي: المتسلط هو رمز الخطر والبطش والسوء، والموقف منه هو التجنب والحذر والابتعاد عنه ما أمكن. أما الجماعة الداخلية فهي رمز الحب والحماية والأمن، والشعور بالهوية الذاتية، والموقف منها هو الاندماج فيها ما أمكن. على أن هذا الانشطار العاطفي ليس دائماً. إذ يكفي تتاح الفرصة لعضو ما في الجماعة كي يتقرب فعلياً، أو مظهرياً من المتسلط، حتى يدير ظهره لجماعته ويتنكر لها.
تلك هي ظاهرة التماهي بالمتسلط التي تؤكد وجود تناقضات داخلية كامنة ضمن الجماعة الذوبانية التي تنشأ كرد فعل على الأخطار الخارجية. والواقع أن الأمر في مساره الخارجي يتذبذب ما بين خشية المتسلط وتجنبه، مما يقود إلى الاحتماء الدمجي في الجماعة، وبين الحرب عليه ومقاومته في مرحلة متقدمة من تطور المجتمع نحو التحرر الاجتماعي. وبين هاتين المرحلتين تتوجه العدوانية إلى الجماعات المجاورة.












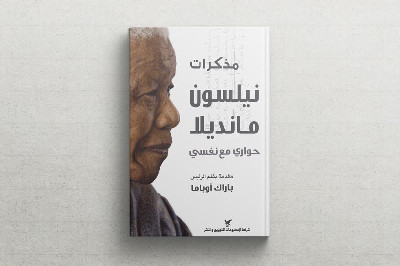

اضافةتعليق
التعليقات