عندما نستقرئ ميزان الحركة والسكون في الحياة نجد أنها تتكلم بلغة التجدّد، لغة لا يفهمها من تشبّث بأوهام الثبات في عالم متغيّر. من تأمّل في الطبيعة، أدرك أن الحياة لا تعرف الجمود، والنهر لا يحمل ماءه مرتين، كل شيء يتحرّك، يتبدّل، فيتطوّر أو يتغيّر، لذا فإن نظرية التجدّد متشعّبة على مدارات واسعة في مفهوميها المادي والمعنوي ومنها:
أوّلًا: التجدّد العلمي والتقني
من المؤسف أننا نستيقظ ذات صباح لنجد أن العلم الذي بذلنا فيه أعمارنا وجهودنا المتراكمة عبر السنين قد يعدّ قديماً وتنقصه صيقلة جدّية من أجل إعادة لمعانه مرّة أخرى، السبب الرئيسي في التخلّف هو الركون إلى علم قديم وعدم محاولة تجديد البنى المعرفية من خلال الطرق العلمية الحديثة التي اكتشفها العلماء اللاحقون، مازلنا نتخبّط في نفس العثرات عامًا بعد عام، في عالمٍ يُحدث كل يوم طفرة جديدة.
يُقصى عن المستقبل من يركن إلى ماضيه، فالعقل الذي لا يتجدّد علميًا، يُصبح عاجزًا عن التفاعل مع تحدّيات الواقع، ويعيش في عصرٍ غير عصره. أما من يُجدّد أدواته المعرفية، فإنه يُطيل عمره الرمزي، ويترك أثرًا حيًّا في مجتمعه وتاريخه.
ثانيًا: التحرّر من قيود السكون الفكري
الفكر الجامد كالنهر الراكد، يبدأ بالتعفّن.
إن العقول التي تكرّر ما قاله السابقون دون مراجعة، تتحوّل من أدوات وعي إلى صناديق حفظ. التجديد الفكري يعني أن نفكّر لأنفسنا، لا بالنيابة عن غيرنا، أن نحترم الماضي، دون أن نجعله سقفًا لا يُخترق.
الماضون من علمائنا وفلاسفتنا عاشوا في بيئة مختلفة وقد تعرّضوا إلى الكثير من الضغوط السياسية والحروب والهجرة والظلم فضلًا عن المجتمع المتخلّف والقاسي الذي لا يفهم أبعاد الفكرة العلمية وتداعياتها، لذا لا بأس من تداول الموروثات وإخضاعها للبحث والتنقيح وهذا لا يعني التخلّي عن الثوابت، بل يعني التمييز بين ما هو ثابت وما هو خاضع للتحوّل، بين الجوهري والطارئ، بين ما يَبني وما يُعطِّل من أجل الوصول إلى نتائج لعلّها تكون كفيلة بإحداث تغيير هائل في الواقع العملي.
لا يصحّ أن تكون القيم مجرّد عادة وتكرار لما تربّينا عليه.
علينا أن نعيد الإيمان إلى مجاله النقي، علاقة صادقة بين العبد والحق، لا بين الإنسان وميراث اجتماعي بلا وعي، تحتاج هذه المرايا إلى تلميع حتى تعكس مفهومها الأبعد والأنقى لعكس صورة أوضح وهذا لا يحدث إلا من خلال فتح مجال البحث العلمي لتناول القضايا الحيوية العميقة التي تدعو إلى الإصلاح الجذري بدل الركون إلى السطحيّات السهلة وهذا ما أشار إليه الإمام الحسين عليه السلام في قوله (إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدّي) ثم تغلغل في عمق الأدمغة الطافية، فاستدعت هذه العملية القيام بأمر صعب جدًّا، وتضحية ما بعدها تضحية خلّدها التاريخ بفخر واعتزاز.
ثالثًا: في المجال المادّي أناقة الظاهر... إضاءة للروح من الداخل
قد يجد البعض أن التجديد في المظهر أمر سطحيّ، لكن الحقيقة أن فيه بعدًا نفسيًا عميقًا واستجابة خفية لحاجتنا الغريزية.
حين نرتدي ثوبًا جديدًا، نشعر وكأن شيئًا في داخلنا قد انتعش. ليس الأمر مجرّد ترف، بل هو استجابة خفيّة لحاجة الكائن إلى التجدّد.
وكذلك بالنسبة للطعام، هل فكّرنا يومًا أننا لماذا ندور في دائرة متكرّرة بالنسبة لاختيار طعامنا رغم وجود قوائم عالمية أصبحت كلها في المتناول تضمّ في قوائمها ألذّ وأطيب الأصناف وأكثرها نفعًا وهي الوصفات التي توارثتها الشعوب والأجيال؟ حين نغيّر هذه الأنماط، فإننا نقاوم الرتابة، نبعث في الحياة مسحة دهشة، ونمنع الروح من الذبول في تكرار لا نهاية له.
رابعًا: فنّ التخلّي
لكي نمارس التجدّد حقًّا يجب أن نتقن فنّ الانفصال والتخلّص من كل الجزئيات المتراكمة التي فرضتها علينا سياسات العولمة الهادفة إلى خلق الإنسان المستهلِك حتى جعلته يعتقد أنه بحاجة ماسّة إلى كل الأدوات الصغيرة والكبيرة التي يشاهدها في حملات الدعاية والإعلان ولكنه ما إن يجلبها حتى يتفاجأ بأنها غير ضرورية بتاتًا، فتتحوّل إلى خردة تضيّق عليه المساحة في البيت وتثير الفوضى وقس على ذلك كلّ شيء في حياتنا.
بالنظر من زاوية ماديّة أخرى نحن في الحقيقة وبصورة غير واعية نمنع أنفسنا من التجدّد عندما نحتفظ بأغراض لم تعد تخدمنا لسبب وآخر مثل تلك التي مضى على استخدامها فترة زمنية، ففقدت شكلها وهيأتها ولم تعد بالمواصفات المطلوبة مثل الألعاب والأغراض المنزلية والملابس وغيرها مما أصيب بالعطل، ليس كل قديم قيّمًا ولا كلّ حاضر نافع.
بعد استقراء بسيط نجد أنّ كلّ من يخشى التجديد، يخاف في الحقيقة من فقدان ما يعرفه، لا لأنه ثمين، بل لأنه مألوف. لكنّ الحياة مغامرة. من لا يتجدّد، يتآكل في صمت. ومن يختار البقاء على حاله، يدفن نفسه حيًّا في أرض الأمس.
التجدّد لا يعني خيانة الأصل، بل وفاء لجوهره. والسرّ الكامن في العودة إلى المعنى الحقيقي للحياة هو أن نكون في حركة، وبحث، وفي تفتّح مستمرّ.


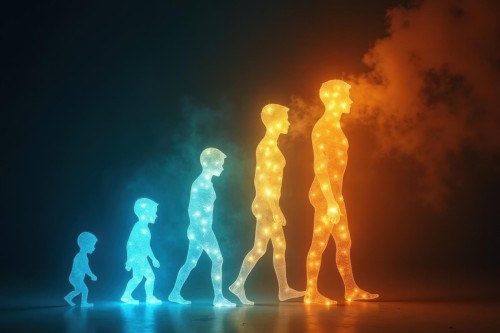




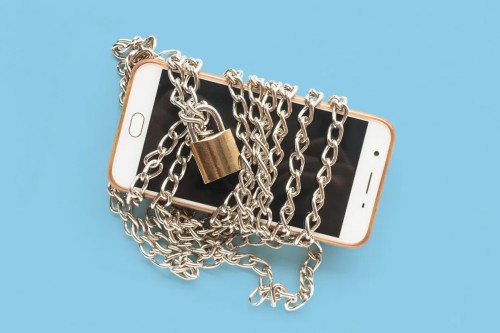


اضافةتعليق
التعليقات